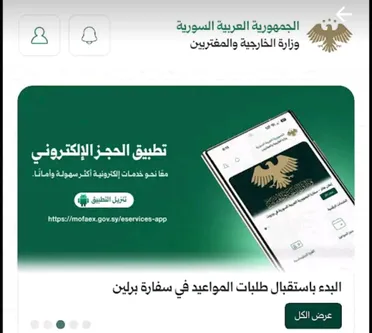فضل عبد الغني: مبدأ تقرير المصير بين الحق القانوني والتقييدات الدولية لصون سيادة الدول
قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشره موقع تلفزيون سوريا بعنوان "خديعة التسطيح الشعبوي لمبدأ تقرير المصير شديد التعقيد"، إن مبدأ تقرير المصير يُعدّ واحداً من أكثر مبادئ القانون الدولي العام تعقيداً وإثارة للجدل، نظراً لما يخلقه من توتر بنيوي مع مبدأي سيادة الدولة وسلامة أراضيها، واللذين يمثلان بدورهما ركائز أساسية لا تقل أهمية عنه.
وأوضح أن هذه الثنائية شكّلت مفارقة مركزية في القانون الدولي، حيث يقتضي الاعتراف بحق الشعوب في اختيار وضعها السياسي، لكن المجتمع الدولي يلتزم في الوقت ذاته بصون استقرار الحدود ومنع تفتيت الدول.
وأشار عبد الغني إلى أن المسار القانوني للمبدأ ظل محكوماً منذ صياغة الرئيس الأميركي وودرو ويلسون له كأطروحة سياسية، قبل تحوله إلى حق قانوني معترف به في ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية اللاحقة، بميزان دقيق بين تطلعات الشعوب المشروعة ومتطلبات الاستقرار الدولي، غير أن هذا التوازن أفرز بنية هرمية جعلت ممارسة تقرير المصير مقيدة عملياً لصالح سلامة الإقليم في مواجهة المطالبات الانفصالية، رغم اعتراف القانون الدولي به كحق أساسي.
الإطار القانوني وتطور المفهوم
استعرض عبد الغني الجذور النظرية لمبدأ تقرير المصير، مبيناً أن صياغة ويلسون له كانت امتداداً لمبدأ وارد في إعلان الاستقلال الأميركي، يقوم على أن الحكومات تستمد شرعيتها من رضى المحكومين. ومن هنا، انطلق التصور بأن أي دولة لا يحق لها فرض نظامها السياسي على شعب آخر، وهو ما أسس قاعدة مفهومية تحولت تدريجياً إلى مبدأ معترف به دولياً، ومع إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة، بدا المبدأ محاطاً بالغموض نتيجة التوازنات بين القوى الاستعمارية والدول الناشئة، الأمر الذي جعله حقاً مشروطاً في بداياته.
وأضاف أن الاعتراف القانوني تبلور أكثر مع العهدين الدوليين لعام 1966 بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أكدا أن لجميع الشعوب حقاً غير مشروط في تقرير المصير، يتيح لها حرية تحديد وضعها السياسي وتنمية أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لكن إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية لعام 1970 أعاد التشديد على ضرورة عدم مساس هذا الحق بسلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، وهو ما رسّخ التوتر بين المبدأين وأبقى الممارسة العملية محكومة بتغليب وحدة الدولة على أي نزعات انفصالية.
تمييز بين تقرير المصير الداخلي والخارجي
أوضح عبد الغني أن القانون الدولي طوّر أشكالاً متمايزة لممارسة تقرير المصير بحسب السياقات، حيث يشكل تقرير المصير الخارجي ـ المؤدي إلى قيام دولة مستقلة ـ الشكل الأكثر صعوبة وندرة، بينما برز تقرير المصير الداخلي، القائم على الحكم الذاتي أو الديمقراطية التشاركية داخل الدول، بوصفه الشكل الأكثر قبولاً للتنفيذ. كما ظهرت فئات أخرى مثل تقرير المصير الخاص بالشعوب الأصلية أو تقرير المصير الاقتصادي، لكنها بقيت خاضعة للقيود التي يفرضها مبدأ السلامة الإقليمية.
وأضاف أن فقهاء القانون يرون في التفاعل بين تقرير المصير وسيادة الدولة أحد أكثر تناقضات القانون الدولي تعقيداً، إذ تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة الدول، ما يضع عائقاً أمام أي محاولات انفصال. وأكد أن الاستثناءات المعترف بها تنحصر في حالات الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية، ما يعني أن الغالبية العظمى من الحركات الانفصالية المعاصرة لا تجد سنداً قانونياً كافياً لمطالبها.
المعايير القانونية ومعضلة الاعتراف
بيّن عبد الغني أن المعايير القانونية التي تحكم تقييم مطالبات تقرير المصير ما تزال موضع خلاف وتطبق بشكل غير متسق، وهو ما يعكس الطابع السياسي لقرارات الاعتراف. فبينما يحظى تقرير المصير الداخلي بقبول أوسع، يبقى تقرير المصير الخارجي مقيداً جداً خارج السياق الاستعماري.
ولفت إلى أن إعلان الاستقلال لعام 1960 أقرّ حقاً غير مشروط للشعوب المستعمَرة في الاستقلال، لكن خارج هذا الإطار لا يُسمح بالانفصال إلا في ظروف نادرة، مع ظهور فكرة "الانفصال العلاجي" في الأدبيات، باعتباره مبرراً محتملاً في حال تعرضت جماعة ما لقمع جسيم وفشلت كل سبل الانتصاف، غير أن هذه النظرية لم تترسخ كقاعدة قانونية مستقرة.
وأشار إلى أن مبدأ "الحيازة القائمة" (uti possidetis juris) الذي ينص على تثبيت الحدود الإدارية الموروثة عند الاستقلال، شكل آلية للحد من تفكك الدول، وقد جرى تطبيقه في أميركا اللاتينية وأفريقيا وفي حالات تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.
ورغم أنه ساهم في حفظ الحدود القائمة، فقد أثار جدلاً لكون الحدود لم تُرسم أساساً كحدود دولية. كما أن قرارات لجنة بادينتر حول يوغوسلافيا أسهمت في تكريس تفسيرات قانونية متناقضة أحياناً، حيث دعمت هويات قومية ضمن حدود ثابتة، ما زاد من تعقيد المشهد.
وأكد عبد الغني أن رفض معظم مطالبات تقرير المصير يعكس تداخل القانون بالسياسة، حيث يمنح المجتمع الدولي الأولوية لاستقرار الدول على حساب تطلعات الاستقلال، مشيراً إلى أن الدساتير الوطنية بدورها تشكل حاجزاً داخلياً أمام الانفصال، إذ تحظر كثير منها ذلك صراحة، وهو ما يحترمه القانون الدولي.
إشكالية "الشعوب" والنظرية العلاجية
لفت عبد الغني إلى أن غياب تعريف دقيق لمفهوم "الشعوب" المخولة بممارسة تقرير المصير يزيد من صعوبة الاعتراف بالمطالبات، إذ تستغل الدول والمنظمات هذا الغموض للطعن في أهلية جماعات معينة لصفة "الشعب". وأكد أن الحسابات الاقتصادية والأمنية كثيراً ما تطغى على الحجج القانونية، حيث تخشى الدول من سوابق قد تشجع حركات انفصالية مماثلة، وهو ما يجعل الحفاظ على الحدود القائمة أولوية ثابتة.
وتطرق إلى نظرية "الانفصال العلاجي" كإطار محتمل لتبرير الانفصال خارج الاستعمار، لكنه أوضح أنها ما تزال نظرية مثار جدل وغير مقترنة بتطبيق عملي واضح. واستعرض المعايير النظرية التي تضعها بعض الأدبيات، مثل وجود شعب متميز يتعرض لاضطهاد جسيم، مع استحالة تحقيق تقرير المصير الداخلي، وأن يكون الانفصال خياراً أخيراً. لكنه أشار إلى أن الاعتراف الفعلي يبقى رهناً بالاعتبارات الجيوسياسية أكثر من التزامات قانونية.
الخاتمة
خلص فضل عبد الغني إلى أن العلاقة بين حق تقرير المصير وسيادة الدولة في القانون الدولي تكشف عن بنية معقدة تعترف بالمبدأ كحق أساسي، لكنها تفرض قيوداً صارمة على ممارسته لصالح سلامة الإقليم.
وأكد أن القانون الدولي يفضل الحلول الداخلية القائمة على الديمقراطية التشاركية والحكم الذاتي وحماية حقوق الأقليات، بدلاً من تشجيع الانفصال. وأضاف أن تقييد الاعتراف، وارتباط القرارات بالسياسة الدولية، وغياب معايير واضحة، كلها عوامل تجعل من مطالبات تقرير المصير حالات استثنائية نادرة النجاح، وتعكس بوضوح أولوية الحفاظ على استقرار الدول ومنع تفككها على حساب طموحات الاستقلال.