 ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
١٤ ديسمبر ٢٠١٥
بدت إسرائيل منحازةً، وبوضوح، لروسيا ضد تركيا في قضية إسقاط طائرة السوخوي على الحدود التركية السورية، ولم يقتصر الأمر على الإعلام، المتجنّد كالعادة، المتشفّي والسعيد بورطة أردوغان مع فلاديمير بوتين، حسب التعبيرات الدارجة، وإنما تعدّاه إلى التصريحات الرسمية المتعاطفة مع موسكو، والكاشفة، في السياق، عن طبيعة التفاهمات الروسية الإسرائيلية، وحتى عن التحالفات الجديدة في المنطقة التي تحاول إسرائيل، كعادتها، وبانتهازية فائقة، تحقيق أكبر فائدة ممكنة منها.
لم يبدأ التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا في الحقيقة مع قصة إسقاط طائرة السوخوي، وإنما انطلق، قبل ذلك، مع تفجيرات باريس، الشهر الماضي التي أقحمت تل أبيب نفسها فيها لنفاق أوروبا، ووضع نفسها في صلب المعركة العالمية ضد الإرهاب، بما في ذلك المقاومة الفلسطينية طبعاً. وقد فضح التصعيد ضد تركيا عزوف إسرائيل عن محاولة التقارب والصلح مع تركيا الجديدة التي تضع القضية الفلسطينية مكوّناً أساسياً من مكونات العلاقة بين الجانبين. إضافة طبعاً إلى قناعة تل أبيب بأن في وسعها الاستفادة من التدخّل، أو الاحتلال الروسي لسورية، من أجل تحقيق مصالحها مجاناً، ومن دون الاضطرار لدفع أي ثمن أو أثمان استراتيجية لتركيا، لا سورياً ولا فلسطينياً.
تبدى هذا المنحى، أي التصعيد ضد تركيا، والإيحاء بالتوقف عن السعي إلى تطبيع العلاقة معها، والاعتماد، في المقابل، على الحلف الجديد مع موسكو، تبدى بشكل واضح، بل فظّ أكثر، مع قصة إسقاط المقاتلات التركية لطائرة السوخوي الروسية على الحدود التركية مع سورية. فقد بدت معظم التعليقات الإسرائيلية شبيهة بإعلام الحشد الشعبي الإقليمي معادية ومتشفية بتركيا، التي ورّطت نفسها في صراع مع الدبّ الروسي، حسب اللغة المستخدمة التي وصلت إلى حد المراهنة على بوتين، لكي ينتقم من أردوغان، ويحقق ما عجزت عنه إسرائيل تجاه الزعيم التركي الذي يشيطنه الإعلام الإسرائيلي، كما بعض التصريحات الإسرائيلية الرسمية، ويصوّره خصماً عنيداً للدولة العبرية، ليس سياسياً، وإنما فكرياً أيضاً.
في مقابل هذا الانتقاد لأردوغان، كالت الصحافة الإسرائيلية المديح لبوتين، وقد اقتبست عن رئيس الموساد السابق، أفارايم هليفي، وصفه الرئيس الروسي بضابط المخابرات الممتاز والمحارب العنيد ضد الإرهاب (يقصدون الإسلامي طبعاً)، مع الانتباه إلى الإعجاب الكبير الذي يكنه كل من أفيغدور ليبرمان وإيهود باراك للزعيم الروسي الذي وصل إلى حد اعتباره القدوة والأمثولة في محاربة الإرهاب، وملاحقة الإرهابين حتى المرحاض، كما يحلو لباراك القول ناقلاً عن بوتين، ومتغزّلاً به.
رسمياً؛ وإضافة إلى التصريح المتبجح والمنافق لأحد قادة سلاح الطيران، والذي قال فيه إن إسرائيل ما كانت أبداً لتسقط طائرة روسية، حتى لو اخترقت أجواءها، وهو ما حصل بالفعل، على أي حال كان، لافتاً كلام المسؤول السياسي الأمني لوزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد (منصب لا مثيل له في العالم) الذي قال، في المركز الثقافي في بئر السبع، إن الطائرات الروسية تستخدم الأجواء الإسرائيلية في عملياتها ضمن تفاهمٍ، يسمح أيضاً لإسرائيل باستخدام الأجواء السورية، للقيام بعملياتها ضد حزب الله.
اكتملت الصورة مع تصريح، وبالأحرى تصريحين لوزير الدفاع موشيه يعلون، قال، في أولهما، إن طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، حيث تم التعاطي مع الأمر بمرونة وأريحية. وفي ثانيهما، وهو الأهم، كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال يعلون إن نشر صواريخ إس 400 لن ينال من حرية حركة الحركة للطائرات الإسرائيلية في الأجواء السورية، ضمن تفاهم سياسي أمني، تم التوصل إليه بين الجانبين.
ترسم التصريحات السابقة، في الحقيقة، صورة المشهد أو التفاهم الإسرائيلي الروسي، وتفسر لماذا ابتعدت وتبتعد تل أبيب عن أنقرة، بينما اقتربت وتقترب من موسكو.
لا تضع روسيا، وعلى عكس تركيا، القضية الفلسطينية عاملاً من عوامل العلاقة بين الجانبين، وفي حرب غزة الصيف قبل الماضي، مثلاً، بدت اللهجة الروسية الرسمية متفهمة لما تقوم به إسرائيل في دفاعها عن نفسها في مواجهة الإرهاب. وضمنياً، سعت موسكو إلى القول إن ما تمارسه في أوكرانيا يتساوق مع ما تمارسه تل أبيب في غزة.
"تل أبيب لا تمانع ببقاء نظام الأسد، طالما أن هذا يتماشى مع مصالحها، أو يحققها، بعكس تركيا التي ترى أن مصالحها في سورية موحدة ديمقراطية، ونافذة لها للانفتاح على محيطها العربي والإسلامي"
هذا طبعاً بعكس الموقف التركي الرسمي، وحتى الشارع التركي الذي يعتبر أن الشعب الفلسطيني هو الأحب إليه. وهذا أحد القواسم المشتركة الرئيسية، ربما بين تركيا الجديدة وتركيا القديمة، علماً أن الأخيرة صوّتت ضد قرار تقسيم فلسطين في 1947، وخفضت مستوى العلاقة مع إسرائيل مرتين على خلفية القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، كما أن الطفرة في العلاقات بين الجانبين في التسعينيات كانت نتاجاً مباشراً لاتفاق أوسلو الذي أوحى، أو أعطى، الانطباع، خصوصاً بعد قيام السلطة، أن عربة الحل باتت على السكة، وأن العداء انتهى، أو في طريقه إلى الانتهاء بين العرب وإسرائيل.
أما تجاه الملف السوري، فقد بدا التناغم الإسرائيلي مع الموقف التركي القائل بضرورة إسقاط نظام بشار الأسد، مؤقتا وتكتيكيا وانتهازيا، علماً أن تل أبيب لا تمانع ببقاء نظام الأسد، طالما أن هذا يتماشى مع مصالحها، أو يحققها، بعكس تركيا التي ترى أن مصالحها في سورية موحدة ديمقراطية، ونافذة لها للانفتاح على محيطها العربي والإسلامي لا يمكن أن تتحقق سياسياً وأخلاقياً، طالما بقي الأسد في السلطة.
كان التفاهم الإسرائيلي مع روسيا، إذن، أسهل وبدون ثمن أو أثمان جدية، وإذا ما أرادت روسيا الاحتفاظ بنظام الأسد حامياً لمصالحها في سورية المدمرة والمقسمة، فلا بأس إسرائيلياً في ذلك، طالما أنه لا ينال أو يؤثر سلباً على المصالح الإسرائيلية، والخطوط الحمر الرئيسية التي وضعتها تل أبيب. وتتضمن هذه الخطوط الحمر عدم القيام بعمليات ضد إسرائيل، أو فتح جبهة جديدة ضدها، انطلاقاً من هضبة الجولان، وعدم نقل أي أسلحة نوعية أو كاسرة للتوازن، إلى حزب الله، مع حق إسرائيل بالقيام بما تراه مناسباً للدفاع عن تلك الخطوط الحمر ومصالحها بشكل عام.
تفهمت موسكو الموقف الإسرائيلي، ووافقت، كما قال جلعاد ويعلون علناً، على الحفاظ على المصالح الإسرائيلية في سورية، بما في ذلك حركة الطائرات في الأجواء، وتنفيذ غارات ضد أهداف تابعة لحزب الله وحتى للنظام نفسه، خصوصاً مع التماهي الكبير بين الجانبين في السنوات الأخيرة.
بدت المفارقة، أو السوريالية ربما، في دخول تل أبيب الفظ والمباشر على معادلة أن السماء لروسيا والأرض لإيران والميليشيات الأفغانية العراقية واللبنانية التابعة لها، وبموافقة روسية طبعاً، بحيث باتت المعادلة المحدثة أن السماء لروسيا وإسرائيل والأرض لإيران وحلفائها، مع أحقية تل أبيب في ضرب هؤلاء متى رأت ذلك متناسباً مع مصالحها وخطوطها الحمر.
للمفارقة، أيضاً، سعت تل أبيب، وبشكل غير مباشر، إلى الاستفادة من المعادلة المماثلة في العراق، حيث السماء للأميركيين والأرض للإيرانيين والمليشيات التابعة لها، كما قال علناً أيضاً الجنرال قاسم سليماني، وحصلت تل أبيب على ثمن، بل وأثمان لتلك المعادلة، ليس فقط عبر المضي في تدمير العراق، وإعادته سنوات وعقوداً إلى الوراء، وإنما عبر سلة عسكرية وأمنية واقتصادية تعويضية كبرى، بحجة أن تلك المعادلة كانت أحد البنود الضمنية أو غير العلنية للتفاهم النووي الأميركي الإيراني.
سعت إسرائيل إلى الاستفادة من الانكفاء الأميركي عن المنطقة الذي تم أساساً بالتفاهم مع الحشد الشعبي الإقليمي، أو حلف الأقليات المذهبي الذي تقوده طهران، بينما تسعى، الآن، جاهدة إلى الاستفادة من الاحتلال الروسي الفظ لسورية، بالتفاهم مع حلف الأقليات نفسه، علماً أن تل أبيب مولعة تاريخياً بالتحالف مع الأقليات، سواء كان ذلك مع سعد حداد وجيش لبنان الجنوبي في لبنان، أو مع الملا البرزاني والأكراد في العراق، وحتى مع قبائل الدينكا في جنوب السودان، وهذا سبب إضافي، ربما لابتعادها المضطرد عن أنقرة التي تتموضع شيئاً فشيئاً في قلب الأكثرية الإسلامية الممتدة من ماليزيا حتى طنجة.
 ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
١٤ ديسمبر ٢٠١٥
بعد ثلاثة أيام من البحث والمشاورات في الرياض، اتفقت المعارضة السورية على رفض أي دور للأسد في "مستقبل" سورية، وهو الموقف الثابت لها منذ بداية الثورة، غير أن الصياغة الجديدة التي تبنتها المعارضة تشبه كثيراً تلك التي اختارتها الدول الغربية قبل أشهر، عند الحديث عن بقاء بشار الأسد أو رحيله، فقد تبدل فيها الإطار الزمني لرحيل الأسد من "فوراً"، أو "قبل أي حوار"، إلى "المستقبل". وهذه من تجليات التغير "الإجباري" الذي بدأ يظهر على مواقف المعارضة السورية، أخيراً. أخذاً في الاعتبار أنه تغير لم يرتبط بمؤتمر الرياض زمنياً أو موضوعياً، وإنما هو صدى تحولين مهمين استجدا على معطيات الأزمة، أولهما التدخل الروسي العسكري المباشر الذي غيّر موازين القوى على الأرض، ومن شأنه أيضاً تغيير مفاعيل الأزمة سياسياً، ومن ثم مبادئ التسوية وملامحها. ثانيهما ليس تغير، وإنما انكشاف الموقف الغربي. الذي لم يتحرك، يوماً، بشكل عملي لإزاحة الأسد، أو حتى التضييق عليه، ولو بحصار بحري، أو حظر جوي، لحرمانه من واردات السلاح الذي يضرب به السوريين المدنيين.
على هذه الخلفية المزدوجة، وبفضل عامل آخر مسكوت عنه، شهد لقاءا فيينا 1 و 2 إقراراً إقليمياً ودولياً ببقاء الأسد إلى أجل غير معلوم. ومن ثم فإن جديد المعارضة بشأن مصيره هو تراجع عن الموقف الأصلي، وليس تأكيداً له. وبالتالي، التفاوض الذي يفترض أن يتم في يناير/كانون ثاني المقبل بين فصائل المعارضة و"ممثلين" عن النظام هو، في جوهره، بل وفي شكله، حوار مع النظام. أما بقية ما تضمنته اجتماعات الرياض من نتائج، فهي لا تغير كثيراً من محصلة جانب المعارضة في معادلة الأزمة وموازين أطرافها، فربما كانت "الهيئة العليا للتفاوض" أكثر شمولية في تمثيلها فصائل معارضة من الائتلاف، الذي كان هو أيضاً أوسع نطاقاً من المجلس الوطني السوري، لكنها تظل غير ممثلة لكل فصائل المعارضة، فضلاً عن تحديد دورها في إدارة العملية التفاوضية. والجديد السلبي، هنا، أن اتساع نطاق التمثيل والعضوية، قابله اختزال الدور والصلاحيات، ما يعني انتهاء فكرة تمثيل المعارضة للشعب السوري، أو تجميدها، إلى أجل غير مسمى. وبدلاً من أن يحل "الائتلاف الوطني السوري" معضلة دمج الفصائل السياسية الأخرى معه، ويسعى إلى التنسيق مع الفصائل المسلحة، وتوحيدها، لتصبح ذراعاً عسكرياً له، إذا بصيرورة العلاقة بين أطياف المعارضة ككل تختلف وتؤول إلى فصل السياسي عن العسكري، بشكل عام، والتنكر لبعض الفصائل المسلحة، تجنباً لشبهة "الإرهاب" الفزاعة التي تتذرّع بها موسكو لانتقاء المعارضة التي يُسمح لها بمحاورة النظام. ولم تألُ الفصائل المشاركة في مؤتمر الرياض جهداً في إبراز مساوئها، بالاختلاف حول الأسماء المختارة، سواء في وفد التفاوض (15 عضواً) أو في الهيئة العليا (32 عضواً). وعلى الرغم من تجاوز الخلافات في النهاية، والتوافق على الأسماء المختارة، إلا أن ما جرى يؤكد استمرار منطق المصالح الضيقة، وبقاء العقليات نفسها التي أضاعت فرصاً كثيرة على الثورة السورية، من دون تغيير. هذا هو المسكوت عنه، إنه انقسام المعارضة السورية المستمر منذ خمس سنوات، من دون تقدير لتضحيات ملايين السوريين، ذلك الانقسام الذي أفضى، في النهاية، إلى التعويل على حل سياسي، لن يخرج عن بضعة حقائب وزارية وانتخابات في ما تبقى من مناطق لم تدمر. تلك المعارضة متعددة المشارب والولاءات والأجندات، المنقسمة في داخلها، والمختلفة دائماً على المقاعد والأسماء، لم تنجح لا في إقناع العالم بإسقاط بشار ولا في التوحد أمامه. حريّ بها السقوط، ولينتظر الشعب السوري معارضة جديدة، جديرة به وبتضحياته.
 ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
١٣ ديسمبر ٢٠١٥
نجح مؤتمر فصائل المعارضة السورية في الرياض، وأكد شراكةً سعودية - سورية تامة لأجل سورية حرة، مدنية وتعددية يناضل لأجلها سلماً أو حرباً، وذلك عندما اتفق على أن تكون الرياض مقر «الهيئة العليا للتفاوض» التي ستقود المعركة الديبلوماسية لإسقاط بشار الأسد ونظامه في اجتماعات صعبة في نيويورك الشهر المقبل. أما إن لم تنجح الديبلوماسية فالبديل هو استمرار الثورة والعمل المسلح بدعم سعودي. ليس هذا قولي، وإنما تصريح متكرر من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكده مجدداً في مؤتمر صحافي إثر اختتام قمة مجلس التعاون التي توافق موعدها مع اجتماع المعارضة، فأكدت دعمها لما يتفق عليه السوريون والسعوديون أيضاً.
أسهم في نجاح المؤتمر هيثم مناع وصالح مسلم بغيابهما، الأول زعم يوماً أنه ناشط حقوقي، والثاني زعيم لحزب كردي انفصالي، وحسناً أنْ غابا ومن يوافقهما الهوى، فلو حضرا لفجّرا الاجتماع، ليس بطريقة «داعش» المفضلة، وإنما بإثارة قضايا الهوية وحقوق الأقليات والمرأة و «علمانية الدولة» وإلى كم من الديموقراطية تحتاج سورية المستقبل، وحدود الإقليم الكردي وعلاقته بكردستان الكبرى. يفعلون ذلك بينما لا يجد السوري في الداخل ملجأ يحميه من قصف وقتل القوى «العلمانية» الروسية، أو البعثية «التقدمية»، وحتى الطائفية الإيرانية الحريصة على «نصرة المستضعفين»، بحسب زعمها.
هناك كُثُرٌ مثل هيثم مناع وصالح مسلم، سوريون وغير سوريين، يتركون القتل الجاري والجوع والتهجير العرقي ويريدون مناقشة وثيقة صدرت عن «أحرار الشام»، أو خطبة ألقاها قائد في «جيش الإسلام». هل هناك أفضل من استخدام صور أقفاص دوما التي وضع فيها ثوارها علويين وتركوهم على أسطح المنازل لعلهم يردعون النظام والروس عن استهداف المدنيين والمستشفيات بعلم ومعرفة؟ كان منظراً قبيحاً، وتصرفاً خاطئاً، ولكن يجب رؤيته في سياق مشاهد آلة القتل الكبرى التي تسحق كل يوم مئات السوريين وسط صمت دولي.
نجح المؤتمر لأنه جمع السوريين المؤمنين بفكرة «الجماعة السورية الكبرى». لكل منهم - الإسلامي والقومي والوطني والكردي والمسيحي وبقية الهويات السورية - رؤية وأمنية في سورية المستقبل. لكنهم يعلمون أن تلك الأماني لن تتحقق في سورية الأسد الطائفية القمعية، ولا سورية الفوضى أو سورية المُقسّمة، ولا حاجة إلى ذكر سورية «داعش»، وبالتالي نظر كل منهم أولاً إلى العوامل المشتركة التي تجمعه مع أبعد سوري في قاعة مؤتمرات فندق «انتركونتيننتال» في الرياض، فكانت التخلص من بشار، ووحدة الوطن، وتفكيك مؤسسات النظام الأمنية، ومدنية الدولة، ثم انتقل إلى تفاصيل تجادلوا فيها في شأن المرحلة الانتقالية ومدتها، وما إذا كان لبشار مكان فيها. المهم أن يرحل مثلما صرخ أول شاب في حماة يوم كانت الثورة سلمية وهتف: «ارحل.. ارحل يا بشار». كان ذلك شعاراً جامعاً هناك، وجامعاً أيضاً في الرياض.
ولكنه يعلم أيضاً أن هذا الشعار غير مجمع عليه خارج السعودية وحلفائها الصادقين القلائل، فليس كل قادة العالم، حتى أولئك الذين تسمّوا يوماً «أصدقاء الشعب السوري»، مستعدين لأن يذهبوا إلى حد الدعم غير المحدود الذي نقله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إلى ممثلي الفصائل المسلحة الذين خصهم بلقاء قبيل افتتاح المؤتمر، فقال لهم: «نحن إلى جانبكم حتى تحقيق طموحات الشعب السوري البطل مهما كلفنا الأمر». بل حضّهم على الصمود ورفع سقف مطالبهم، مؤكداً أن المملكة لن تقبل بدور لبشار الأسد في أي صيغة حل، «موقتة أو دائمة».
في الوقت نفسه يرون تسريبات من حلفاء مفترضين كالولايات المتحدة تكشف أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخذت تقتنع أكثر بأن الأسد هو شر أصغر بالمقارنة مع «داعش»، كما كشفت مذكرة كتبها منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي السابق فيليب غوردون ونشرت الأسبوع الماضي. هذا التطور يشير إلى حيرة الإدارة الأميركية حيال النظام السوري، ما يرجح بالتالي تفضيلها الدفع بمصير بشار إلى طاولة المفاوضات وليس الحسم العسكري أو الأممي «لأنه لن يسقط عسكرياً» على أمل الاستفادة بإبقاء الدولة السورية وجيش بشار وتوظيفهما في الحرب على «داعش».
فكرة ساذجة بالنسبة إلى سوري أو سعودي يعرف سورية جيداً ويمكن أن تسمعها بغمغمة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مثل قوله الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في أثينا: «ليس واضحاً بعد ما إذا كان يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل أولاً لتأمين وجود تعاون بين المعارضة المسلحة والجيش السوري لمحاربة تنظيم داعش». ترجمة ما سبق وإعادة تركيبه من جديد هو التحدي الذي سيواجه المملكة والسوريين في مفاوضات كانون الثاني (يناير) المقبلة التي يفترض أن تناقش مرحلة الحكم الانتقالي، والتي سيفاوض فيها الوفد الذي انبثق عن مؤتمر الرياض وحظي بغطاء شرعي من الشعب السوري ودعم سعودي - ويفترض - إقليمي ودولي.
قول ذلك أسهل من فعله، فالمعركة هنا ستكون في محورين: الأول مع الأعداء وهم الروس والإيرانيون غير المتحمسين أصلاً لاجتماع الرياض ونتائجه، والذين سيشكّكون فيه ويحاولون مرة أخرى نفي صفة التمثيل والاعتدال عنه، ومع الحلفاء المترددين والحائرين الذين يقولون كلاماً مغمغماً مثل تصريح كيري أعلاه ومذكرة غوردون المشار إليها والتي يؤيدها حتى الآن المنسق الجديد للشرق الأوسط روب مالي، وهو خبير أمني في الإرهاب.
السعودية تريد أن تستنفد إمكان الحل السلمي، فهي مدركة أن التدخل الروسي غيّر قواعد اللعبة، وأن «داعش» من جهته غيّر أولويات الغرب والولايات المتحدة بعد اعتداء باريس، لذلك أمامهم والسوريين، بعدما أصبحوا فريقاً واحداً، اختراق هاتين الجبهتين: إقناع الحلفاء بأن من المستحيل تشكيل قوة سورية وطنية تحارب «داعش» قبيل إسقاط نظام الأسد، والغرب المستعجل الذي يتخيل أن في الإمكان توحيد قوى المعارضة مع الجيش ومخابرات النظام الغارقين في الطائفية ودماء الشعب السوري معاً، وهو ما سترفضه بالتأكيد الفصائل المقاتلة التي شاركت في مؤتمر الرياض ثقة بالمملكة، ولكنها تتخوف كما أوضح بيان لـ «أحرار الشام»، وهي جماعة لا تخفي سلفيتها وجهادتيها وتطلعها إلى دولة إسلامية في سورية، فوضعت سقف مطالبها في خمس نقاط، هي: تحرير كل سورية مما وصفته بـ «الاحتلال الروسي - الإيراني والميليشيات الطائفية»، وإسقاط كامل النظام وتقديم أركانه لمحاكمة عادلة، وتفكيك أجهزته الأمنية، ورفض المحاصصة الطائفية والسياسية، وأخيراً الحفاظ على هوية الشعب الإسلامية وإعطاؤه حق تقرير المصير وفق هويته.
الغالبية الشعبية السورية ستؤيد مطالب كهذه. «أحرار الشام» ومعها «جيش الإسلام» يشكلان عماد الثورة السورية التي لولاها لما كان هناك دور لمثل هيثم مناع وصالح مسلم، ولاستطاع النظام القضاء على الثورة والبطش بهما أو إبقاءهما لاجئين خارج الوطن، وبالتالي فمن حق العالم الاستماع إلى هذين الفصيلين، خصوصاً بعد الزخم الذي حصلا عليه في المؤتمر، ما يجعل من السخف رفضهما وتصنيفهما جماعتين إرهابيتين من الغرب أو دول المنطقة.
لكن بالتأكيد سيرفضهم المعسكر الروسي والإيراني، وفي الغالب سيعطل مفاوضات الحكم الانتقالي التي - رغم غمغمة كيري - لا تعني غير بداية النهاية لنظام بشار، فهم يعلمون أن اللحظة التي يوقع فيها مندوب النظام على اتفاق يقول إن على النظام التخلي عن استئثاره بالسلطة وإشراك الثوار في إدارة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة وبإشراف دولي، وقبل ذلك كله وقف إطلاق النار بقرار أممي، فسيبدأ انهيار النظام وخروج أزلامه وعوائلهم زرافات ووحداناً إلى قبرص ولبنان، فلا يبقى من يقاتل باسم الجمهورية العربية السورية سوى الإيرانيين والروس.
إذاً لماذا هذا المؤتمر وهذه المفاوضات؟ لنرسل صواريخ «مانباد» الآن إلى الثوار فوراً! قول ذلك أيضاً أسهل من فعله، إذ علينا جميعاً المضي في مسار «جنيف» و «فيينا» و «نيويورك»، فحلفاؤنا ليسوا على قلب رجل واحد، وعلينا المضي في طريق الأشواك هذا حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
الخبر الجيد أن الشعب السوري صامد، والسعودي صامد بصموده ومستعد لأن يدعمه بلا حدود و«مهما كلفنا الأمر»، كما قال الأمير محمد بن نايف لثوار أتوه من أرض الرباط الشامية.
 ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
١٣ ديسمبر ٢٠١٥
بعد سنتين وأكثر من الحصار المطبق، أسلم حي الوعر الروح.
أطلق آخر أحياء حمص، «عاصمة الثورة» السورية أنفاسه في حافلات نقلت المسلحين وعائلاتهم إلى وجهات شبه معروفة في الريف الشمالي ومصائر مجهولة تماماً، لتصبح المدينة بأكملها تحت سيطرة النظام استعداداً لعودة «مؤسساته» المزعومة إليها.
قوافل المساعدات الإنسانية والهلال الأحمر التي بدأت تصل إلى الأهالي قبل ترحيلهم، ووعود «تسوية الأوضاع» بالنسبة للمقاتلين جعلتهم يتجرعون السم بشيء من التسليم والرضى، كما جرى من قبلهم مع أهل الزبداني وغيرها من مناطق «التسويات» والهدنات المفروضة بقوة الحصار والجوع.
صحيح أن حي الوعر تحديداً لم يكن من أول الأحياء المنتفضة في حمص، ولا حمل ثقل الثورة كأحياء أخرى مثل الخالدية وبابا عمرو، وصحيح أيضاً أن تبادل الخدمات وفرض الخوات بين حواجز الجيش النظامي والشبيحة من جهة وبعض حواجز الفصائل المقاتلة من جهة أخرى كان يجري على قدم وساق عند مداخل الحي ومخارجه، لكن يبقى لإخضاع آخر معاقل الثورة في عقر دارها، طعم مر وموجع.
حمص تعود بكاملها إلى «حضن الوطن». هل من مرارة وانكسار أقسى؟
مر سقوط المدينة بهدوء نسبي، أو ربما لم يكن مفاجئاً لكثيرين بعدما ذهبت الأمور إلى تسويات سياسية كبرى، لكن يبدو أنه كان مخططاً لها منذ زمن. ففي تقرير لم ينشر كاملاً لمستشارين من فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ويعود إلى مطلع العام الحالي، ثمة شرح مستفيض عن «النجاح في إبرام صفقات الهدنات، وضرورة الاستمرار بها لوقف التصعيد الحربي عبر استقطاب المقاتلين المعارضين للنظام سواء بالقتال إلى جانبه ضد «داعش» أو بالتخلي كلياً عن السلاح». ويستشهد معدو التقرير بـ «نجاح تجربة الهدنات في العراق في 2007، وضرورة استعادتها في سورية».
وفي خطة كاملة وطويلة النفس لإخضاع المناطق الثائرة بإشراف دولي، اعتبر التقرير أن «الحرب هي المشكلة الأولى في سورية. فهي التي تتسبب بالموت، والدمار، والتهجير، والفقر والطائفية (...). والحرب تسببت في اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وتعذيبهم وقتلهم على رغم أنهم في غالبيتهم أبرياء من أي نشاط معاد للنظام». وإلى ذلك، قدم فريق العمل شهادات تفيد بأنهم راقبوا عن كثب حسن إدارة النظام للمناطق العائدة إلى كنفه، وحسن معاملة سكانها معتبرين أن الهدنات هي «السبيل الوحيد لعودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية، واستعادة أعمالهم، ويشعروا عن حق بجدوى قرارهم الشجاع في تقديم التنازلات».
هكذا، يأتي تسليم حي الوعر للنظام، كقطعة أخيرة من «بازل» التهدئة ومحاربة الإرهاب، كما و»يصب في صلب القرارات الشجاعة» بعد سنتين ونصف السنة من التجويع والإفقار، فيما لا تزال مصائر المعتقلين والمختفين قسراً في ذمة بند من بنود التفاوض.
لكن ماذا جرى في هدنات اليرموك والزبداني والقصير وبابا عمرو؟ هل نذكر مفاوضات بابا عمرو مثلاً؟ أين ذهبت تلك الحافلات كلها ومن عاد منها ومن بقي؟ ربما لم يتسن لفريق التدقيق البحث في تلك التفاصيل وقياس درجة الشجاعة، طالما صمت صوت الرصاص. لم يمض وقت طويل لننسى خروج المسلحين من حمص القديمة ثم إلقاء القبض عليهم بعد وعود بـ «تسوية» أوضاعهم، ولا «فخ» مدرسة الفردوس واعتقال العشرات فيها وتجويعهم ثم تصفيتهم تدريجاً. آنذاك خرجت باصات كما باصات الوعر بالأمس، ورفعت لافتات تحتفل بالهدنة وعودة الأحياء المتمردة إلى كنف الدولة، على خلفية دمار هائل وهياكل قطط ماتت جوعاً.
لسبب غير مفهوم ولا منطقي ربما، يعيدني تسليم حي الوعر للنظام، إلى جريمة اختطاف الناشطين الأربعة في دوما، رزان وســميرة ووائل وناظم، وهو للمفارقة جاء متزامناً مع الذكرى الثانية لاختفائهم. أفكر بتلك الهدنة غير المعلنة التي جعلت مصيرهم على ما هو عليه الآن... مصير يتشابك بمصائر أخرى قد تفضي إلى حضن الوطن أو حضن ثورته، لا يهم طالما ثمة من هو مستعد لإخضاع المدن، والأحياء والأشخاص.
لا تترك صور الخارجين من حي الوعر وإصرارهم على الاعتذار عما دفعوا إليه دفعاً إلا الغضب والألم. صفحات التواصل الاجتماعي حفلت بصور «رزان ورفاقها»، ومقاطع فيديو لأولى تظاهرات حمص مذيلة بالعبارة الشهيرة «عندما أرحل تيقنوا أني بذلت ما في وسعي لأبقى». ربما يفيد تذكير مستشاري دي ميستورا بأن الشجاعة تكمن في محاولات البقاء وليس في تقديم التنازلات، لكن لا مكان للكلام في السياسة هنا. فالسياسة تحاك هناك. في الرياض وفيينا وجنيف وغيرها من عواصم القرار... أما ما يبقى من «عاصمة الثورة»، فمجرد دفق عاطفي وحنين لأمكنة شهدت ذات يوم انطلاقة حلم بالحرية.
 ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
١٣ ديسمبر ٢٠١٥
قاد الحرج من القعود والتفرّج على مأساة الشعب السوري إلى جولات المندوبين الدوليين المكوكية، والمؤتمرات المتنقلة، التي عافها حتى الإعلام الذي لا يكل ولا يمل، وبدّد متعاطفون مع الشعب السوري الوقت، بالتحجج بعدم وحدة المعارضة. مرّت سنتان، وكادت تمر الثالثة من دون أن يسمع أحد بداعش. ولكن كل شتاء منها كان دهراً بالنسبة للشعب السوري. فخلافاً لما يسمى المجتمع الدولي في مؤتمراته، لم يبدّد النظام يوماً واحداً بدون تعذيب السوريين وقتلهم وتشريدهم.
وأخيراً، وصلت مواقف الدول الغربيّة، عمليًّا، إلى حدّ المصارحة بأنّ المشكلتين الرئيسيّتين في سورية، بالنسبة للغرب، هما تنظيم الدولة (داعش) وأمواج اللاجئين المتدفقة من سورية إلى هذه الدول. وحلت مشكلة النظام السوري نفسه في المرتبة الثالثة. (تداعيات: أما على غلاف مجلة التايم الأميركية فحلّت المستشارة الألمانية ميركل في المرتبة الأولى، واحتل البغدادي المرتبة الثانية، وكانت الثالثة من نصيب دونالد ترامب. واحتفت وسائل الإعلام العربية بهذه وكأنها منافسة عالمية فعلاً، وليس مجرد غلاف لمجلة أميركية. فأميركا وأوروبا هما العالم بالنسبة للإعلام العربي).
عبثاً، انتظر العرب من أميركا وأوروبا موقفاً جدياً بالنسبة لمعاناة الشعب السوري. وأضاعوا وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله بحثا عن بدائل أخرى عربية إقليمية. ولم يتخلّف شتات المعارضة السورية عن عملية هدر الوقت، فأوساطها كانت بداية تمنّي النفس بالنموذج الليبي، الذي انتهى إلى ما نرى ونشهد، وما سبق أن شهدنا في العراق. ولم تتمكّن من طرح بديل منظّم سياسي -مسلّح طوال الفترة السابقة، كما أن أطيافها لم تتعامل مع طرح بديل للنظام، أولوية ملحّة لا تقلّ أهمية عن مناهضة النظام.
يعرف القادة الغربيون والشرقيون تمام المعرفة أنّ أصل المشكلة في سورية طبيعة نظام الحكم، وأنّ رفض هذا النظام التجاوب مع انتفاضةٍ مدنيّة، سواء بالإصلاح أم باستنتاج ضرورة المغادرة من عدم القدرة على الإصلاح، وإصراره على الخيار الأمني، ثمّ العسكري، في قمع انتفاضة شعبه، أدّى إلى التخلّص من المظاهرات وتحويل الثورة السوريّة إلى حالاتٍ محليّة غير منظّمة للدفاع عن النفس. ولم تنجح حالات الدفاع المسلح عن النفس في التحوّل إلى تنظيم مسلّح وموحّد على المستوى الوطني. واقتحمت الميدان قوى مسلحة منظمة، بعضها لا علاقة له بأهداف الثورة السورية، ولا يميّز أصلا بين المعارضة والنظام، فملّة الكفر واحدة بالنسبة له. وبعضها الآخر ليس تكفيرياً، لكنه وجد في الإيمان حليفاً موثوقاً وحيداً. وحين تحوّل الكفاح المسلح إلى استراتيجية وحيدة ممكنة في مواجهة النظام، ظلّت هذه إمكانية وحيدة بدون استراتيجية، نتيجة لتشظي القوى المسلحة الذي لا يعرف حدوداً.
ثار هذا الشعب ضد صنوف القمع والإذلال والنهب التي يتعرّض لها الإنسان السوري، منذ ولادته وحتى مماته في ظل هذا النظام. وكان الصمت قبل ثورة الشعب السوري ممكناً، بسبب
"سيكون على السوريين طرح بديل ديمقراطي متكامل للنظام، وإيجاد الحلفاء لهذا البديل، وتوحيد العمل العسكري والسياسي والإعلامي لتغيير الوقائع على الأرض"
أدوار النظام الإقليمية المختلفة، وأحيانا المتناقضة. ولكن طبيعة النظام كانت معروفة، وحين ثار الشعب السوري، كان الجميع يعرف أن لديه أسباباً للثورة أكثر من غيره من الشعوب. ولهذا، أصبح الصمت محرجاً. ففي حالة الثورة السورية، لا يمكن إلا اتخاذ موقف متعاطف مع الشعب السوري. (أما من اختار الوقوف إلى جانب النظام، لأسبابه التي لا علاقة لها بالشعب السوري، فلا يمكنه إلا أن يتشنج بشكل مطلق، كآلية دفاع عن هذا الموقف -الجريمة في مواجهة العقل والضمير، معبّراً عن نفسه، بابتداع المؤامرات واختلاق الأكاذيب، لأن أي نقاش عقلاني يقوّض موقفه، وأي تعامل مع الحقائق يدحضه. وهو إضافة إلى ذلك لا يستطيع أن ينتقد أي ممارسة للنظام، مهما كانت إجرامية، لأن أي نقد هو شق قد يتسرّب منه الضوء إلى ذهنه عبر جدار الدفاع الأصم. ولهذا، يجد نفسه منقاداً للدفاع، حتى عن التعذيب والتهجير والبراميل المتفجرة).
لم ينجح من سمّوا أنفسهم لاحقًا "أصدقاء الشعب السوري"، في حماية المدنيين السوريين من إطلاق النار على المظاهرات بحرية تامة، واحتلال مراكز المدن السوريّة بالفرق العسكريّة المدرعة، والقصف العشوائي من الجو بالبراميل المتفجرة، وبغيرها ضد المناطق المأهولة التي خرجت عن سيطرته. ولا علاقة لحماية المدنيين بوحدة المعارضة السورية. ومع ذلك، لم يقوموا بحمايتهم، ولا حتى بالإنذار بتطبيق حظر الطيران.
ولكن الدول الغربيّة سارعت إلى اتخاذ موقف فعلي، عندما مُسّ مدنيّوها بعمليات الإرهاب المدانة والمستنكرة، أو حين مُسّت حدود مجتمعاتها بتدفّق اللاجئين. استنفر الغرب على الفور. ولكن، ليس لنجدة الشعب السوري، وإنّما في مواجهة هذين الخطرين حصرياً، مع تناسٍ مقصود لجذورهما الضاربة عميقاً في طبيعة النظام وسلوكه، وفي نكبة الشعب السوري. وتذكروا طبيعة النظام لأغراض التحليل فقط.
ولو ادعى السوريون أمام الدول الغربية أنّ النّظام هو خصم الشعب الرئيسي، وداعش هو خصمه الثّاني، لأجابهم بعض المسؤولين أنّه بالنّسبة للرأي العام الغربي داعش هو العدو الرئيسي، وأن النظام مستبد، لكنّه ينفذ عملياته ضدّ ملايين المدنيين السوريين، وليس ضد عشرات، أو ربما مئات، المدنيين الغربيين. يكتفي النظام بارتكاب جرائم إبادة جماعية "ضد السوريين فقط". ثمّة تراتبية ما في عالمنا بين حياة المدنيين، وكلنا يعرف ذلك. وما كان ينبغي لأحد أن ينساه للحظة.
سيكون على السوريين طرح بديل ديمقراطي متكامل للنظام، وإيجاد الحلفاء لهذا البديل، وتوحيد العمل العسكري والسياسي والإعلامي لتغيير الوقائع على الأرض وفي الرأي العام. ليس هذا منصفاً، فلم يُطلب من شعبٍ تلبية مثل هذه الشروط، لكي يتحرّر من الاستبداد. ولكن قضية الشعب السوري تعقدت، ليس فقط بسبب طبيعة النظام، وأدواره الإقليمية وطبيعة حلفائه، بل أيضاً جراء فعل قوة ظلامية، دخلت إلى ساحة الصراع ضد الثورة على النظام، قبل أن تكون ضد النظام نفسه.
 ١٣ ديسمبر ٢٠١٥
١٣ ديسمبر ٢٠١٥
كتب وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، مقالة يحدد فيها وجهة نظر حكومته حول وضع سورية "واحدة من أكبر الكوارث البشرية في الحقبة المعاصرة". واستعرض سعادته الإطار الذي تنظر جمهورية إيران الإسلامية من خلاله إلى الأزمة السورية، وحدد سبل الخروج منها، مؤكداً أن سياسة بلاده تجاهها قامت، منذ بدايتها، على المبادئ الثلاثة: احترام مطالب الشعوب وإرادتها في تعيين مصيرها، وإدارة وتعديل أمورها بنفسها، ومعارضة التدخل الخارجي لفرض رغبات أجانب على حكومة وشعب مستقلين، ورفض استخدام الإرهاب أداة لبلوغ أهداف سياسية في النزاعات الداخلية في البلدان الأخرى.
إذا كان هناك من لم يضحك بعد من سذاجة هذا الذي يتوهم أن سوريّاً واحداً سيصدق أن إيران تحترم "إرادة شعبه وحقه في إدارة أموره بنفسه"، فإنه سيضحك، حتماً، من الفقرة التي يدّعي فيها أن بلاده "تعارض التدخل الخارجي لفرض رغبات أجانب على حكومة وشعب مستقلين". يعرف السوريون ما تقوله جثث قتلى إيران، وهو أنها تتدخل ضدهم وتقاتل من أجل إخضاعهم لمجرم اغتصب رئاسة دولتهم، ويعمل لإبادتهم. ويعلمون، أيضاً، أن إيران تقتلهم، لأنها لا تحترم "حقهم في تعيين مصيرهم بأنفسهم" ، ولم ترسل "ملائكة" حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس إلى وطنهم، إلا لفرض إرادتها عليهم، مع أن وزيرها يدّعي أنه يرى فيهم شعباً مستقلاً يعارض فرض رغبات الأجانب عليه. يبدو الوزير كأنه يعتقد أن مرتزقة الولي الفقيه الذين يذبحون السوريين، ليسوا أجانب، بل عرباً عاربة، لا يدمرون سورية، إلا لحماية شعبها من الإرهاب، ومن لا يصدق، فليقرأ مبدأ سياسات طهران الثالث الذي يرفض "استخدام الإرهاب لبلوغ أهداف سياسية في نزاعات البلدان الداخلية". بعد أن صدّق السوريون أن قتلة حزب الله وأضرابهم من العراقيين والأفغان ليسوا أجانب، ها هم يصدّقون، أيضاً، أن المرشد الإلهي لا يستخدم إرهابهم لبلوغ أهداف سياسية.
ربما كانت السذاجة قد أوهمت الوزير أن كلماته يمكنها ليَّ عنق الحقيقة، وأن ضحايا سياسته سيصدقون أكاذيبه، عرفاناً بجليل خدمات جيشه ومرتزقته لهم، وأن قتل مواطنيهم لم تُمْلِهِ نيّاتٌ ومطامع خبيثة، بل كان يستهدف زيادة رواتب القتلى والمحاصرين بالحصار الغذائي والدوائي، ورفع قدرتهم على مواجهة الموت جوعاً أو حرقاً وتقطيعاً. لا عجب أن يختم الوزير أكاذيبه بالقول: "إن حل الأزمة السورية يأتي فقط من خلال إرادة الشعب السوري ورأيه، بما أن الوصاية على الشعوب قد ولت حقبتها، ولا يحق لأي من اللاعبين الأجانب التحدث باسم هذا الشعب".
يطبق الوزير سياسات تناقض أقواله، تحتقر عقل الشعب السوري، وترفض حقه في تعيين مصيره بنفسه، وتفرض رغبات إيران ومرتزقتها عليه، ولا تعترف به شعباً مستقلاً، وتستخدم الإرهاب لإطالة نزاعات داخلية في وطنه هي أيضا فتنة إيرانية لها أهداف سياسية خسيسة، يذبح السوريون بسببها منذ أربعة أعوام ونصف العام، ولولا تدخلها العسكري الوحشي والشامل، لكانوا اليوم شعباً مستقلاً وحراً وخارج قبضة الاستبداد والحرب.
يتحدث الوزير كأنه ملاك ويتصرف كسفاح. ولشدة سذاجته، يخال أن ضحاياه لن يروا سكاكينه وهي تجزّ أعناق أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، وتدمر ما بنوه خلال قرون في وطنهم. ويتوهم أن شعب الثورة من الغباء بحيث تنطلي عليه أكاذيب مفضوحة، يروجها أفاق يريد التلاعب بعقولهم!.
تقول حكمة دارجة: من لا يستحي فليقل ما يشاء. وتقول وقائع إيران السورية إن وزير خارجيتها ساذج، ولا يستحي.
 ١٢ ديسمبر ٢٠١٥
١٢ ديسمبر ٢٠١٥
لا يمكن بطبيعة الحال اعتبار مؤتمر الرياض بداية للعمل السياسي المعارض لنظام بشار الأسد، لكنه بكل تأكيد يشكل خطوة متقدمة في إطار عمل المعارضة السورية. فقد استطاع جمع كافة أطياف المعارضة تقريبا، بما فيها فصائل عسكرية مهمة، ووصل المؤتمرون إلى صيغة موحدة للمرة الأولى منذ سنوات من العمل الذي يمكن وصفه بالعشوائي وغير المنظم، والذي تخلله الكثير من الخلافات ما بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وما بين القوى الأخرى سواء منها الفاعلة على الأرض والتي كانت تنظر للائتلاف على أنه بلا فائدة، أو بعض القوى السياسية التي كانت تتصيّد أخطاء أعضاء الائتلاف وتصوّرها على أنها استمرار لنهج الفشل السياسي الذي ورثه المنضوون تحت راية الائتلاف من الحقبة الأسدية الطويلة. ولا يخلو هذا الاتهام من بعض الدقة، وإن كان يؤخذ على الكيانات الأخرى أنها ارتكبت بدورها بعض الأخطاء الكارثية التي أطالت من عمر المعاناة السورية، ومن عمر النظام في الوقت نفسه.
وإذا كان بيان الرياض قد وضع النقاط على الحروف، وحدد منهاج عمل واضح وكامل لمرحلة التفاوض التي ينتظر الجميع أن تبدأ قريبا، كما صرّحت بذلك واشنطن التي باركت بدورها اجتماعات الرياض واعتبرتها خطوة على الطريق الصحيح، ليس حرفيا، لكن على الأقل هذا ما يمكن تلمّسه من خلال الموقف الأميركي الداعم لجهود المملكة العربية السعودية، التي تبدو تصريحات كبار مسؤوليها متقدمة جدا. بل إن إصرار السعودية على الوصول بهذا الملف المعطّل إلى ما يمكن اعتباره بر أمان، تبدو أولوية بالنسبة إلى كبار مسؤولي المملكة الذين لم يفوتوا فرصة انعقاد مؤتمر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انعقاد أعمال مؤتمر المعارضة السورية، ليؤكدوا أن المملكة جادة في الوصول إلى حل يوقف نزيف الشعب السوري، ويحقق له آماله وتطلعاته في بناء دولة حرة، وبأن بشار الأسد سيرحل سلميا من خلال التفاوض أو عسكريا، كما كرّر ذلك أكثر من مرة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وعلى الضفة الأخرى لم تخف كل من موسكو وطهران امتعاضهما من المؤتمر، وقد اعتبر بعض السوريين هذا الموقف الروسي الإيراني دليلا على نجاح المؤتمر.
موسكو، وكالعادة، تعلّلت بالحرب على الإرهاب، وهي تدرك تماما أنها فشلت في تمكين الأسد على الأرض كما كانت تخطط، وأنه وبعد أكثر من شهرين من القصف المتواصل والدعم الجوي بلا حدود والذي تسبب بمقتل الآلاف من السوريين حتى الآن. كل هذه المساندة لم تستطع قوات الأسد أن تترجمها بانتصارات واضحة على الأرض، واكتفت بالوصول إلى مناطق معيّنة صباحا لتعود وتخسرها مساء، ولعل هذا ما يجعل موسكو غير قادرة على إدارة العملية كما كانت تخطط، وهي مضطرة بالتالي للقبول بحل تفاوضي يحفظ ماء وجهها.
الأمر نفسه ينطبق على الجانب الإيراني الذي لم يعد يكتفي بالانسحاب، بل إن نزيف قادته العسكريين وكبار ضباطه مستمر، وخاصة بعد أن باتت ميليشيا حزب الله عاجزة عن رفد الجبهة بمقاتلين جدد، بسبب الخسائر المتلاحقة والنعوش التي يتم تشييع ما تخفيه من أسرار كل يوم تقريبا في ضاحية بيروت الجنوبية، وإلى متى؟
لا أحد يمكنه التكهن بذلك، إذ تبيّن أن الثوار قادرون على الاستمرار في القتال دون توقف، وهم قادرون على تكبيد أعدائهم خسائر بشكل مطّرد، بل إن خبرتهم وقدرتهم القتالية تتطور بشكل ملحوظ. ولا يمكن التعويل على قوات النظام المهلهلة سواء في إعادة لملمة الدولة السورية المشتتة أو في قتال تنظيم داعش، وهو ما تتجه أنظار واشنطن إليه، في المرحلة اللاحقة، وقد عنونت واحدة من كبريات الصحف البريطانية بأن داعش هو العدو لكن الأسد هو المشكلة، وعليه فإن الابتهاج الذي أبداه ما يعرف بـ”محور المقاومة” بتصريحات متباعدة لعدد من المسؤولين الأوروبيين عن إمكانية إشراك الأسد في مرحلة انتقالية، أو التعاون معه لمحاربة داعش، لم تلبث أن خفتت، فالأسد مهزوم عاجلا أم آجلا، وعلى المجتمع الدولي أن يعد العدة لمرحلة ما بعد الأسد بكل تداعياتها واحتمالاتها، وقد يكون هذا هو العنوان الذي لم يتم الإعلان عنه لمؤتمر الرياض، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن مؤتمر المعارضة السورية سيكون تحت هذا العنوان.
أخيرا، ثمة مفارقة لافتة تتمثل في إيعاز النظام لبعض الأحزاب والقوى المعارضة التي فصّلها على قياسه كي تعقد مؤتمرا في دمشق بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الرياض، ويخرج المؤتمر ببيان ختامي يؤكد أن المجتمعين لا يقبلون تدخلا من أحد في شؤون سوريا الداخلية، والمقصود هنا المملكة العربية السعودية تحديدا، لكنهم بكل تأكيد لا يمانعون في قبول الوصاية الروسية والتوجيهات الإيرانية.
 ١١ ديسمبر ٢٠١٥
١١ ديسمبر ٢٠١٥
بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى المطلوب تنفيذها من خلال مؤتمر" الرياض" ، بات القسم المتعلق بالمعارضة شبه منتهي ، و الأوراق قد قدمت للراعي المسؤول عن الطرف الثاني "نظام الأسد" ، لتحديد كيفية و توقيت البدء بمرحلة المفاوضات و الدخول في التطبيق الفعلي لما تم الإتفاق عليه في فيينا .
لعل مخرجات مؤتمر الرياض أثارت من العواصف ما يكفي ، ولن تنتهي إرتدادتها في أروقة المعارضة بمختلف صنوفها خلال ساعات أو أيام ، و أخص بالتركيز على الفصائل العسكرية ، التي ستعاني من فترة ضياع كبيرة ، لما يعتبر خروج عن مبادئ أساسية في التركيبة المتعلقة بالفصائل كـ"إسلامية الدولة " و طبيعة الشركاء ، إضافة لمصير شركاء على الأرض مصيرهم قد يكون في خطر .
صحيح أن هناك سلبيات أخذت حيز من المناقشات لدى غالبية الشعب ، ونفس الأمر ينطبق على الإيجابيات ، لكن يبقى الأهم والمتمثل في قضيت تطبيق نتائج "الرياض" ، و شروط ما يعرف بحسن النية من "خروج الأسد بعد 6 اسابيع من انطلاق المفاوضات – وقف القصف و التهجير – عودة اللاجئين و فك الحصار ..." ، التي تجعل من التطبيق أو المباشرة بالتفاوض هي معضلة و أمر قد لا يتحقق ، كون الأمور لا تأتي بالتمني ، فالواقع يكرس أنه لا تغيير سيحدث في المدى المنظور ، رغم الإفراط التفاؤلي من قبل الراعاة الدولين و على راسهم أمريكا التي رأت أن الشهر القادم سيكون موعد اطلاق التفاوض ، والبدء في مسيرة الأميال الغير محددة و الغير معروفة التأريخ ، تبعاً لكثرة اللاعبين و ووعورة طريق السلم .
ومع هذه التعقيدات ، ووجود فرص كبيرة للفشل و العودة من جديد إلى الحرب ، التي ستكون أشد ضراوة و شدة وعنف ، يجب على الجميع أن يكونوا حاضرين لهذا الأمر ، ولايعني الركون إلى الشق التفاوضي أن يُنسى الشق الدفاعي ، وبل يجب أن يكون هجومي أيضاً .
فالعبث الروسي مستمر و إمدادات السلاح و الذخيرة على اشدها ، و التي تنبئ أن روسيا ليست في المنطقة لقتال شعب ثائر على حاكم ظالم ، و كذلك ايران التي زجت خلال الفترة القصيرة الماضية بقرابة الـ 7000 عنصر من قوات النخبة في الحرس الثوري في أتون الحرب ، الأمور التي تجعل من قضية وقف إطلاق النار المفروض أن تتم الشهر المقبل ، ماهي إلا فرصة للملمة الطرف المقابل لجروحه التي أثخن بها الثوار ، ليكون الهجوم عند إفشال الجهود السياسية بمثابة ضربة قاضية .
 ١١ ديسمبر ٢٠١٥
١١ ديسمبر ٢٠١٥
أمام أعضاء مؤتمر الرياض للمعارضة السورية مهمات وصعوبات عديدة، جرى الحديث عنها بإسهاب وتفصيل، وقدمت من أجل مواجهتها أوراق مهمة ومفيدة. ولا شك أن الكتل والمنظمات والشخصيات المشاركة تدارست ذلك وغيره، كما أنه تراكم لديها الخبرة الكافية والمريرة خلال تجربة السنوات الخمس العجاف من عمر الثورة السورية، بما عرفته من مؤتمرات وحوارات، وما مرت به من ضغوط وصراعات، ويفترض بهم أن يكونوا على قدر من المسؤولية والأهلية، لأن يتوصلوا إلى توحيد رؤيتهم بشأن مفاوضات المرحلة الانتقالية، وربما من أجل تشكيل وفد المعارضة إلى المفاوضات المرتقبة.
لكن، بموازاة كل الضجيج والآمال المعقودة على تلك المفاوضات، والمنطلقة من القرار الدولي بعد مؤتمر فيينا، يمكن ملاحظة ما نعنونها، اليوم، بالمرحلة الروسية في الصراع السوري. وليس ذلك مرتبطا فقط بما هو واضح من شدة التدخل العسكري الروسي الذي بدأ مع هجمات سلاح الجو الروسي وقاذفاته منذ أكثر من شهرين، ثم تطور، أخيراً، مع نشر صواريخ إس 400، وضمن منظومة دفاع جوي روسية غطت سماء سورية، بعد إسقاط سلاح الجو التركي الطائرة الروسية، والتي حولت سورية إلى ما هو أشبه بالمنطقة الروسية الآمنة. بل إنه مرتبط كذلك بعمل حثيث وبطيء ومتدرج، يتمثل في موجة جديدة من بدء سريان هدن أو اتفاقات على طريق تنفيذ هدن في مناطق سورية متعددة، لطالما كانت، فترات طويلة، خاضعة لحصار الجوع أو الركوع، بدءاً من ريف دمشق وغوطتها إلى الوعر في حمص وغيرها، والذي طالما سكت المجتمع الدولي عن جريمة هذا الحصار الموصوفة في القانون الدولي، ضمن ما سكت عنه من سلسلة جرائم النظام السوري وحلفائه.
وإن كانت هذه الموجة الجديدة من الهدن استمراراً لاستراتيجية النظام في القضاء على بؤر الثورة، وإخماد شعلتها في حمص وداريا والزبداني وغيرها، تحت شعارات التهدئة والمصالحة، وسبق أن اندرجت، في إطار تدخل إيراني هامشي، يتلطى وراء مشاركة حزب الله وبعض القوى العسكرية. ودلّ على ذلك مشاركة المندوبين الإيرانيين في مفاوضات حمص القديمة والوعر، والزبداني، لكن حلول المندوب الروسي في مفاوضات الغوطة الأخيرة ارتبط بنقلة جديدة أعلى في مستوى تدخل حلفاء النظام وتحكمهم بمسارات الصراع السوري وتوظيفاته، بل صار يجري في إطار استراتيجية روسية أعلى، بدأت ترسم دولياً ملامح الحل السياسي منذ مؤتمر فيينا. وللمقارنة، لم يكن للحليف الإيراني مثل هذا التدخل والسيطرة، كما لم يكن لديه مثل هذا الموقع في توجيه الاستراتيجية الدولية، وهذا هو الفرق الأكثر أهمية.
قد يقال إن لا جديد في الأمر، وإن تلك الهدن تندرج، أيضاً، في سياق سعي مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي مستورا، إلى توظيف التهدئة والمصالحات المحلية في سياق استراتيجية جنيف/ فيينا. لكن، إذا لاحظنا أن مساعي المندوب الأممي لا تملك أكثر من قوة بيانات الأمم المتحدة وقراراتها، على عكس القوة الروسية التي هيمنت على المجال العسكري السوري، بموازاة مبادراتها السياسية في إطار التحالف الجديد ضد الإرهاب. وعليه، فإن السياق الذي تجري فيه تلك الهدن، إنما هو سياق وقائع المرحلة الروسية الجديدة التي تتغيير موازين القوى فيها ميدانياً، وعلى مختلف المستويات عسكرياً وجغرافيا، والذي سيستكمل السيطرة على من تبقى من السوريين المنهكين جوعاً وقهراً، بينما استكملت الهجمات الإرهابية المشبوهة تحشيد التحالف الدولي الجديد. والذي تمكنت روسيا والنظام خلفها من حجز دوريهما فيه، مع ما رافقه من دعواتٍ غربيةٍ جديدة إلى لغة خلاقة بخصوص رحيل الأسد، وإلى الاستفادة من الجيش السوري في محاربة الإرهاب.
هذا التطور يعني أن الصراع في سورية وعليها ما زال مستمرا وعلى أشده، وليس الخلاف الروسي التركي إلا أحد جوانبه المفتوحة. ولن تكون المفاوضات، إذا بدأت، إلا حلقة جديدة من حلقاته التي يبدو أنها ما زالت طويلة ومستمرة، وقد انخرطت فيه قوى عظمى، تجد حكوماتها في مشاركتها فيه، لا دفاعاً عن حصصها ومصالح بلدانها فقط، بل وجهاً من وجوه صراعاتها السياسية الداخلية أيضا، كما هو متجلٍّ بصورة حادة في أوروبا اليوم.
تتطلب هذه الرؤية المفتوحة للصراع من مؤتمر المعارضة في الرياض لا أن يكتفي بتوحيد رؤيته ووفده حول المرحلة الانتقالية ومفاوضاتها، وهو أمر مهم، وسبق أن تقاربت رؤى مختلف فصائلها حوله، بل أن يرتفع إلى مستوى مواجهة المرحلة الطويلة التالية من الصراع، ويلبي حاجة طال انتظارها، وهي أن لا يكون انعقاده أمراً استثنائياً وعابراً، واستجابة لضغوط الآخرين، بل أن يتجاوز ذلك إلى تشكيل مرجعية مستقرة للثورة السورية، يمكنها أن تتفرغ نهائيا للثورة ومقتضياتها، فتمكث مثلا في مكان واحد، لعله يكون في الأراضي المحررة أو بجانبها، بدل أن يستمر ممثلو الثورة مهاجرين ومتنقلين بين العواصم، وأصحاب مناصب بلا مؤسسات. وكي يتوحد التمثيل، أخيراً، بدلا من هذا الانفصام الزائف والمستمر بين معارضتين، داخلية وخارجية.
وضداً عما هو شائع من تذرّر وانقسام في الجماعة السورية، ورداً نهائياً على حجة النظام وحلفائه، بكونه طرفاً موحداً، في حين يفتقد الطرف الموحد المعارض، فهل يمكن للمؤتمرين أن يتعالوا على ذاتياتهم وانقساماتهم وروابطهم المناطقية والحزبوية، وأن يرتقوا إلى ما هو أرفع في تمثيل الثورة السورية، فيستقيلوا جميعاً من أوهام ونزوعات الفرد والرئيس، الذي طالما حشرت واختصرت فيه الشخصية السورية، كي يتوافقوا على مرجعية تسير بالثورة إلى بر أمان المرحلة الانتقالية، حيث يتولى البرلمان الحر القادم انتخاب القيادة التالية، وتخوض البلاد تجربتها الديمقراطية، بما فيها من آلام التجربة والعدالة الانتقالية، وبما ستعانيه من صعوبات إعادة الإعمار والبناء.
إنتاج المرجعية الموحدة هو الحاجة الرئيسة في الثورة السورية، وهو ما تستحقه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ثورة الشعب السوري وتضحياته التي فاقت كل ما عرفته الثورات الأخرى.
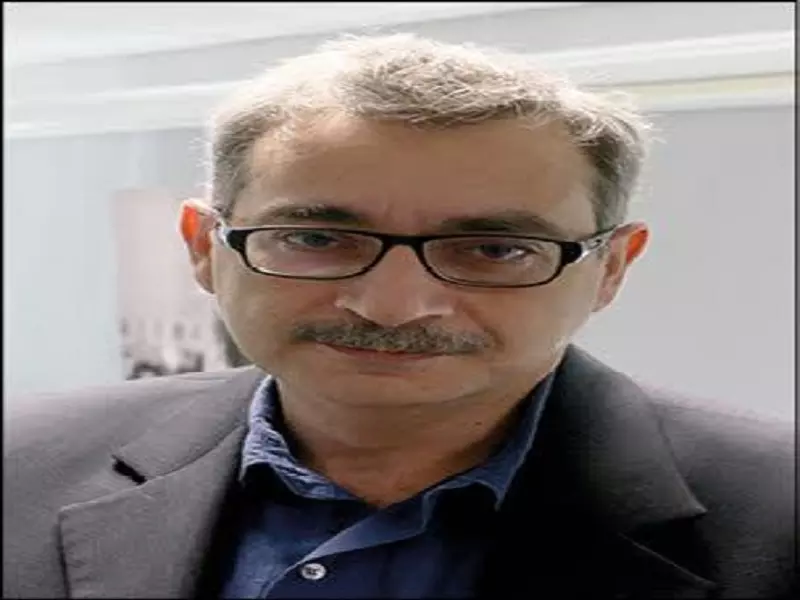 ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
١٠ ديسمبر ٢٠١٥
يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يضطر إلى تزويد الصواريخ «الحديثة والدقيقة» التي تطلقها قواته على مناطق سيطرة «داعش» في سورية رؤوساً نووية في سياق الحرب على الإرهاب.
منذ نهاية الحرب الباردة، نادراً ما صدر كلام جديّ عن استخدام الأسلحة النووية عن سياسي يتسم بحد أدنى من المصداقية. وباستثناء شطحات بعض غلاة المحافظين الجدد في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أو المحيطين بها من الذين اعتادوا توجيه تهديدات أكبر من أحجامهم، أثناء غزو أفغانستان والعراق وفي ذروة الأزمة حول برنامج إيران النووي، لم تعد معتادة الإشارة إلى السلاح الذري، سواء على المستوى التكتيكي الذي لوح به بوتين أو على مستوى الخيار الاستراتيجي الذي كان سائداً بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي.
أرست الحرب الباردة ما يصح وصفه «بالأدبيات» في تناول الأسلحة النووية، خصوصاً بعد مواجهات كادت تدمر العالم، مثل أزمة الصواريخ الكوبية واقتراحات بعض الجنرالات الأميركيين بقصف كوريا وفيتنام نووياً أثناء الحربين هناك، وتشبّع القيادتين السوفياتية والأميركية بهاجس الإفناء الناجز المتبادل. حملت تلك الخبرة جانبي الصراع، السوفياتي والأميركي، على إبداء درجة أعلى من «الحكمة» في التعامل مع المسألة النووية.
تعريفاً، السلاح النووي يوجه لتدمير المراكز المدنية والاقتصادية والسياسية عند العدو. أما الأسلحة النووية الصغيرة من النوع الذي تحدث عنه بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، فتُستخدم –نظرياً– ضد الأهداف العسكرية الضخمة: القواعد الكبرى والمطارات وحاملات الطائرات، ويكون استخدامها في سياق حرب نووية مفتوحة.
بديهي أن الحقائق هذه حاضرة في ذهن الرئيس الروسي، الذي يعرف حكماً أن استهداف أي منطقة يحتلها «داعش» بذخيرة نووية مهما صغر عيارها، يعني الموت الفوري لعشرات الآلاف من المدنيين، إلى جانب بضع مئات من مسلحي التنظيم الإرهابي.
تُفصح معادلة قتل آلاف الأبرياء مقابل القليل من المجرمين، من جهة، عن فشل أخلاقي فظيع يعاني منه بوتين الذي يحاول إخفاء هذه النقيصة بإبداء «الأمل» في ألا يضطر إلى الخطوة النووية، ويتشارك في فشله هذا مع المواقف القديمة لمحافظي أميركا الجدد. وتعلن، من جهة ثانية، بؤس السياسي الذي لا يملك سوى التهديد باللجوء إلى ما يفتقر اللجوء إليه إلى المعنى والجدوى باستثناء الدمار والقتل المجانيين، فالتلويح بقتل الذبابة بمدفع لا يكشف مهارة الرامي بقدر ما يُظهر خرقه وانعدام الوسائل الناجعة لديه في مكافحة آفة الإرهاب.
وإذا استفاد بوتين من فراغ القيادة في الغرب والانكفاء الأميركي ومن إدراكه أن لا التهديد ولا التنفيذ في حال حصوله، سيقابلهما أي رد فعل عملي، فإن ذلك لا يضعه في موقف متقدم على نظرائه من قادة العالم في حربه على الإرهاب، بل يجعله شريكاً لهم في عدم القدرة على استنباط أساليب تتجاوز اللجوء إلى القوة والحلول العسكرية الأمنية لكبح مشكلة تتخذ أبعاداً عالمية ويمتد نسيجها من جبال أفغانستان إلى أفريقيا.
وإلى جانب التبلد الأخلاقي والسياسي الذي تشير إليه فكرة قصف المناطق السورية بأسلحة نووية، فهي تقول إن ما من جهة عربية أو دولية ارتقت بعد إلى مستوى علاج ظاهرة الإرهاب من جذورها المتشابكة وصولاً إلى قمتها، وإن الحرب على الإرهاب أهم بأشواط من أن تُترك للضابط بوتين.
 ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
١٠ ديسمبر ٢٠١٥
عاملان رئيسيان يتحكمان بالسياسة الروسية حيال سورية والمنطقة، يعكسان تفضيلها تحقيق الأهداف المرحلية، مع تأجيلها البحث بأهدافها الاستراتيجية الكامنة وراء تحركاتها العسكرية والسياسية والديبلوماسية في الشرق الأوسط، والمتعلقة بمقاومتها تمدد النفوذ الغربي والأطلسي في دول أوروبا الشرقية، حديقتها الخلفية.
العامل الأول هو المواجهة المستجدة بين الجانبين الروسي والتركي التي حولها حادث إسقاط أنقرة طائرة «سوخوي» الى صراع مفتوح، مع ضوابط لا تقود إلى الحرب بين الدولتين.
أما العامل الثاني فهو أن لا حديث في نظر موسكو عن أي أمر في ما يتعلق بسورية والحل السياسي فيها وفي مستقبل المنطقة، إلا مواجهة الإرهاب، الذي التقطت حاجة الغرب الى إعطائه الأولوية بعد جرائم «داعش» في باريس والعديد من أنحاء العالم. بل إن الديبلوماسية الروسية باتت تربط المواجهة التي انطلقت مع أنقرة بعنوان الإرهاب، فتتهمها بتأييد الإرهابيين، وتهيئ لمزيد من الإجراءات ضدها.
بناء على هذين العاملين تسلك موسكو في دعايتها الإعلامية طريقاً يرفض منطق «النفوذ التركي المشروع» في الأراضي السورية، بحكم وجود أقلية التركمان والعلاقات التاريخية مع الشمال السوري. بل إن موسكو تقفز فوق تواجدها العسكري على الأرض السورية وزيادة عتادها وعديدها العسكري، قبل إسقاط طائرة «سوخوي» وبعده، لتدحض الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسعى الى تثبيت نفوذها في بلاد الشام، وتبرر بذلك اعتراضها على الطموحات التركية بالنفوذ في سورية، فهي ليست في وارد القبول بتنافس الدول على من يفوز في الميدان السوري.
تبعد موسكو عنها تهمة تجاهل مصالح تركيا ودورها واستبعاد السلطان الجديد من المشاركة بالحلول في سورية بإعطاء بعد سياسي آخر لاختيار أنقرة المواجهة معها، هو السعي الى إجهاض عملية التفاوض في فيينا وإفشالها، والتي كان في أولوياتها التعاون لمكافحة الإرهاب، بالتوازي مع السعي الى إنجاح العملية السياسية بين النظام والمعارضة في سورية.
وفيما ينظر كثر إلى الصراع المفتوح بين موسكو وأنقرة على أنه أجهض الهدف التركي بإقامة منطقة آمنة في شمال سورية، بالتوازي مع الحل السياسي الذي يجب أن يقود الى إبعاد بشار الأسد من السلطة، فإن الجانب الروسي يستهزئ بتكرار رجب طيب أردوغان الدعوة الى رحيل الرئيس السوري.
«لقد سئمنا الكلام عن إزاحة الأسد لأنه يعرقل العملية السياسية، ولا نريد التحدث بعد الآن في هذا الموضوع، حتى مع الأميركيين، الذين نتفق معهم على خطوات يمكن تحقيقها، بدءاً بالحوار بين الفرقاء السوريين وفقاً لبيان جنيف1 وتوجيه الأمور نحو إجراء انتخابات هي التي تحدد من يبقى أو لا يبقى في السلطة». وإن لم يحصل تقدم يدفع واشنطن الى وقف المطالبة برحيل الأسد، فإن موسكو تراهن على أن يقود تزايد التفهم الأوروبي، وآخره التفهم الفرنسي، لوجوب محاربة الإرهاب من السوريين، معارضين وموالين للنظام، في ظل وجود الأسد، الى تعديل في الموقف الأميركي.
وترمي موسكو الى أن تقابلها دول الغرب الموقف وفق المعادلة التالية: «إذا افترضنا أننا نريد بقاء الأسد في السلطة، فنحن لا نمارس ضغوطاً حتى يبقى، فيما الدول الغربية تريد رحيله وتضغط لأجل ذلك، ونحن نريدها أن تكف عن هذا الضغط وتترك الأمر للعملية السياسية السورية...».
لكن الأهداف الروسية المرحلية في سورية والتي تشمل مواجهة النفوذ التركي، تتناقض مع التعايش الروسي مع النفوذ الإيراني في سورية، بل إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد التطابق مع طهران أثناء زيارته إياها قبل أسبوعين.
لا تفسير لاستعداد موسكو لتصعيد المواجهة مع أنقرة سوى أنها تستخدم النفوذ الإيراني في مواجهة الطموح التركي إلى النفوذ، على رغم تأكيدها أن التعاون مع طهران لأجل الحل السياسي في سورية لا يعني «أننا في محور الممانعة»، وأنها لا تنسق مع قوات «الباسيج» والميليشيات المدعومة من طهران، وتترك الأمر للسلطات السورية أن تنسق معها، لأن هذا شأنها «السيادي».
 ١٠ ديسمبر ٢٠١٥
١٠ ديسمبر ٢٠١٥
وجهت المعارضة السورية اليوم الصفعة الأقوى لجميع أعداء الثورة ، على مدى السنوات الخمس ، وكانت الرسالة الموحدة من الجميع و التي انتهت بالتوقيع الجماعي ، مع بعض الإعتراضات البسيطة ، التي لاتغيير في الهيكل العام ، الا وهو "المعارضة السورية" معاً لأول مرة منذ خمس سنوات .
لا يمكن أن ننفي حجم التناقضات التي ضمها اجتماع الرياض ، فضم المعارضة المسلحة إلى جانب السياسية في نفس الهيكل ، والمعارضة التي تقسم بين الداخل و الخارج ، والأهم الأطياف كافة من إسلاميين بمختلف التدرجات إلى جانب العلمانيين ، و المختلفين مذهبياً و دينياً ، ليكون الطيف الأوسع الذي يخرج للمعارضة السورية .
في الحقيقة الرسالة الأهم صدرت من الدعم السعودي عبر لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وكذلك استباق المؤتمر بلقاء مع ولي العهد السعودي الذي حفّز الجميع على رفع السقف و ان يكونوا على قدر التضحيات ، الأمر الذي مهد للإتفاق و الخروج كتلة واحدة قد تكون غير متجانسة أو متوقعة ، لكنها خرجت و وانتهت مرحلة المخاض ، ومن بين الأمور ذات الأهمية هي اعتبار كل من يخالف بنود اتفاق الرياض بأنهم " ليسوا بمعارضة" ، فلا معارضة خارج المتفق عليه ، و بالتالي يجب على اجتمع في الحسكة او الأركوزات الذين التقوا في دمشق ، أن يعوا أن الأمر بات جدياَ .
أما الرسالة الأسعد للشعب السوري كانت برد الفعل الإيراني الهستيري ، الذي صدر فور اصدار البيان و إعلان موافقة الجميع ، عندما خرج مساعد وزير الخارجية الإيراني واصفاً المجتمعين بأنهم "إرهابيون" , متحديهم بأنه إيران "لن تسمح بأن يعتبرواأنفسهم معارضة معتدلة , و أن يقرروا مستقبل سوريا" ، في حين أن الرد السعودي كان أمضى و أقوى و من خلال دول التعاون الخليجي ، عندما أعاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلمته المزعجة :" الأسد أمام خيارين إما التنحي عن السلطة عبر مفاوضات مع أطراف المعارضة السورية، أو أنه يتم إسقاطه بالقوة".
لا يمكن ان نخفي أن التركيبة التي التقت و اتفقت في الرياض ، هي كتلة تجمع المتناقضات ، و لكن خطورة المرحلة و مصيرتها بالنسبة للشعب السوري ، اضطر كثر لتقديم التنازلات عن بعض المبادئ ، التي من الممكن أن تسبب بعض الشقاق في صفوف هذا الفصيل او التنظيم أو الحزب أو ذلك ، لكن لنكون واقعين و عقلانيين ، فالدم المسال و المباح بحتجة لتضحية ، لوقفه أو الحد من جريانه ، قد نختلف ثورياً بأن ما حدث في الرياض لايتوافق مع المسيرة التي خاضتها الثورية ، ولكن كعقلانيين هذه المرحلة بحاجة لرؤية أوسع و صدر أرحب لتجاوزها و العبور إلى الآمان .






