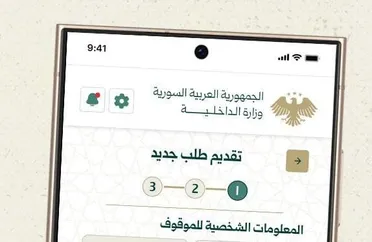البيوت عادت... لكن من يملأها؟".. قصص الأمهات السوريّات بين "الأطلال والذكريات"
تقف أم عبده أمام منزلها المدمَّر، تحدِّق في تفاصيله، ثم تتنقّل بين أرجائه وهي تسترجع صورته الجميلة كما كان قبل أن يصبح ضحيةً لقصف الطيران قبل سنوات، ثم فريسةً لجيش "التعفيش" الأسدي. تتمنى لو أنها مخطئة، وأن هذا ليس منزلها، لكن الموقع والتفاصيل المتقاطعة بين شكله القديم والحالي، يثبتان الحقيقة المرّة. تتحوْقَل، وتُلقي بنظراتها على منازل الجيران والأقارب المحيطة، التي لم تكن أوفر حظاً.
تقول أم عبده (55 عامًا) من ريف حماة: "دمار المنازل كسَر ظهورنا، لكن هذا يمكن تجاوزه مع الوقت، ويمكننا إعادة بنائها، ربما بشكل أفضل مما كانت عليه. لكن ماذا عن الأبناء والأحبة الذين خطفتهم الحرب منا؟ لقد فقدت ثلاثة من أولادي؛ أحدهم قُتل خلال اشتباكات اندلعت بين فصائل قبل أحد عشر عاماً، وآخر قضى في حادث سير في بدايات النزوح من القرية قبل خمس سنوات وسبعة أشهر، ولحق به شقيقه بعد واحد وعشرين يوماً فقط. ثم تُوفي زوجي بعدهم، وكأن قلبي لا يزال يُنتزع قطعةً قطعة".
وتتابع بصوت يغلبه الحزن: "قبل أن أعود، كان مجرّد التفكير بالرجوع إلى الحارة والمنزل من دونهم يضيق صدري، وتُظلم الدنيا في عيني. سأراهم في كل تفصيل، في كل لحظة تمرّ بي. في ساحة الحارة حيث اعتادوا أن يتجمعوا مع أصدقائهم، في الأرض عندما كنا نعمل معًا وتملأ ضحكاتهم المكان، على"على مائدة الطعام التي باتت تفتقد وجودهم، وأصبحت أماكنهم الفارغة تذكّرني دومًا بأن شيئًا كبيرًا ينقص هذا البيت."
ليست أم عبده وحدها من تعيش شعور الفقد واللوعة بسبب ما خلّفته الحرب من ظروف قاسية، فكل سوري أصابته خسارة ما، باختلاف أشكالها. عدد الضحايا يُقدَّر بالآلاف، سواء في السجون أو تحت القصف أو خلال محاولات الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن وقائع الاعتقال، والدمار، والسرقة، والتخريب، وعمليات "التعفيش".
لم يكن التخلّص من حكم آل الأسد أمراً سهلاً، خصوصًا أن هذا الحكم امتد لعقود طويلة وتحالف مع الروس والإيرانيين. ومع ذلك، سقط في 8 كانون الأول/ديسمبر من عام 2024. لكن جراح السوريين لم تندمل بعد، فذاكرتهم ما زالت مثقلة بالآلام والأحداث المروّعة التي يصعب نسيانها، وقد فُتحت تلك الجراح مجددًا مع العودة إلى الديار، حيث الغياب الواضح لأفراد العائلة يُعيد المأساة إلى الواجهة.
تخشى أم محمد العودة إلى منزلها في ريف إدلب الجنوبي، إذ تحاول قدر الإمكان الهروب من ذكرى وفاة ابنها الذي قُتل في قصف جوي قبل نحو سبع سنوات، حين بدأت الحملة العسكرية على مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وبدأ جيش النظام بالتقدّم.
تقول السيدة الخمسينية: "نزحنا من القرية في الأيام الأولى للحملة، بينما أصرّ أولادنا الشباب على البقاء لحماية المنازل من السرقة، ودعم المقاتلين على الجبهات. لم نتمكن من إجبارهم على المغادرة. مع تصاعد القصف، كان الشبان يختبئون في كهوف قمنا بحفرها تحت الأرض لتوفير الحد الأدنى من الأمان".
وتتابع أم محمد: "كان ابني في منزل أحد الجيران يسهر مع اثنين من أصدقائه عندما استهدفت الطائرات الحي بالغارات. سقط صاروخ على المنزل فقُتل ابني على الفور، وأُصيب أحد أصدقائه إصابة بالغة في العمود الفقري أفقدته القدرة على الحركة، أما الثالث فقد نجا بإصابات طفيفة لأنه كان في المطبخ يعدّ الشاي وقت الضربة".
تغيّرت حياة تلك المرأة بشكل كبير بعد فقدان ابنها، حتى أن أبناءها الآخرين باتوا يتجنّبون ذكر اسمه أمامها، كي لا تنفجر بالبكاء. بل أصبحوا يبتعدون عن كل ما يرتبط به: طعام كان يفضّله، ملابس كان يرتديها، ذكريات تجمعهم به، وحتى المناسبات التي كان يشاركهم فيها. فمجرد أن يخطر على بالها، تنخرط في نوبة بكاء حادة، وقد ترفض تناول الطعام لساعات طويلة. "كيف يمكن أن تنسى ما حدث، وهي تمرّ يومياً أمام المنزل الذي فقدته فيه؟"، تقول منار، ابنتها، التي كانت حاضرة معنا أثناء اللقاء مع والدتها.
ولدى مناقشة الآثار النفسية والاجتماعية لتلك الذكريات على الأمهات، تحدثنا مع براء الجمعة مختص في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وقال: "في السياق السوري، لا يمكن اختزال الذاكرة بمجرد اضطراب نفسي ناجم عن الصراع؛ بل إنها تمثل شاهداً حيّاً على انتهاك القيم الإنسانية، وجمراً تحت الرماد يُهدّد بالاشتعال كلما اصطدم خطاب النسيان القسري بجرحٍ لم يُعترف به.
بالنسبة للأمهات السوريات، تتداخل الذكريات مع غياب العدالة لتشكّل "ألماً مركّباً": ألم الفقد ذاته، وألم الغياب التام للاعتراف المجتمعي والدولي بضحاياهن. ومع استمرار غياب آليات المساءلة الفعلية، تتحوّل الذكريات إلى شكل من أشكال المقاومة الرمزية ضد الإقصاء، وتُعزز شعوراً بالاغتراب، خاصة في البيئات التي يُفرض فيها خطاب "المصالحة" قسراً دون محاسبة.
وأضاف: "التأثيرات اليومية لا تنفصل عن بنية المعاناة المستمرة، حيث تظل مظاهر الفقر والتهميش والعنف البنيوي متجذرة في تفاصيل الحياة، ففي العلاقات الأسرية: يظهر توتر دائم في ديناميكيات الأمومة، يتجسد في حساسية مفرطة تجاه الأبناء الناجين، كرد فعل على فقدان السيطرة خلال فترات الحرب، ما يضع الأمهات في صراع داخلي بين الحماية والخوف من التكرار.وفي الجسد: تتجلّى آثار الظلم في صيغ جسدية؛ آلام مزمنة، اضطرابات في النوم، وشكاوى صحية متكررة لا تجد تفسيراً طبياً واضحًا، ما يشير إلى وجود علاقة عميقة بين المعاناة النفسية والتجسيد الجسدي للصدمات".
وذكر الجمعة أن الدعم الفعّال للنسوة لا يُختزل في جلسات علاج فردية، بل يتطلّب مقاربة شاملة تعترف بالذاكرة كحق إنساني، وبالمعاناة كقضية نظامية لا كخلل في الدماغ أو العاطفة.على مستوى السياسات: يجب تعزيز المبادرات المجتمعية التي تُمكِّن النساء من إعادة تشكيل سردياتهن بأنفسهن. التوثيق المحلي، والأرشيفات المجتمعية، ومشاريع التمكين التي تدمج بين سبل العيش ومساحات الحكي، تساهم في ترميم الكرامة قبل استهداف "الصحة النفسية".
وتابع: "على مستوى الممارسة النفسية الاجتماعية: من الضروري تبنّي أدوات تُعيد تعريف الهوية بعيدًا عن دور "الضحية"، مثل تقنيات السرد الجماعي والتدخلات القائمة على استعادة المعنى. كما يُعدّ الدمج بين الدعم النفسي والتحرك المجتمعي وسيلة فعّالة لتحويل الألم الفردي إلى طاقة جماعية للضغط والتغيير.
وعلى مستوى الخطاب الإعلامي والأكاديمي: ينبغي استبدال مفردات مثل "الضحايا" بـ"الناجيات" أو بدائل أخرى ملائمة، مع الالتفات إلى توثيق قصص الصمود اليومي، بما يعكس القوة والتكيّف، لا الألم فقط.