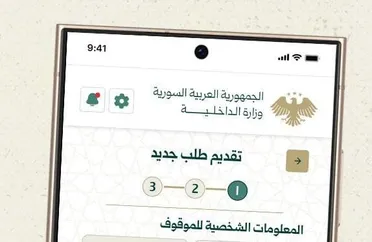ذاكرة الغياب: حين يُعتقل الأبناء وتبقى الأمهات في العتمة
في سوريا، غرقت أمهات في وجع مستمر رافقه انتظار امتدَ لسنوات عدة، وجوههن تحمل تجاعيد الصبر لا الزمن، وعيونهن تلمع كلما سُمع صوت باب يُفتح أو هاتف يرن، لعلّه يحمل خبراً عن فلذات أكبادهن المعتقلين أو المفقودين. تلك النساء لسن مجرد أمهات، بل شهيدات أحياء للوجع السوري. في صمت كل واحدة منهن قصة، وفي صبرهن مقاومة، وفي عيونهن سؤال لا إجابة له: أين أبناؤنا؟
"أريد ابني"
من بينهن، تقف أم محمود، الحاجة السبعينية من ريف إدلب، شاهدةً على ألم ممتد أحد عشر عاماً، بعد أن اعتُقل ابنها "محمود" في دمشق عام 2013. قبل اعتقاله، دار بينهما حديث بسيط، مثل آلاف الأحاديث التي تحصل بين أم وابنها، عتب خفيف، قلق عادي، لكنها الآن تتذكر كل كلمة، وتتمنى لو أن الزمن عاد. قال لها محمود: "شغلة يومين وبرجع". لكن تلك "اليومين" تمددت إلى أحد عشر عاماً من الترقب، والخوف، والانتظار، واللا يقين.
سعت العائلة في كل اتجاه، دفعت أموالاً، وناشدت وسطاء، وسمعت عشرات الروايات المرعبة: "مريض"، "في فرع لا يدخله الجن الأزرق"، "انتقل إلى سجن سري". ولم يكن هناك أي جواب مؤكد، فقط غياب طويل، وقلق لا يهدأ. أم محمود صارت أماً لأحفاده الثلاثة، صارت حائط الأمان لهم، وصار قلبها موزعاً بين رعايتهم وخوفها عليهم من أن يصيبهم ما أصاب والدهم. كانت تعدهم أن والدهم سيعود، وتعد نفسها. "يمكن بكرا..."، هذا ما كانت تهمس به كل ليلة، قبل أن تطفئ النور وتترك الباب موارباً، فقط قليلاً، ربما…
كسرت القضبان ولم يعد
وفي عام 2024، حين بدأت تُفتح بعض السجون، بعد هبوط المجرم الأسد إلى الهاوية، عادت شرارة الأمل، وتجمّع الناس حول بوابات صيدنايا، وراقبوا الصفحات والمجموعات. حتى جاء ذلك اليوم... يوم صرخت ابنة شقيقه، فصمتت الجدة، لأنها علمت. كان اسم محمود بين قوائم الموتى. بلا جسد، بلا قبر، بلا وداع. هذا المشهد الذي عاشته أم محمود، هو مشهد متكرر في البيوت السورية، من إدلب إلى الزبداني، ومن درعا إلى دير الزور.
مشهد مكرر في كل أرجاء سوريا
في الزبداني، ما زالت أم وسيم تفتح النافذة كل مساء. لا تضع ضوءاً، ولا تترك علامة، لكنها تجلس هناك طويلاً، تتخيله عائداً دون موعد، يمشي وحده في الطريق الصامت، ويصل إلى الباب كما كان يفعل. أكثر من عشر سنوات مرّت، وما زالت تنتظر. وفي حماة، كانت أم نزار تتلقى أخباراً متضاربة عن ابنها، تصدق التي تشير إلى أنه حي، وتكذب ما يتنافى مع ما تتمناه، وذهبت سنة وتبعتها أخرى، وهي تذبل لتسقط كأوراق الشجر في فصل الخريف، عند فتح السجون وعدم العثور إليه، لتعلم أنه فارق عالمها دون أن تراه أو تودعه فلا يكون لحظة أخيرة بينهما.
وفي درعا، تعيش أم عمار على أملٍ لا يخفت. لم ترَ ابنها منذ سنين، ولا تعرف إن كان في الحياة أم تحت التراب. وكل ما سنحت لها الفرصة كانت توزّع طعاماً على الجيران والغرباء، وتقول: 'إذا كان عايش، يمكن دعوة توصل، وإذا مات، فهي صدقة على روحه
الانتظار كسلاح
النظام السوري لم يكتفِ بالسجن والتعذيب. بل جعل من الانتظار ذاته أداة تعذيب نفسي للأمهات والعائلات. سنوات من الغموض، من الشائعات، من صفقات الابتزاز والاحتيال، من الأكاذيب الرسمية. يُستخدم الإخفاء القسري كورقة ضغط وسلاح ضد أهالي المعتقلين، حتى تتحوّل الأم إلى كائن معلق، لا تعرف إن كانت تبكي أم تأمل. لكن رغم كل هذا، بقيت الأمهات شامخات. يبنين البيوت على أمل عودة الغائبين، ويربين أحفاداً على أسماء آبائهم الذين لم يعودوا. في كل بيت صورة معلّقة، ورسالة لم تُكمل.
أم محمود ليست وحدها... لكنها أيضاً وحدها
قصة أم محمود ليست قصة خاصة. هي واحدة من آلاف، لكنها تكثّف الوجع السوري كله. وجهها المتجعد، صمتها الطويل، وصورتها وهي تضم صورة ابنها وتهمس: "سامحني يا ابني"، تختصر كل ما لا تستطيع السياسة قوله، وكل ما تتجاهله العدالة، وكل ما لم يُكتب بعد. في كل صلاة، تهمس الأمهات بأسماء أبنائهن، ثم ترفع أيديهن بالدعاء على من كان السبب. يسمين بشار الأسد باسمه، ويصفنه بـ'المجرم' دون تردد. تقول إحداهن: 'ما في سجدة إلا وبدعي عليه، هو وكل مين شارك بخطف ولادنا'. وسط الحزن الطويل، لا ينسين أن العدالة حق، وأن من ارتكب الجرائم سيُحاسب، ولو بعد حين، ولو ظنّ أن الوقت نسي.