 ٤ يوليو ٢٠١٦
٤ يوليو ٢٠١٦
باتت المسألة السورية في مواجهة تطورين كبيرين، سيكون لتداعيات كل منهما شأن كبير، إن على مآلات الوضع السوري والثورة السورية، أو على مكانة الفاعلين الدوليين والإقليميين، في إطار الصراع على سوريا.
التطور الأول، ويتمثل بهذا التمايز، الذي بات علنيا وواضحا، في مواقف كل من روسيا وإيران بخصوص ما يجري في سوريا، وفي الموقف من نظام الرئيس بشار الأسد، ومن مسألة الهدن، والعملية التفاوضية؛ ففيما تبدو إيران مصرة على استمرار الأسد في السلطة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار نفوذها، ليس في سوريا فحسب وإنما في العراق وإيران أيضا، ثمة تسريبات جديدة تفيد بأن روسيا ليست متمسكة للنهاية بالرئيس، وأنها تفعل ذلك الآن فقط لمصلحة بقاء الدولة السورية، وتلافيا لانهيارها. ومعلوم أن روسيا تعوّل في دورها على العملية التفاوضية، في حين أن إيران تعول فقط على مشاركة ميليشياتها في الصراع إلى جانب النظام، ما يعني أنه بات ثمة فارق جوهري في مضمون مواقف هذين الطرفين؛ الروسي والإيراني، كما في اصطفافهما على الأرض، وفي هدف كل منهما لأغراض التدخل العسكري.
وقد شهدنا في الآونة الأخيرة مجموعة من الإشارات الروسية التي تفيد بالتوضيح للعالم، وضمنه للإيرانيين، بأن سوريا هذه ورقة في يد روسيا، لا في يد إيران، وأن هذه أصغر من أن تنافس روسيا في سوريا. ولعل هذا ما بدا واضحا من “فيلم حميميم”، في القاعدة البحرية الروسية على الساحل السوري، الذي ظهر فيه الرئيس الأسد وكأنه في حالة استدعاء إلى قاعدة روسية في سوريا لمقابلة وزير دفاع بلد آخر. هذا أيضا ما يمكن استنتاجه من رفع الغطاء الجوي الروسي عن الميليشيات التي تشتغل كأذرع لإيران في سوريا مثل حزب الله في مناطق حلب، وفي نفي السفير الروسي للكلام الذي صدر عن زعيم هذا الحزب حسن نصرالله بخصوص أن ثمة معركة مصيرية آتية في حلب.
التطور الثاني الذي يمكن ملاحظته أيضا، وستكون له تبعاته في المشهد السوري، يتمثل في إعادة التموضع التركي المفاجئ؛ إن لجهة عودة العلاقات الطبيعية بين تركيا وروسيا، أو لجهة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، وذلك بغض النظر عن العوامل الذاتية أو الموضوعية، التي ضغطت من أجل ذلك، وأفضت إلى هذا التحول الدراماتيكي في السياسة التركية.
في هذا التطور تحاول تركيا الخروج من الضائقة التي باتت تجد نفسها فيها بسبب انعكاسات الصراع السوري عليها، وتحوله إلى عامل لزعزعة الاستقرار فيها، إن كان من مدخل العمليات الإرهابية التي نشطت في الفترة الماضية، أو من مدخل إشعال فتيل الصراع مع الأكراد، إما في داخل تركيا ذاتها، وإما في سوريا، بحكم تصدر قوات حماية قوات الشعب (الكردية) لقوات سوريا الديمقراطية، والتي بات لها دور فاعل على الأرض في إطار الجهد العسكري ضد داعش.
هكذا يقف السوريون اليوم لمراقبة تداعيات هذين التطورين المهمين، على مجريات الصراع في سوريا وعليها، بحيث يمكن القول معهما إن سوريا ستشهد، على الأرجح، معادلات سياسية جديدة، قد تمهد لتسويات قريبة تخفّف من حدة الصراع السوري، وصولا إلى إيجاد مخارج أو توافقات مناسبة، تمهد لتحقيق النقلة السياسية اللازمة لاستعادة الاستقرار في هذا البلد.
ومعنى ذلك أن هذا الاصطفاف الجديد في علاقات القوى المتصارعة على سوريا، سيعني إضعاف دور إيران، وتاليا إضعاف أهم قوة ساندت نظام الأسد، وأسهمت في وصول الأوضاع في سوريا، وفي المشرق العربي عموما، إلى ما وصلت إليه، من حال التصدع الدولي والمجتمعي. ومن شأن هذا الاستبعاد ربما أنه يوحد الجهود في اتجاه إخراج كل الميليشيات العسكرية من البلد، ووضع حدّ للصراع المسلح، أو التخفيف منه، بانتظار أن تفرض التسوية السياسية ذاتها.
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
يخطئ الانسان أحياناً ، و يصب خطئه في قالبه "الشخصي" ، وضمن محدودية الآثار على الجمع المحيط به، و لكن عندما تضع نفسك في مقام عالي و تنصب شخصك أو مجموعة على أنك حامي الحمى ذو مهمة دينية عالية، فالخطأ هنا أكبر و أشد إيلاماً سواء لمسؤولياتك التي قررت حملها أو للهدف الذي ارتضيت حمايته و الوصول إليه، دون أن يكون هناك ورقة تكليف رسمية أو شعبية ذات إرادة حرة.
تقع جبهة النصرة في كل مرة في مطب من مطبات العمل المدني و التداخل في شوائك الحياة العسكرية، وقلب المعادلة في الآرض بسيف القوة ، ويبدو أن هناك من يدأب على زرع الرفض الشعبي لها مستقبلاً، و إن كان هناك قبول حالي فهو وقتي تبعاً لمعطيات الظرف ، المتمثل بحجم الألم المتولد عن النظام و حلفائه، ففي الأرض مدنيون لا يملكون ميزة أو رفاهية إختيار السلاح المدافع عنهم، و مع غياب الخطر على الروح فإن الآية ستتغير بشكل كبير، بخلاف كل ما يخطط أو يُعمل عليه، و لا يوجد استبداد يستطيع السيطرة على الأرض بالسيف و النار ، فدوامهما مستحيل.
فبعد التجارب الـ١٣ للفصائل التي تم انهائها من قبل جبهة النصرة و ارتفاع العدد إلى ١٤ بعد انضمام جيش التحرير إلى القائمة، يبدو أن خط التمدد من قبل النصرة هو قطار سيمر على الفصائل، سواء التي تعتبر جزء خفي من النصرة أو بعيد كل البعد عنها، و الغريب هو الاستهتار النابع عن خوف أو أنانية من قبل الموضوعين على القائمة، اتجاه ما تقوم به النصرة اتجاه فصائل الجيش الحر.
الصامتين على تصرفات النصرة يمثلون قطيع من الغنم يقفون أمام جزار يتلاعب بهم، بانتظار لحظة مواتية لإنهائهم، هذه اللحظة التي تأتي بعد كل انتصار أو بطولة للنصرة لتفرّغ الساحة من فصيل من أبناء الشعب، لا هدف له بأن يتحول الشعب المكلوم لمحارب عن مجتمع بأكمله، لم يتحرك ساكناً أمام أنهر دمائه التي مُلئة الأرض.
قد ينتفض كثر ضد ما نقول أو نتحدث عنه، و لكن يبقى تبيان الواقع أفضل من الصمت بحجة الخوف من ردة الفعل التي قد تودي بحياتك أو حياة من هم على قرب منك، فالقضية ليست قضية فلان من الناس مع مجموعة من الأشخاص ، لكنها هي قضية سوريا المستقبل ، الذي يتحدد الآن من خلال الخيارات التي تضيق على الأرض بعد الابتلاعات المتتالية و غير مضبوطة.
لا يمكن انكار دور النصرة الحالي في احداث الرد الجزئي على كم الاعتداءات اللامتناهي من أعداءه، و لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن ننسب هذا الفضل في مجمله لفصيل بعينه، فهو ضمن عمل جماعي يلعب كل جزء منه دور بارزاً و مهماً في أي نتيجة إيجابية، من حلب للساحل و عودة إلى بداية الرد في وادي الضيف وصولاً إلى تحرير ادلب.
التفرد و انكار الجميع قد تكون حالة تمنح النصرة حالياً ميزة للتفوق على الأرض، و لكن ليست ذات استمرارية فحكم الشعب لا يكون بالإلغاء و الانهاء لكل مخالف، و إنما باستيعابه و الذوبان فيه و قبوله كما هو .
و آلاف الأسئلة تضرب في الرأس بحثاً عن مبرر يمكن أن يستخدم لتخفيف الحنق ضد تصرفات "النصرة"، و أبرزها ماذا لو النصرة حلت المشاكل مع حزم و الفرقة ١٣ و جيش التحرير من خلال لجنة حل مقبولة من الجميع، و ماذا لو لم تعتبر كل أخطاء النصرة من اعتقالات و كم الأفواه تحت بند "الأخطاء الفردية" المعفو عنها، ويبقى السؤال الأهم كيف نواجه "بغي" جبهة النصرة !؟
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
بعد فسحة من الأمل، تراجع فيها منطق العنف والحرب وتقدمت لغة التفاوض السياسي، عاد المشهد السوري إلى سابق عهده مثقلاً بالفتك والدمار، وعاد السلاح ليكون صاحب الكلمة الفصل، منعشاً الأوهام بجدوى الخيار العسكري ومستهتراً بالنتائج المأسوية التي يخلفها على حياة البشر وأمنهم وشروط عيشهم وعلى وحدة الوطن والدولة والنسيج الاجتماعي، وما يزيد الطين بلة، أن كل طرف يحمل الآخر مسؤولية هذا الخيار، إما كرد على انسحاب المعارضة من اجتماعات جنيف ولإجبارها على العودة الى طاولة المفاوضات، وإما لإضعاف نظام يرفض المعالجة السياسية ولإجباره أيضاً على قبول خطة الطريق الأممية والمرحلة الانتقالية العتيدة.
وبينما لا تزال جماعات المعارضة المسلحة منشغلة بترميم قواها وتحصين مواقعها بعد الضربات الجوية الروسية، فإن النتائج التي حققتها هذه الأخيرة مكنت النظام وحلفاءه من التقاط زمام المبادرة والبدء بمرحلة من التصعيد العسكري مستندين إلى ثلاث نقاط داعمة.
أولاً، استثمار الانفلات الناجم عن انهيار هدنة وقف العنف والأعمال العدائية لاستعادة السيطرة على بعض المواقع المفصلية ومحاصرة المعارضة المسلحة في مناطق محدودة ومعزولة، ربطاً بالتركيز على استعادة مدينتي حلب والرقة والتعويل على ذلك في قلب التوازنات القائمة ووضع الصراع السوري في مسار جديد يمكن النظام وحلفاءه من رفع سقف الاشتراطات وفرض إملاءاتهم.
ثانياً، تمرير التصعيد العسكري بالتناغم والتزامن، مرة، مع استعار معارك التحالف الدولي وقوات سورية الديموقراطية ضد تنظيم داعش ونجاح الأولى في التقدم والسيطرة على عدد من القرى والبلدات وآخرها مدينة منبج، ومرة ثانية مع الهجوم الواسع الذي تقوده قوات التحالف ذاتها مع الجيش العراقي للسيطرة على مدينة الفلوجة والاستعداد لاجتياح مدينة الموصل، وما يعطي هذا التناغم قيمة مضافة، انكشاف حالة من توزيع المهمات بين واشنطن وموسكو في إدارة الضربات الجوية للنيل من الجماعات الجهادية على أنواعها.
ثالثاً، الإفادة من تشتت المعارضة السياسية ومن الصراعات التنافسية الدموية التي تتواتر بين أهم جماعاتها المسلحة في غير منطقة من سورية، ربطاً باستمرار إحجام الأطراف الخارجية عن تزويدها بسلاح نوعي، هذا إن بقي خبر حصول جبهة النصرة على مضادات للطيران في إطار التخمينات!
لكن أن تكون الظروف مواتية لتحقيق بعض التقدم العسكري شيء، وأن يسمح تباين المصالح الدولية والإقليمية بتغيير التوازنات القائمة شيء آخر! والقصد أن الأفق سيبقى مغلقاً أمام أي تصعيد عسكري، وأن ثمة خصوصية لمعركتي حلب والرقة، ترتبط بصراع محموم على النفوذ المشرقي، يرجح أن تلعب أطرافه المتضررة دوراً كبيراً في إجهاض أية نتائج عسكرية حاسمة، حتى لو أدى الأمر إلى رفع منسوب الصراع ميدانياً وربما إعلان حرب مفتوحة! فليس من منطق ومصلحة يدفعان القوى الدولية والإقليمية المناهضة للنظام وحلفائه، كي تغض الطرف عما يجري وتقف على الحياد، وهي المدركة الأهمية الإستراتيجية لمدينتي حلب والرقة، إن في تمكين أعدائها وإن في إضعاف تأثيرها بالمستقبل السوري وبصراع الهيمنة على المنطقة.
ربما لا تسمح الموازين الداخلية والخيارات الدولية والإقليمية في اللحظة الراهنة بفرض حل سياسي عادل يحقق طموح الشعب السوري، وربما لا تسمح ببعث مسار التفاوض السياسي ومنحه ما يتطلبه من الجدية والزخم، لكن هذه الموازين نفسها لن تسمح أيضاً لأحد الطرفين، بتحقيق الغلبة والانتصار خاصة في مدينة مثل حلب، ومن هذه القناة يمكن النظر إلى تحذيرات الوزير كيري بأن صبر واشنطن بدأ بالنفاد، وتالياً إلى مسارعة موسكو تجميد القصف والأعمال القتالية وإعلان هدنة قصيرة في المدينة من طرف واحد.
يصعب على المرء فهم الطريقة التي تنظر فيها أطراف الصراع إلى ما يجري، وكيف تخلص إلى تغليب الخيار الحربي على كل شيء، وتعجب بعد أعوام عديدة من تجريب مختلف أصناف الأسلحة وأكثرها فتكاً ومن استجرار كل أشكال التدخل الخارجي وما تحمله من مصالح وأهداف خاصة، تعجب من استمرار الأوهام بإمكانية الحسم ونجاعة منطق كسر العظم، وتالياً من نكران حقيقة مرة تقول بلا جدوى هذا الخيار، وأنه يسير بالبلاد، في ضوء التشابكات الدولية والإقليمية العنيدة والمعقدة للوحة الصراع السوري، نحو الأسوأ سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، ونحو المزيد من الضحايا والخراب والمشردين واستنزاف ما تبقى من قوة المجتمع وثرواته.
فإلى متى يبقى الشعب السوري أسير الخيار الحربي في رهان السلطة أو المعارضة على الانتصار؟ أوليس أمراً مؤسفاً ومقلقاً في آن، الوقوف أمام قادة للمعارضة لا ينفكون عن تكرار أوهامهم عن حسم عسكري سريع في حال مدوا بأسلحة نوعية أو تم تحييد الطيران، وأمام نظام لم تفارقه الأوهام ذاتها، واعتاد مع كل محطة يحقق فيها الخيار العسكري بعض التقدم، أن ينعش هذه الأوهام ويكرر لازمته، بأن الأزمة توشك على الانتهاء وبأن ما تواجهه البلاد سيغدو في وقت قريب من الماضي؟!
لن تعود سورية إلى ما كانت عليه قبل آذار (مارس) 2011... هي عبارة يتداولها الكثيرون كحقيقة لا تقبل التأويل. ولكن بين تشاؤم العقل وتفاؤل القلب، ثمة بارقة أمل، تتعدى الرهان على محصلة صفرية للصراع تكره أطرافه الداخلية على التنازل والانصياع للحلول السياسية، أو على تقدم توافق وإرادة أمميين يضعان حداً لما يجري، إلى الرهان على خصوصية الشعب السوري وعلى شدة ما يعانيه في لعب دور فاعل يحاصر منطق العنف والغلبة والإكراه، يحدوه رهان على جدوى المثابرة في نشر ثقافة تنبذ التمييز والاستفزاز وإثارة الحقد والبغضاء، وترفض أي خطاب إيديولوجي مسطح يحتقر السياسة وحقوق الإنسان ويستسهل قتل البشر وسفك الدماء لأغراض سياسية أو دينية، ثقافة لا يمكن من دونها أن يكون السوريون أوفياء للتضحيات العظيمة التي بذلت ولشعارات الحرية والعدل والكرامة.
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
قد يمكنك تفسير سبب عنصرية الشعب اللبناني (أو الشعوب اللبنانية؟) تجاه العمال الأجانب الآتين من سريلانكا أو الهند أو بنغلادش، من دون أن تبرر هذا الحال طبعاً، كما هو شأن تفسيرك عنصريتهم تجاه الأفارقة، وحتى تجاه العربي الخليجي أو المصري أو المغربي. ولكن، كيف نفسر العنصرية اللبنانية ضد السوري والفلسطيني؟ على ماذا تستند، أو من أين تنبع؟ على ماذا تستند لترى نفسك مختلفاً عمّن تشترك معه في اللغة، لا بل اللهجة أحياناً، والتاريخ والجغرافيا والثقافة والعرق والنسب... والتخلُّف عن ركب الحضارة؟ نزوح مليون ونصف مليون إنسان إلى بلد صغير، متعثر أصلا، سيفاقم مشكلاته ويعرّضه للأزمات والمخاطر. ولكن، هذه مسؤولية الدولة، ومن واجباتها ومهماتها إيجاد الحلول والتسويات مع الخارج، عبر المؤسسات والقوانين الدولية، ومع الداخل عبر مؤسسات المجتمع المدني، لتنظيم ما يمكن تنظيمه وتحسين ما يمكن تحسينه. وبعدها، لا بأس بالاتكال على أصحاب الهمم من المواطنين للمساهمة بما أمكن. أمّا المواطن الغاضب والقلق على الأمن والمستقبل، وإذا ما شعر أن ضرر النزوح أقوى من قدرته على الاحتمال، فما عليه سوى الضغط على أصحاب الشأن لتخفيف الضائقة؛ وليس التنكيل بالنازح المغلوب على أمره، والذي يحلم، أصلاً، بالخروج من لبنان على أقرب قارب، يصارع أمواج الموت الأبيض المتوسط.
ثم، أليس اللبناني شريكاً لشقيقه السوري في هذا البؤس المزمن والمستشري؟ كم من العائلات والأفراد اللبنانيين سعوا، ويسعون، إلى سلوك الدرب نفسه، درب الموت الشمالي المفضي إلى الوهم الأوروبي؟ أو، كم لبنانيا زوَّر أوراقه الرسمية، وادعى أنه سوري، ليحصل على حق اللجوء في ألمانيا أو سويسرا أو إيطاليا؟ وكم لبنانيا نجح بالادِّعاء، لأنه يتكلم اللهجة السورية نفسها، ويحمل السحنة نفسها، ويتكبل بالأنواع نفسها من اليأس والإحباط، ومن العقد التي راكمها في نفسه شبيحة الأنظمة والمليشيات وحماة الطوائف.
من الطبيعي أن يتخفّى بين النازحين السوريين شذاذ ومجرمون وإرهابيون ومعتوهون. ولكن، من قال إن نسبة هؤلاء أعلى من نسبة نظرائهم في منازل اللبنانيين؟ لنعد إلى أرشيف التفجيرات والعمليات الإرهابية، ونرى كيف أن الأسماء السورية كانت أقلية، مقارنة باللبنانيين، خصوصاً إذا ما فصلنا الذين خرجوا من بين النازحين عن الذين جاؤوا مجهزين من خلف الحدود. ثم، خارج هذه المعادلة، وفي كل الأحوال، يبقى الأمن مسؤولية الأجهزة الأمنية، حصراً، ولا يجوز أن تحمّل المسؤولية للنازح المغلوب على أمره، ولا لزوجته التي، غالباً، ما تكون مشغولة بأطفالها، فمعظم اللاجئين السوريين هربوا من الأرياف، وهؤلاء أطفالهم كثيرون، على غير أفراد الطبقة الميسورة التي انخرطت في النسيج المدني اللبناني، ولا تطاولها التصرفات العنصرية، لأنها، أصلاً، غير محسوبة على النازحين.
بشأن سوق العمل، ومعزوفة مزاحمة اللبناني و"خطف اللقمة من فمه"، توضح الأرقام أن معظم اليد العاملة السورية، الموجودة حالياً، كان موجوداً في العقود الأربع الماضية. مع فارق أنها، أيام وصاية النظام السوري على لبنان، كانت تحظى باحترامٍ وتقديرٍ أكبر؛ وكانت مرتباتها ومداخيلها أعلى. ومن دون قيود من الأمن العام ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية. ولم تكن قد اختُرِعت بعد شخصية "الكفيل" الذي يشارك، في أحيان كثيرة، العامل المياوم عرقه، ويتحكّم به بعنصرية مقرفة! والأهم أنه، في ما مضى، كان السوري يرسل مدخوله الى عائلته في سورية، أما الآن فهو يصرفه في لبنان. أي أنه يشارك، إيجابياً، في الدورة الاقتصادية التي تحسنت، بشكل ملحوظ، بعد دخول مليون ونصف مستهلك إلى السوق اللبناني.
النزوح السوري مشكلة، لكن النازح هو الأكثر معاناةً، هو الضحية وليس المجرم. هو النتيجة وليس السبب. فيا أيها اللبناني الغاضب؛ وجِّه غضبك باتجاه مسببي المشكلة أو، على الأقل، باتجاه من يستطيعون شيئاً لحلها، فالنازح لا حول ولا قوة، وإذا كنت ترى وضعك أفضل، فساعده بالضغط على أصحاب القرار لحل مشكلته، أو اتكل على الله... واصمت. فقد تصحو في صبحٍ قريب، وترى نفسك تشاركه النزوح داخل لبنان أو خارجه. لا فرق. وستكون في انتظارك جحافل من عنصريين سيشعرون بالتفوق عليك، لمجرد أن ظروفاً قاهرة أخرجتك من بيتك.
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في زيارته النرويج أخيراً إن لصبر بلاده على روسيا، فيما يخص الملف السوري، حدوداً "مع محاسبة الأسد أو بدونها". وأضاف أن الولايات المتحدة "مستعدة أيضا لمحاسبة (المجموعات المسلحة) من عناصر المعارضة"، الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات أو الذين "يواصلون المعارك في انتهاك لوقف اطلاق النار".
بقي أن نعرف متى سينفد صبر الولايات المتحدة، وأين تقف حدود صبرها. أي متى سينفد صبر الولايات المتحدة من نظام الأسد وجرائمه المستمرة، بعد أن وسّٓعت صدرها، وألغت جميع خطوطها الحمر، يوم قصف الأسد الغوطة بالكيماوي، وقتٓلٓ الآلاف، قبل أكثر من عامين، وبعد أن انخفضت فجأةً حساسيتها تجاه جرائم التعذيب حتى الموت والقتل الجماعي في السجون. ووسَّعت أميركا صدرها، وصبرت على نشر حوالي خمسين ألف صورة لأكثر من عشرين ألف شاب وشابة سوريين، جرى قتلهم تعذيبا في سجون النظام
هل هناك عدد محدد من السوريين يجب أن يموتوا قبل أن ينفد صبر السيد كيري وإدارته؟ هل عدد النصف مليون لا يزال رقماً ضمن الحدود، ويمكن التسامح معه؟ ليحدّد لنا كيري عدد السوريين الذين يجب أن يقتلهم الأسد وحلفاؤه، لكي ينفد صبره وصبر إدارته. ما هي النسبة المئوية للمنازل والمدن والقرى السورية التي يُسمح للطائرات الروسية وقوات إيران ومليشياتها تدميرها قبل أن ينفد صبر الوزير كيري؟ نطالبه، وإدارته، بتحديد هذه النسبة: هل ينتظر أن يتم تدمير ما تبقى من حلب وإدلب وحمص وريف دمشق وريف اللاذقية والقلمون، وتشريد من تبقوا من سكانها حتى ينفد صبره؟ يبدو أن مخزون الصبر الأميركي تجاه موت السوريين أكبر من مخزون النفط العالمي.
ألا يكفي تهجير نصف سكان سورية من مدنهم وقراهم إلى مخيمات البؤس، أم لدى جون كيري وإدارته ما يكفي من الصبر، لترحيل النصف المتبقي؟ وكم هو عدد الأطفال المشرّدين والمحرومين من التعليم والحياة اللائقة في مخيمات البؤس الذي سيدفع كيري وإدارته للإعلان أن صبرهم نفد، وأصبح من الواجب دفع المؤسسات الدولية لعمل شيء من أجل تأمين عودةٍ آمنة لهم إلى مدارسهم ومنازلهم التي هجَّرهم نظام الأسد منها؟
فعلاً شر البلية ما يُضحك ويُبكي معاً. بعد أكثر من خمس سنوات من الموت والدمار والقتل والتهجير والتشرد، ولا يزال لدى وزير الخارجية الأميركي، وإدارته، مزيد من الصبر. حوّل نظام الطاغية سورية إلى مرتع لمليشيات إيران الطائفية، لتزرع حقدها، وتؤمِّن البيئة المناسبة لفتنةٍ طائفيةٍ مهّدت لظهور داعش والتنظيمات التكفيرية بأبشع صورها، ولا يزال لدى كيري وإدارته مزيد من الصبر. وُلِد عشرات الأطفال في مخيمات اللجوء، ووصل مئات الآلاف منهم إلى سن التعليم، من دون وجود مدرسة تؤويهم، أو بيئة صالحة تجنبهم الانزلاق نحو التطرف، ولا يزال كيري وإدارته بعيدين عن الحدّ الذي يستوجب نفاد الصبر.
معالي الوزير: مع الأسف، لا أعتقد أن سورياً واحداً لا يزال يثق بحسّكم الإنساني، ولا بحديثكم عن حقوق الإنسان وضرورة احترامها ومحاسبة منتهكيها. الغالبية الساحقة من السوريين، ومن جميع الاتجاهات السياسية، ترى أن مسؤوليتكم عن استمرار شلال الدم السوري لا تقلّ أبداً عن مسؤولية الروس الذين تُنذِرونهم بقرب نفاد صبركم. صمتكم و(صبركم) تجاه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري من قتل وتعذيب وتهجير على يد طاغيته، والمليشيات الطائفية التي تدعمه، وترككم "داعش" تكبر وتتمدّد وتقتل وتنكل بالسوريين منذ أكثر من عامين، بحد ذاته، جريمة أخرى بحق سورية وشعبها.
معالي الوزير: إذا ما شعرتم وإدارتكم أن صبركم نفد فعلاً، وكان مفترضاً أن يَنـفد منذ سنوات، فأنتم أكثر من يستطيع وقف شلال دمائنا (إذا لم يكن لكم مصلحة في استمراره؟).
تستطيعون أنتم وحلفاؤكم، لو شئتم، أن تفرضوا على الروس أن يتوقفوا عن دعم الطاغية وإيران ومليشياتها في حربهم ضد شعبنا، الأمر الذي سيساعدنا، نحن السوريين، لكي نتوحد ضد وحش التكفير والإرهاب. وتسطيعون أنتم وحلفاؤكم تشكيل قوةٍ عربيةٍ دوليةٍ، وبموافقة الروس، قادرة على دعم جهود السوريين في الحفاظ على وحدة وطنهم، وعيشهم المشترك الممتد آلاف السنين (إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصالحكم واستراتيجيتكم في المنطقة!)، وفي حربهم المزدوجة ضد الظلم والظلام، لعّلكم تُكَفِّرون عن صمتكم، وعن سعة صدركم اللامحدودة تجاه موتنا وآلامنا وتدمير وطننا.
معالي الوزير: لن يكون سهلاً على السوريين المنهكين أن يحاربوا هذين الوحشين معاً وحدهم (ظلم الطاغية وظلام التكفيريين) من دون قرارٍ أمميٍّ، لم تبذلوا أي جهدٍ كي يصدر عن مجلس الأمن. آمل وأرجو ألّا تكون لكم أي مصلحة في استمرار مأساتنا ونزيف دمائنا، وكلي أمل أن ينفد صبركم بأسرع وقت ممكن، وقبل أن تظهر داعش أخرى أشدّ دموية، وأكثر خطورةً، علينا وعليكم وعلى الإنسانية.
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
لا أعتقد أنه بقي غير عدد جد قليل من السوريين من لم يتصل بأجانب، أو من لم يتصل به أجانب. صار السوريون، في معظهم، كائنات دولية تتخطى اهتماماتها ومواقفها هموم بلدها الصغيرة إلى معضلات العالم الكبرى التي تعتقد أنها لن تحلّ من دون جهودها، وأن لقاءاتها مع المسؤولين الأجانب تتم بقصد توجيههم ومساعدتهم على اتخاذ قراراتٍ استراتيجية صائبة. أو للإشراف على تنفيذها، يستوى في ذلك إن كان السوري صاحب خبرة حزبية، أو من الذين "هوبروا" حتى بعد الثورة لمخابرات "أسدهم الأبدي"، أو انهمك، بعد الثورة، في اختلاق تاريخ شخصي، ثوري ومجيد، ينظف به ماضيه و"يبردخه" بمفعول رجعي، مستفيداً من الكلامولوجيا الشعبوية السائدة التي تلعب دوراً إرهابياً، يقوم على تخوين دعاة الواقعية كطريقة في فهم الأمور والعقلانية سبيلاً لمعالجتها، وعدداً كبيراً من الذين قاوموا الأسدية وعرفوا سجونها، ثم غمرهم ديماغوجيوها الفطريون بثورجيّةٍ جعلت منهم مستحاثاتٍ فات زمانها، يجب شطبها من ذاكرة الشعب، بالطرق التي طالما تعلمها الثورجيون الحاليون من ثورجيّة نظام البعث، إبّان فترة خنوعهم له.
كيف نفسر، من دون أوهام هذا النمط الواسع الانتشار من الثورجيين، إسداء الذين غرقوا من ممثليه، وأغرقوا الثورة في شبر ماء، النصح طوال الأعوام المنصرمة للأميركيين هنا، وللروس هناك، حول أفضل سبل تلبية مصالحهم، ووضع سورية وثورتها في جيوبهم، وتصحيح ما قد ينشأ من سوء تفاهم بين واشنطن والثورة السورية، قد يضعف ما بينهما من وحدة. والحل إن عدداً كبيراً من معارضي الخارج لم يتوقف إلى اليوم عن تقديم النصح للأميركيين حول أفضل سياسات تخدم مصالحهم، في بلادنا وكل مكان، ولم يصدّق أنهم ليسوا أوفى أصدقاء قضيتهم، وأنه لا يقلق نومهم إن بقي النظام والأسد في السلطة، ولا يدافعون، بالأفعال والأقوال، عن حق كل سورية وسوري في الحرية والكرامة. في المقابل، يعتقد عدد كبير من معارضي الداخل أن الاتحاد السوفييتي لم يسقط، كل ما في الأمر أنه غيّر اسمه وحسب، وأن بوتين هو لينين زماننا الذي علينا الثقة به والسير في ركابه، مهما ناقضت أقواله وأفعاله آمالنا، إن كنا نريد لنضالنا ضد بشار الأسد أن يحقّق نتيجةً ما.
في "كليلة ودمنة" قصة عن طائر لقلق نصح حمامة ألا تلقي فراخها إلى الثعلب الذي يهدّدها، كل صباح، بصعود الشجرة والتهام فراخها، إن رفضت إلقاء واحدٍ منهم إليه. قال الطائر للحمامة: لا يستطيع الثعلب بلوغ عشّك في أعلى الشجرة، فلا تلقي بفراخك إليه. بسؤالها، قالت الحمامة: إن طائر اللقلق هو الذي أعلمها بعجزه عن ارتقاء الأشجار. بحث الثعلب عن الطائر. عندما وجده، امتدح جماله، وأبدى إعجابه بضخامة جناحيه، وسأله أين يضع عنقه الطويل، حين تهب عليه العواصف من جميع الجهات. أجاب الطائر المنتشي بالإطراء: أضعه بين ساقي. طلب الثعلب منه أن يريه كيف يفعل ذلك، وحين طوى عنقه وأخفى رأسه بين ساقيه، انقضّ الثعلب عليه، وأمسك به، وهو يقول له: يا غبي، ترى الرأي لسواك، ولا تراه لنفسك.
تلك كانت نهاية لقلقٍ غبي أسكره المديح الكاذب، فمتى تكون نهاية لقالق معارضتنا الذين يرون الرأي لأميركا وروسيا، ولا يرونه لشعبهم، ويقدمون النصح لمن لا يحتاج إلى نصحهم، بينما يرتكبون أخطاء كارثية تضرّ بشعبهم ووطنهم. وكما كانت الحمامة تلقي بفراخها إلى الثعلب الماكر، يلقون هم مواطنيهم إلى أعداء يستمتعون برؤيتهم وهم يتخبطون في مأزقهم، أو يقتلونهم، أو إلى غزاة احتلوا بلادهم، وحوّلوها إلى مكانٍ تسرح فيه ضوارٍ من شتى الأصناف والدول، تشارك الأسد في نهش لحم شعبهم ولعق دمائه.
يا لقالق المعارضة: متى ترون الرأي لشعبكم، ولا ترونه لأعدائه وخصومه؟.
 ٣ يوليو ٢٠١٦
٣ يوليو ٢٠١٦
الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأشهر السبعة الأخيرة من رئاسته للولايات المتحدة سيُكتب ويُقال الكثير عن سجله والإرث الذي سيخلفه بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) 2017. الرجل ذكي في شكل لافت، ويملك موهبة الخطابة الرزينة، لا يمكن اتهامه بأنه بسيط في تفكيره وحساباته وأهدافه، على رغم ذلك هو رئيس من دون سياسة خارجية متماسكة. مواقفه تجاه أوكرانيا وسورية والعراق تؤكد ذلك. يبدو أحياناً متناقضاً، وربما مرتبكاً. خذ تأكيده أن التدخل الأميركي في أي بلد في الشرق الأوسط، مثلاً، مشروط بالتزام هذا البلد تبني سياسة داخلية متوازنة تجاه جميع مواطنيه من دون تمييز («النيويورك تايمز» 8 آب - أغسطس 2014). ضع هذا التأكيد أمام تقاسم النفوذ مع إيران في العراق، وتحالف إدارته مع ميليشيات «الحشد الشعبي» على رغم أنها ميليشيات طائفية، وتمارس العنف والقتل على أساس طائفي. أضف إلى ذلك قرار أوباما فرض عقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، وضم جزيرة القرم إليها، ثم مكافأتها في الشرق الأوسط بتسليمها الملف السوري بكامله.
يبدو أوباما أحياناً على درجة عالية من الحس الأخلاقي، يعبر عنه موقفه الرافض للحروب. من ناحية ثانية يبدو بارداً تجاه آلام ومآسي الآخرين. جاء إلى البيت الأبيض بوعد بأن يضع حداً لمغامرات سلفه جورج بوش الابن العسكرية. هل تحققت نتيجة من وراء ذلك؟ لم يتراجع القتل في أفغانستان، وازدادت وتيرته في باكستان. تضاعف القتل وتعفن الوضع السياسي في العراق. في عهد أوباما ظهر «داعش»، وتضاعف عدد الميليشيات في العراق وسورية، ودخل الجيش الروسي إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحولت ميليشيا «حزب الله» إلى قوة تدخل إقليمية لإيران. تجاوز عدد قتلى الثورة السورية 400 ألف وفق إحصاءات الأمم المتحدة، عدا الجرحى والمفقودين والمعتقلين والمهجرين، والدمار الذي طاول كل المدن السورية. في خضم المأزق السوري ظهرت أزمة المهاجرين التي هزّت استقرار أوروبا ونظمها السياسية. وعلى علاقة بذلك خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أمام كل ذلك يبدو أوباما غير آبه. أحياناً يبدو مرتبكاً، في حال دفاع ليست مقنعة لأحد.
في عهد أوباما انفجر الربيع العربي. في اللحظات الأولى لذلك بدا الرئيس حازماً في موقفه الداعم مطالب الجماهير في الشوارع. لكن تدريجياً بدأ يتبين أن أوباما كان رهينة حال ارتباك تتصاعد. اخترع فريق الرئيس مصطلح «القيادة من الخلف» في الحال الليبية. المهم أن تبقى القيادة لأميركا، حتى ولو من الخلف. في سورية، وكما فعل في حالات أخرى، طالب أوباما بشار الأسد بالتنحي. ذهب أبعد من ذلك حين وضع خطاً أحمر أمام استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد المتظاهرين. النظام السوري استخدم بالفعل هذا السلاح ليس تحدياً للرئيس الأميركي، لكن طبيعة النظام الدموية وحال اليأس التي شعر بها في صيف 2013 دفعتاه حينها للمغامرة بآخر أوراقه. قتل نتيجة ذلك أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق. تعالت أصوات الاستنكار والشجب في أنحاء العالم. لم يكتف بالشجب. ربما تملكه شعور بأن صدقيته وصدقية أميركا باتت أمام تحد سافر. لكن سياق الأحداث يشير إلى أن أوباما كان لا يزال رهينة حال الارتباك. أمر قواته بالاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لمواقع النظام السوري. ثم تراجع عن ذلك بسرعة لافتة بعد اقتراح روسي بأن يسلم الأسد كل ترسانة السلاح الكيماوي التي في عهدة الجيش السوري.
تراجع أوباما كان إيذاناً بتسليم الملف السوري إلى روسيا. وهذا ما حصل. آخر معالم ذلك ما ذكرته صحيفة «الواشنطن بوست» الخميس الماضي، بأن إدارة أوباما اقترحت على روسيا تنسيق الطلعات الجوية بينهما في سورية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و»جبهة النصرة»، شريطة أن تمارس موسكو نفوذها لدى النظام السوري لوقف استهدافه المعارضة التي تدعمها واشنطن. أي أنه بعد أن كانت إدارة أوباما تفكر في توجيه ضربة للنظام السوري، باتت تتمنى أن تستخدم روسيا نفوذها لدى هذا النظام بعدم استهداف حلفاء الإدارة. وهذا لا يضيف شيئاً أكثر من أنه يؤكد أن أوباما لا يملك سياسة خارجية واضحة ومتماسكة تجاه المنطقة.
لم يحزم أوباما أمره تجاه أي من ملفات المنطقة. تردد كثيراً أنه يريد إعادة العلاقة مع إيران، لكنه لم يحزم أمره حتى في هذا الاتجاه بعد. لم يستقر على شيء تجاه العراق، ولا «داعش» أو الإرهاب. يحارب تنظيم «داعش» من الجو، ويتحالف مع ميليشيا «الحشد الشعبي» في العراق، ومن الجو أيضاً. عملت إدارته على تدريب قوات من سوريين وأكراد لمحاربة «داعش» على الأرض، بدلاً من قوات أميركية. أي أنه يستخدم مرتزقة لتحقيق أهداف غامضة لا علاقة لهم بها. ما يؤكد أن أوباما لم يحزم أمره في سورية أيضاً. القضاء على «داعش» ليس أولوية بالنسبة الى أوباما. هدفه، كما قال، متدرج «إضعاف هذا التنظيم، ثم القضاء عليه». كم ستأخذ عملية الإضعاف هذه؟ وفق تقديرات الإدارة قد تأخذ أكثر من 30 سنة. من يصدق ذلك؟ الأسوأ أن الرئيس لا يعتبر «داعش» نتيجة لما حصل للمنطقة، بما في ذلك الغزو الأميركي للعراق وما انتهى إليه، ووحشية النظام السوري، وتسليم سورية لروسيا. من هنا لا تملك إدارته خطة أو استراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة. كل ما تفعله أنها تعزل «داعش» عن محيطه وسياقه، وتعمل على إضعافه بالشكل التدريجي المذكور. كأن أوباما يتمنى إضعاف قدرات هذا التنظيم بحيث لا تتجاوز حدود الشرق الأوسط، وألا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة. وإذا صح هذا، فهو يبدو وكأنه يريد بقاءه ورقة ضغط على الآخرين في المنطقة. لكن تاريخ تعامل الولايات المتحدة مع الإرهاب هو تاريخ فشل متصل. في مرحلة أفغانستان في تسعينات القرن الماضي، لم يكن هناك إلا تنظيم إرهابي واحد اسمه «القاعدة». بعد أكثر من ربع قرن من الحرب على هذا التنظيم، ليس فقط أنه لا يزال معنا، بل تضاعف عدد التنظيمات الإرهابية، بحيث أنه يقترب الآن من المئات، ما بين تنظيمات سنية وشيعية. والسؤال الذي يتجنب أوباما مواجهته هو الآتي: لنتجاوز تقديراتك بأن القضاء على «داعش» قد يستغرق 30 سنة، ولنفترض أنه تم القضاء عليه في نهاية هذه السنة، أو السنة المقبلة، ثم ماذا؟ ماذا عن الميليشيات الأخرى التي تجوب المنطقة طولاً وعرضاً؟ ماذا عن نظام الأسد الذي يغذي بقاؤه الإرهاب، ويحتمي بميليشيات إرهابية؟ وماذا عن النظام الطائفي الذي أفرزه تجاور الاحتلال الأميركي والنفوذ الإيراني في العراق، ويعتمد على الميليشيات؟
ربما أن أوباما غير مدرك، أو غير آبه بالعلاقة بين قناعاته السياسية، وحجم التداعيات التي تترتب عليها عندما تتحول إلى سياسات نظراً إلى حجم الولايات المتحدة وتأثيرها. وربما أن قراره بالتحول نحو شرق آسيا قد قلل من أهمية الشرق الأوسط بالنسبة اليه. لكن ما قاله هو نفسه عن المنطقة قبل حوالى السنتين، ثم أخذ يردده بعد ذلك أمر لافت. يقول: «أنا أعتقد بأن ما نشاهده في الشرق الأوسط وجزء من شمال أفريقيا هو بداية انهيار لنظام إقليمي يعود تاريخه للحرب العالمية الأولى». («النيويورك تايمز»، 8 آب 2014). مواقف وسياسات الرئيس الأميركي تبدو وكأنها تدفع باتجاه تسريع عملية الانهيار. هل هذا مؤشر إلى وجود سياسة متماسكة، أم إلى غيابها؟
 ٢ يوليو ٢٠١٦
٢ يوليو ٢٠١٦
حمل التدخل العسكري الروسي عند حصوله قبل ثمانية أشهر فكرة أساسية، جوهرها إحداث تبدلات عميقة في الواقع الميداني على الأرض في سوريا، ومن شأن هذه الفكرة، إن تحققت كما رغب الروس وحلفهم مع إيران ونظام الأسد، أن تفتح الباب نحو تسوية يقبلونها، أساسها تعديل ميزان القوى عبر إعادة بسط سيطرة النظام وحلفائه على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، الأمر الذي يضع المعارضة أمام القبول بالنظام وحلفائه في مستقبل سوريا والدخول في شراكة معه عبر حكومة وحدة وطنية، أو الاندحار سياسيا، إذا رفضت المشاركة.
وفي الحالتين، فإن المراهنة الروسية على دحر المعارضة والسيطرة على المناطق الخاضعة لها، سوف تؤهل النظام إلى الانضمام إلى التحالف الدولي للحرب على «داعش» وهزيمته، وإن طالت الحرب.
غير أن الفرضيات الروسية، اصطدمت بالواقع، فلم تحقق حسما في ثلاثة أشهر، كما توقع الروس، رغم دموية هجماتهم الجوية ومساعداتهم غير المحدودة في التغطية الجوية لهجمات قوات حلفائهم، التي دفعت أعدادا كبيرة من جنودها وعتادها للحرب في حلب وريفها في الأشهر الماضية. ولم يغير تمديد الفترة أشهرا تالية واقع أن الحرب كر وفر، والمعارك بين ربح وخسارة، ولا نتائج حاسمة فيها.
حالة الاستعصاء السوري في غياب حل سياسي، فشل المجتمع الدولي في الوصول إليه سواء لعدم توافق أطرافه أو بفعل عدم رغبتهم في التوافق عليه بالتزامن مع عدم القدرة على حسم عسكري، تنجزه أطراف القوى المتصارعة في الميدان، يدفعان إلى استمرار الحال السوري بما هو عليه من صراع مدمر، ويدفعه إلى الأشكال الأكثر وحشية على نحو ما يحصل في حلب وجوارها، والأمر في هذا، يؤشر إلى رأس جبل الجليد في الصراع الذي تتجسد قاعدته في مظاهر الأخطر فيها:
تنامي الخلاف والصراع داخل تحالف النظام حيث صراع روسي – إيراني ومثله بين الروس و«حزب الله»، وصراع بين «حزب الله» وقوات الأسد، وخلافات نظام الأسد مع موسكو. وكلها تجاوزت حدود الخلافات السياسية إلى خلافات ميدانية، ظهرت في الآونة الأخيرة في معارك حلب وريفها، كان بين تعبيراتها الأشد، امتناع روسيا عن توفير دعم جوي لمعظم هجمات قوات حلفائها وميليشياتهم على قوات المعارضة المسلحة، أو الامتناع عن ضرب الأخيرة إبان هجماتها على قوات النظام و«حزب الله»، كما كان بين تعبيراتها قيام طائرات النظام بشن هجمات جوية ضد ميليشيات «حزب الله» جنوب حلب.
ويتوازى مع الصراعات البينية لتحالف نظام الأسد، صراعات وخلافات مماثلة داخل جماعات المعارضة السياسية والعسكرية، وفي الجانب الأول ما يظهر من خلافات في موضوع التمثيل السياسي والذي تتصارع عليه تحالفات وقوى متعددة، تسعى إلى كسب تأييد دولي لمكانتها في التمثيل السياسي، ويتجاوز الأمر ذلك إلى صراعات بين التشكيلات المسلحة للمعارضة على نحو ما ظهر الصراع الميداني في غوطة دمشق، بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن، فيما تتواصل صراعات ميدانية أقل حدة في الشمال والجنوب على السواء بين تشكيلات في المعارضة المسلحة، لكنها تتدارى بسبب من ظروف سياسية، يفرضها ويغطي عليها واقع الصراع المحتدم مع معسكر النظام، ومنها صراع تشكيلات الجيش الحر مع جبهة النصرة، التي وإن كانت نظريا وسياسيا مصنفة إرهابية، لكنها عمليا قوة حاضرة في تحالف «جيش الفتح» في الشمال.
وسط الصراعات والخلافات البينية بين طرفي الصراع الرئيسي، يستمر وضع «داعش» بالاستقرار في مناطق سيطرتها مع فشل الحرب الدولية عليها، وعجز أطراف الصراع الداخلي لأسباب متعددة ومعقدة عن خوض صراع جدي وحاسم ضدها في دير الزور وفي الرقة حيث تتمركز، وتدور ضدها معارك محدودة في ريف حلب، يشارك فيها مختلفون ومتصارعون من قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الاتحاد الديمقراطي الكردي (pyd) وجماعات المعارضة المسلحة، بينما تعزز قوات سوريا الديمقراطية مواقعها، وتزيد انتشار قواتها بدعم مباشر علني ومزدوج من الأمريكيين والروس على السواء، على حساب قوى المعارضة المسلحة.
ولأن كان تنامي الصراعات والخلافات البينية لقوى الصراع السوري وفيها، يمثل جانبا في المرحلة الأصعب التي يواجهها السويون وقضيتهم في الأفق الحالي. فإن ثمة جانبا آخر، لا يقل أهمية، الأبرز فيه تصعيد استهداف المدنيين قتلا ودمارا، وهي حقيقة قائمة في كل المناطق، بغض النظر عمن يتحكم في تلك المناطق ويسيطر عليها، وتتضاعف خطورة ما يجري في هذا الجانب، في ظل إغلاق شبه مطلق من جانب دول الجوار على دخول المدنيين إليها، وترافقه مع اتساع رقعة الاغتيالات والخطف والاعتقال، التي لا تطال قادة عسكريين ونشطاء فقط، بل شخصيات وقيادات سياسية ومدنية وأهلية في كل المناطق.
خلاصة الأمر أن الوضع السوري ماض نحو مزيد من الدمار السياسي والعسكري والمدني والتشظي والفوضى لمرحلة يصعب التنبؤ بنهايتها، طالما أن المجتمع الدولي عاجز عن المضي نحو حل سياسي أو غير راغب فيه، وهو لا يريد أو لا يستطيع إنجاز «حل عسكري» يضع حدا لما هو قائم من صراع سوري وحول سوريا.
 ٢ يوليو ٢٠١٦
٢ يوليو ٢٠١٦
كان لحالة الاستبداد السياسي في سوريا، واستمرار قوانين الطوارئ والأحكام العرفية لنصف قرن من الزمن، واحتكار السلطة وفرض الوصاية على الشعب وقواه الحية، والاستئثار بالقرار الوطني، أثر بالغ في افتقار الشارع السوري إلى ثقافة حزبية وافتقار الوعي السوري العام إلى فهم طبيعة الدور الذي تسهم من خلاله الأحزاب السياسية في رسم سياسة الدولة، لهذا أتى مطلب السماح بتأسيس الأحزاب من أبرز المطالب السورية طوال الفترة الماضية التي اتسمت بغياب مفهوم التعددية وهيمنة حزب البعث على قيادة الدولة والمجتمع، وتجميد عمل الأحزاب السياسية منذ العام 1972 في ما يسمى الجبهة الوطنية التقدمية للإيحاء بأن هناك أحزابا معارضة وممثلة في الحكم.
أدى الحراك السوري منذ انطلاقته إلى تفعيل الحياة السياسية السورية، ومع صدور قانون الأحزاب في أغسطس 2011 تم الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة المتنوعة في اتجاهاتها السياسية، كما ظهرت تشكيلات قريبة من النظام وتمتلك رؤية مشابهة لرؤيته، بالإضافة إلى تشكيلات معارضة متنوعة ذات فعالية محدودة، بعضها مكون من عدد من الشخصيات المعارضة المستقلة والثقافية، غير أن أهم التشكيلات السياسية المعارضة هي هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي في سوريا، وتعدّ تجمعا لقوى مختلفة بالرؤية السياسية إذ تضم ممثلين عن أحزاب يسارية وقومية وإسلامية معتدلة، ورموز المجتمع المدني، والعديد من رموز الثوار، وقد لخّصت عملها ضمن ثلاثة أهداف؛ “لا للتدخل الأجنبي، لا للعنف، ولا للطائفية”، وهي رغم ادعائها تمثيل المعارضة الداخلية، إلا أنها لم تتمكن من قيادتها أو تمثيلها سياسيا، كما لم تستطع أن تكسب التأييد الشعبي اللازم.
أحزاب الداخل لم تخرج من حالة الشلل في قدرتها على العمل وفي تحقيق غاياتها عبر خلق قاعدة شعبية لعملها السياسي لأسباب عديدة منها اعتمادها على منطق أيديولوجي وخطاب سياسي يبتعد عن مقاربة الواقع الاجتماعي المعيش، وبقاء هذه القوى محكومة بالأطر الشخصية والحزبية، وعدم قدرتها على مأسسة العمل الحزبي، وإخفاقها في تفعيل دورها على الأرض الذي لا يبتعد عن مسألة تطبيق مبدأ التمثيل، الذي يقتضي توفر إمكانية العمل الدؤوب للوصول إلى تحقيق تطلعات غالبية السوريين بإسقاط نظام استبدادي، والأخذ بأيديهم في جميع القضايا والمسائل، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات والمستجدات في الداخل والخارج.
إخفاق التمثيل الذي تعانيه معارضة الداخل ينطبق بصورة أكبر على المعارضة الخارجية، والتي رغم احتكارها للمشهد السياسي منذ مؤتمر أنطاليا في صيف العام 2011، مرورا بإعلان تأسيس المجلس الوطنيّ السوري في إسطنبول في العام نفسه، إلى إعلان تأسيس الائتلاف الوطني في الدوحة على أنقاض المجلس، وحتى مؤتمر الرياض وتشكيل الهيئة العليا للتفاوض التي انبثقت عنه، استمرت في مراكمة فشلها بعدم قدرتها على امتلاك أي رؤية وطنية لكيفية الحل، فبدأت بخسارة الثقة الشعبية منذ لحظة ولادتها، وعدم امتلاكها لأي فكرة عن آلية العمل المؤسساتي وأهميته في بناء إطار عمل وطني قادر على جذب السوريين للخوض في مقارعة النظام، وإقناع المجتمع الدولي بمخططها وأسلوب عملها بحيث تكون مصدر ثقة وبديلا عن النظام، فما بات يعرفه الشارع السوري يعرفه المجتمع الدولي، وهو أن ما تم تأسيسه في الفترة الماضية هو تصورات لمؤسسات قائمة بفعل تمويلها من الخارج، ولا يحتاج قرار إغلاقها إلى أكثر من اتفاق دوليّ إقليمي يستطيع أن ينهي ما يسمى تشكيلات المعارضة الخارجية، أما التشكيلات الحزبية الداخلية فقد استمرت في لعب دورها كأحزاب أو تشكيلات أزمة لا أكثر، ولاتزال تقدم طروحاتها النظرية في سياق بات أحوج ما يكون إلى الطرح العملي ضمن أطر قانونية في التنشئة والتأهيل والتنمية السياسية.
الواقع الحالي بقدر ما يبدو مخيبا للآمال، يستدعي المزيد من التفكير والعمل في آن معا لتجاوز المأزق السياسي السوري، وإنشاء كتلة وطنية تعتمد مبدأ الشراكة السياسية وتأخذ بزمام المبادرة في العمل على برامج وسياسات واضحة تكون مرجعيتها من السياق الاجتماعي لحياة المواطنين، وتعبّر عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع بكافة أطيافه، مطوّعين كافة الأفكار والنظريات لخدمة هذا الهدف، فهو الحل الممكن لشرعية التمثيل واضطراب الخطاب السياسي وتخبّطه الذي يقدّم خدمات مجانية للنظام وللميليشيات وحاملي حقائب المال السياسي.
فعمق الأزمة أيا كانت أسبابه وحالة الانقسام سيقف حجر عثرة أمام فرض احترامها على الشعب والمجتمع الدولي، ولن تؤهل لقيام بدائل النظام الحالي الذي يزداد تمسكا بزيادة أمد الحرب رغم كل الفناء الذي يعيشه الشعب.
 ٢ يوليو ٢٠١٦
٢ يوليو ٢٠١٦
إذا كان الإنسان يضرب به مثل “الإناء ينضح بما فيه”، فالدول والأنظمة أيضا تنضح بما فيها؛ وإيران نضحت في العراق والمنطقة مياه غسيلها وبزلها وملأت أرضنا بالأملاح حقيقة واستعارات معنى.
صادرات ثورة ولي الفقيه على طريقها البري للوصول إلى تحرير القدس، تعرضت إلى مطب صناعي، فسارعت بالإيعاز إلى مهندسيها وحجاج الولاية بإخراج ألسنتهم الملحية للتحذير من إقامة الإقليم الطائفي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، واعتبرته عائقا طبيعيا بوجه دول المقاومة والممانعة وتواصلها والذي تمثله بلدان الهلال الخصيب سابقا والهلال الطائفي في إيران والعراق وسوريا ولبنان حاليا.
ولأنهم مع وحدة العراق وترابه ووحدة أرض المقاومة، فهم ضد مخطط الصهيونية الساعي إلى إقامة الإقليم العازل؛ لذلك تم تكليف قاسم سليماني برئاسة فيلقه الهندسي لتعبيد الطريق إلى القدس، والذي باشر عمله في صلاح الدين وأدى واجبه ثم انتقل إلى الفلوجة بكل إمكاناته وحشده وإصراره على “تسوية” الموصل تماما، وإجبار سلطة المركز المحتلة لكرادة مريم في بغداد على إصدار تعليمات بالموافقة على مشاركة الحرس الثوري العراقي في قاطع عمليات نينوى.
ليس تهكّما لكن شر “ملالي طهران” ما يضحك؛ فبعد دعوات زبائنها من الأحزاب وزعماء كتلها السياسية في برلمان احتلال العراق وترويجهم لإقامة إقليم الجنوب ومحاولتهم ترك بغداد تحترق أثناء الحرب الأهلية بعد تفجير المرقدين في سامراء عام 2006 في حادث مدبّر، وما تلا هذه الحرب من جرائم وتصفيات وأعراس دم أقدمت عليها ميليشياتها الطائفية ووأدت بأفعالها كل أمل في التعايش السلمي؛ تبدو إيران هذه الأيام مهتمة جدا بوحدة العراق، كاملة وغير منقوصة، في محاولة لتبرير زج قواتها رسميا في معارك تحرير المدن العراقية المستباحة من إرهاب تنظيم داعش، لتكمل بحالتها الإرهابية ما بدأته أميركا باحتلال العراق، وما مهدت له القوات الأمنية ثم القطعات العسكرية النظامية بانسحابها أمام أعداد قليلة، عدّة وعددا، من المهاجمين في هزيمة غير مسبوقة ووصمة عار لزعيم حزب الدعوة رئيس الوزراء لدورتين متلاحقتين لحكومة الاحتلالين الأميركي الإيراني، الذي وفر الغطاء المطلوب لتسليح تنظيم الدولة داعش بما لا تحلم به الجيوش النظامية، وفتح باب الإرهاب واسعا، واضعا المنطقة في أتون الصراعات الإقليمية والدولية، مهيّئا كل مستلزمات إبادة وتهجير الأقليات الدينية والإثنية، وإعلاء أصوات ودوافع انفصال إقليم كردستان، وطموحات ومسوغات لن تقف عند حدود المحافظات الثلاث، أربيل وسليمانية ودهوك، بل ستجر الويلات مستقبلا لشعب العراق؛ وبوادر اشتعال الأزمات قائمة وضحاياها لن تغفلهم الأخبار.
كوميديا العداء الإسرائيلي الإيراني، والأميركي الإيراني، والسوري الإسرائيلي، والإيراني الداعشي، والسوري الداعشي، والإسرائيلي الداعشي، وكل خلطة البهارات المتجانسة والمتنافرة؛ لن تستقيم أبدا في خواتيم الخدمات والمنافع المتبادلة والغرام من خلف الأبواب المفتوحة، ربع ربع أو نص نص؛ وتبادل الهدايا تحت جنح الظلام.
حكومة المنطقة الخضراء ودستورها وميليشياتها وممارساتها وشعاراتها وطقوسها ورشاواها وتبعيتها وعمالتها وإثارتها لمشاكل التاريخ وحوادثه، وحشدها الطائفي وقاسمها ومهندسها وحجاج ولاية الفقيه الإيراني، وما جرى من إهانة لمكون كبير من الشعب، استهدف حياتهم ومدنهم وكرامتهم، يدفعهم دفعا للبحث عن ملاذ آمن.
إيران تجتاح المنطقة وتضع العراق والعرب في مرمى مكائدها، وتنصّب نفسها مدافعا عن وحدة تراب العراق، وذلك يعني أنها لم تعد تفكر في ارتداء خمار الطائفية، بل أسفرت تماما عن وجهها ومطامحها القومية الفارسية، وهو لب وجوهر مشروعها وصادراتها على أوتوستراد القدس.
تستغل إيران قضية العرب المركزية فلسطين، لأنها تدرك وقع آثارها النفسية على عقل وقلب كل عربي وتتلاعب بهذا الحقل المغناطيسي الجاذب لحماستهم، فتحرك أقطابها تحت راية فيلق القدس، وشعارات إبادة المدن وتغيير ديموغرافيتها تحت لافتة الوصول إلى القدس، ومن أجل القدس توجهت كل أسلحة الجيش السوري إلى صدور الشعب السوري صاحب ملكيتها، الذي تجرع الفقر والظلم من أجل تحرير الجولان والإبقاء على حد أدنى من السيادة والكرامة، وساهمت تلك الأسلحة مع أسلحة ملالي طهران في إبادة الآلاف من شعب العراق وتدمير مدنه في حرب الثمانينات، أو في إطلاق وحوش القاعدة أو داعش الذين قلبوا كل المعاهدات الدولية والإقليمية لصالح إبقاء النظام السوري على رأس السلطة، وخذلان المعارضة المسلحة المعتدلة، وتشتيت وسائل الحل السياسي كما تشتتت وجهات فوهات البنادق، وسخرت الآلة الطائفية لإيران ومنحها براءة اختراع وإنتاج واسع لحماقاتها وادعاءاتها وتزويرها بتعاملها اللزج لتضيع الحقائق وسط الحرائق.
هذا العداء الإيراني لإسرائيل توج بمطالبة أتباع ولاية الفقيه بتغيير اسم بابل إلى اسم الحسن بن علي بن أبي طالب؛ ولكم أن تتفحصوا وتختبروا حجم كمية السم في العسل أو العكس وتتعرفوا على أسرار التقارب بين إسرائيل وإيران، خاصة إذا اطلعتم على الجرح الذي تسببه بابل لإسرائيل ومدى الاستفزازات التي كان يشكلها مهرجان بابل وشعاراته المرفوعة قبل احتلال العراق، وما جرى أثناء اتخاذ مدينة بابل الأثرية كقاعدة عسكرية للقوات الأميركية وأحداث أخرى تتحشد للدفاع عن مستوى العلاقات وتخادمها بين إيران وإسرائيل.
سقط الخمار الطائفي عن وجه الولي الفقيه، عندما كشف عداء نظامه القومي الفارسي للعراق وللعرب، ومثالنا الأخير ما يتعرض له شط العرب ومدينة البصرة سنويا، من بداية يونيو إلى أكتوبر، نتيجة لغلق تدفق نهر الكارون وتحويله وخزن مياهه في الأراضي الإيرانية، بما يؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح إلى أكثر من 2500 جزء بالمليون وهي النسبة المحددة لصلاحية الإرواء، وتصل إلى 8000 أو 13000 جزء، وتنفق عندها أسماك المياه العذبة وتتلف المزروعات، ومع قلة المياه الشحيحة أصلا من دجلة والفرات، تتسرب مياه الخليج المالحة إلى داخل البصرة مسببة ظاهرة اللسان الملحي وتمتد إلى ما يقارب 60 كلم، يضاف إليها تصريف مياه البزل الإيرانية؛ إيران تنضح بمشروع ولايتها بما فيه، لتؤكد أن الإرهاب ليس طبعة دينية واحدة فقط، إنما ملاحق وكراسات ونفخ سحال.
 ٢ يوليو ٢٠١٦
٢ يوليو ٢٠١٦
السلطات التركية هي التي أكدت أن منفذي هجوم الانتحاري على مطار إسطنبول من تنظيم داعش٬ جاءوا من محافظة الرقة السورية٬ مقر «دولة الخلافة».
إن كانت «داعش» حًقا المدبر٬ الأمر محير٬ ما الدافع؟
وإن كانت خلف هذه العمليات أجهزة موالية لنظام الأسد٬ فما الذي تريده؟ وما خيارات تركيا في الحالتين؟
دافع «داعش»٬ ربما انتقاما من تركيا لأنها سدت معابر التمويل والمرور لمقاتليها عبر أراضيها٬ ولأنها انخرطت في الحرب عليها بالتعاون مع الولايات المتحدة٬ ولأنها تصالحت مع روسيا وإسرائيل. وقد تكون لهم مطالب مثل إطلاق سراح معتقليهم.
الذي تغير أن تركيا٬ في السابق٬ كانت تغمض عينيها عن حركتهم٬ فاتخذوها ممرا أساسيا لهم. لكن غضب «داعش» ضد حكومة إردوغان لا يبرر مهاجمتها٬ وهناك قائمة طويلة من الأعداء أهم على التنظيم استهدافهم٬ بل إن تكرار هجوم «داعش» على تركيا سيضاعف من عزم السلطات على ملاحقة مقاتليه واعتباره عدًوا.
الاحتمال الأرجح أن التنظيم الإرهابي مخترق٬ بدليل أن كثيًرا من نشاطاته تخالف طروحاته الفكرية. خلال يومين متتاليين نفذ «داعش» هجومين ضد فريقين سياسيين على خلاف مع النظام السوري. الأول قام به ثمانية انتحاريين على بلدة القاع اللبنانية على حدود سوريا٬ التي يسيطر عليها حزب «القوات اللبنانية»٬ خصم لنظام الأسد. والهجوم الثاني نفذه ثلاثة انتحاريين على مطار إسطنبول. وهجوم «داعش» على «القوات اللبنانية» يناقض ما يقوله التنظيم إنه يستهدف قوات الأسد وحزب الله في تلك المنطقة. كما أن الزج بثمانية انتحاريين على بلدة القاع٬ منطقة محدودة الأهمية في الصراع٬ أمر غريب ورقم كبير٬ ولم نعرف له مثيلا إلا مرة في معركة الأنبار العراقية قبل عام تقريًبا.
كما أن تكرر استهداف تركيا يعزز رواية أن الجماعات الإرهابية مخترقة. فقد كان تنظيم «القاعدة» يعمل مع نظام الأسد عندما كان يوجد في سوريا خلال حربه ضد القوات الأميركية في العراق خلال فترة الاحتلال٬ وكان التنظيم يعمل مع المعارضة العراقية وعلى علاقة مع أجهزة النظام السورية لاستهداف القوات الأميركية في العراق. وعندما ولد «داعش» خلال الانتفاضة السورية جاء امتداًدا لـ«القاعدة»٬ وحارب فئات مختلفة على الأرض٬ بما فيها المعارضة السورية المسلحة الوطنية مثل «الجيش الحر»٬ وكذلك عدًدا من التنظيمات الإسلامية المقاتلة٬ كما أنه نفذ عمليات ضد النظام السوري وحلفائه.
وإذا لم يكن «داعش» مخترقا من قبل أجهزة النظام السوري٬ فإن التنظيم رغم تعصبه الآيدولوجي لا يمانع في التعاون مع خصومه على الأرض٬ وهو الآن يعمل مع نظام الأسد ضد تركيا ضمن لعبة البقاء. وسبق أن مارسها في العراق بتعاونه مع الجماعات البعثية رغم أنه يكفرها٬ كما سبق له أن عقد صفقات متاجرة مع نظام الأسد في سوريا فكان يبيع له النفط بعد أن سيطر على آباره في الرقة.
وهناك من يشير بإصبعه للروس٬ باستخدام الإرهابيين للهجوم على تركيا٬ لكن لا توجد أدلة مقنعة. ربما روسيا أكثر دولة لها مصلحة في إضعاف تركيا٬ وقد سبق لها وتوعدت حكومة إردوغان لأنها أسقطت طائرتها٬ وطالبتها بوقف تعاونها مع «التنظيمات الإرهابية»٬ كما تسمي كل الجماعات المسلحة المناهضة لحليفها نظام الأسد. إنما لم يعرف للروس مثل هذا التفوق من قبل في اختراق واستخدام الجماعات الإسلامية٬ بخلاف النظام السوري الذي يملك خبرة ثلاثين عاما٬ بمخابراته التي تدير جماعات دينية متطرفة٬ من فلسطينية ولبنانية وإسلامية.
السؤال٬ هل سيؤثر الهجوم الموجع في سياسة حكومة إردوغان ويغير مواقفها؟
لا شك أن المحققين الأتراك أقدر على معرفة من وراء الهجوم على مطار إسطنبول. وسواء كان المدبر الإرهابيين أنفسهم٬ أو مخابرات نظام الأسد٬ أو حلفاءه٬ فإن مصلحة حكومة إردوغان هي إعادة النظر ليس في التخلي عن الثورة السورية٬ بل مراجعة سياستها في مقاطعة تنظيم «الجيش الحر» المعارض. فقد أثبت التنظيم مع الوقت٬ رغم ما أصابه من ضعف وخسائر٬ أنه الخيار السوري الوحيد الذي يستحق الدعم والمراهنة عليه كجماعة لا تحمل أجندة خارجية٬ بخلاف بقية التنظيمات المعارضة٬ مثل «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»٬ التي لا يختلف فكرها كثيرا عن «داعش» وإن لم تتورط بعد في عمليات ضد تركيا وحليفاتها.
مصلحة الأتراك تنشيط الحل العسكري ضد الأسد للوصول إلى حل سياسي ملائم يجمع بين النظام والمعارضة٬ حتى يؤمن في الأخير السلام لسوريا وجيرانها. من دون تفوق عسكري ستستمر الفوضى؛ لأن نظام الأسد المكسور غير قابل للإصلاح.
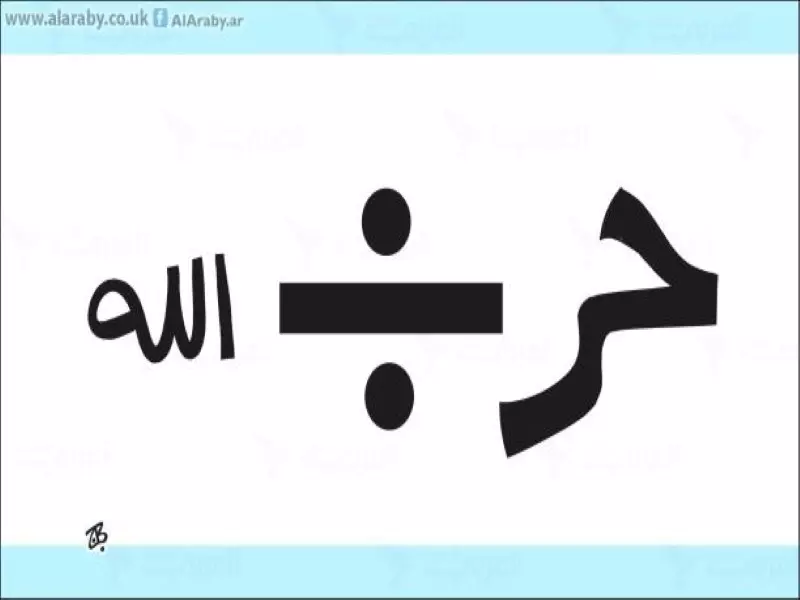 ١ يوليو ٢٠١٦
١ يوليو ٢٠١٦
لعل نقطة التقاطع المشتركة الأبرز بين شخصية الجنرال المرابط على تخوم ميدان معركةٍ وشيكة، قوامها الحديد المسقي وحمم النار، وبين تكوين المقامر المدمن على اللعب فوق الموائد المخملية الخضراء، نقول لعلها شاخصةٌ في نقطةٍ مركزية واحدة، وهي أخذ المخاطر من حيث المبدأ، وتقبّل عنصر المجازفة المحسوبة بدقة. وعدا ذلك، لا تماثل ولا خاصيات ولا قواسم بالحد الأدنى، بين من يقف على الحدّ الدقيق الفاصل بين الحياة والموت وبين من يلهو بمدخراته أو بمرتب آخر الشهر أو غير ذلك.
وأكثر ما يعز على قلب المقامر الداخل لتوه على لعبة الأثرياء الماجنة هذه، أن يخسر رصيده مبكراً قبل احتدام الكباش في ليلة السهرة الممتدة غالباً حتى مطلع الفجر، ويشقّ عليه أكثر فأكثر، أن ينسحب مكرهاً من مقعده الوثير، بعد أن يسوء حظه وينفذ البنكنوت من جيب سترته الفاخرة، ثم يرفض الندماء الضالعون بأحكام المراهنات على خمس أوراق كلها مخفية، تسليفه مبلغاً يسيراً، لإكمال شوط هذه المغامرة التي إن بدأت خاسرةً تظل هكذا إلى النهاية.
وعلى نحو ما تمليه غواية الانخراط في سحر عالم المقامرة الماتع، الطافح بأحلام الأرباح السريعة، وما تشيعه أجواؤها الملبدة بروائح السيجار الفاخر، من أوهام وأضغاث تصوراتٍ ورديةٍ زائفة، أوحت سابقة معركة القصير عام 2013 لحزب الله، الباحث عن طريق القدس عبر الزبداني وإدلب، بإمكانية البناء على ما تحقّق من أرباح عسكرية مبكرة، والاندفاع أبعد فأبعد إلى مناطق سورية أخرى، قادته، أخيراً، إلى حلب، بذهنية المقامر السعيد بطالع نجمه في أول السهرة.
ولعل خطاب حسن نصر الله، أخيراً، بمناسبة ذكرى الأربعين لمقتل رئيس أركانه مصطفى بدر الدين في سورية، كان دليل إثباتٍ قاطع، ليس على كونه عتلة إيرانيةً فحسب، وإنما أيضاً على استحكام روح المقامرة لدى وكيل الولي الفقيه في لبنان، وأبلغ شهادة على انجرافه الشديد وراء وهم تكرار واقعة القصير في حلب، على الرغم من التباين البيّن بين المكانين، واختلاف مدخلات الصراع بين زمنين موغلين في الدماء والدمار، ناهيك عن فوارق المعطيات التسليحية والبشرية على جانبي المتراس، الواسع وسع الجغرافيا السورية.
لقد تم تشخيص هذا الخطاب التعبوي المباشر، من الخصوم والمريدين على حد سواء، على أنه خطاب تمهيدي لمعركةٍ وصفها زعيم حزب الله بأنها استراتيجيةٌ كبرى. وقال، بما معناه، إنها ستكون نقطة تحوّل مفصلية في مسار الحرب الدائرة منذ خمس سنوات وأكثر. وبدا الرجل، في رسالته الكاشفة ونبرته المتعالية، كمن يقود قوة إقليميةً عظمى، مستعدة لدفع ضريبة الدم بالكامل، وذلك لحجز مقعدٍ لها على طاولة المفاوضات المحتملة، وأخذ حصتها العادلة من كعكة التسوية اللاحقة، كتفاً إلى كتف مع القوى الإقليمية الدولية المتصارعة.
وأحسب أن تعهد نصر الله بكسب معركة حلب المنتظرة، ووعيده بإرسال مزيد من قواته إلى أقصى الشمال السوري، وربما إلى البادية، دفاعاً عن بلاد الهلال الخصيب مجتمعةً، بما فيها الأردن هذه المرة، إنما ينم بأوضح الواضحات (حسب تعبيره) عن عُصابٍ مذهبيٍّ شديد، وعقليةٍ سياسية أحادية الفهم، حتى لا نقول مجدّداً إنها روح المقامرة التي كثيراً ما تودي بصاحبها، في نهاية مطافٍ قصيرٍ، إلى التهلكة، فما بالك، ونحن نتحدّث، هنا، عن حلب التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة لبنان، ولا نتحدّث هنا عن طائفةٍ في بلد الطوائف المتساكنة تحت قشرةٍ من التوازنات الهشّة.
ومع أن الخطاب المشار إليه آنفاً كان حافلاً بالتبجّحات المعهودة، وفائضاً بمفردات التهويل والمبالغة، إلا أن أكثر ما يسترعي الانتباه، وسط هذه الزحمة من الترّهات المتراصفة جنباً إلى جنب، كان ادّعاء زعيم الحزب الممانع (ماذا يمانع حقاً؟) أن قواته المتموضعة حول حلب صامدة (كذا)، وأن خسائرها ضئيلةٌ بالمقارنة مع خسائر الأعداء على الطرف الآخر، علماً أن صفة الصمود لا تليق بالمهاجم أبداً، وإنما تنطبق فقط على مقاومةٍ وطنيةٍ تجابه جيش احتلال أو غزواً خارجياً، وهو ما ينطبق بالمسطرة والفرجار على المليشيات الإيرانية.
على أي حال، وبنظرةٍ استرجاعية لأهم محطات المأساة الشامية، فقد كانت معركة القصير، قبل نحو ثلاث سنوات، بمثابة بوابةٍ واسعةٍ لفيضٍ من التحولات الكبرى في مسار الأزمة السورية، أو قل دعوة مفتوحة لدخول المحاربين، من كل جنسٍ ولون، بزخمٍ شديد على خط الثورة التي تحوّل مقاتلوها الوطنيون إلى مجاهدين بصورة عامة، تحت وطأة الشعور الطاغي بأن الحرب أصبحت، في جوهرها العميق، حرباً مذهبية، خصوصاً بعد أن رفع حزب الله راية الحسين على مسجد بلدة القصير، في إشارةٍ لا تخطئها العين، أن المعارك المتنقلة امتداد، على طول الخط المستقيم، لواقعة كربلاء التاريخية.
وفي مرحلة ما بعد معركة القصير الكاشفة، وما حملته من دلالاتٍ طائفيةٍ فظة، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، باعتباره أكثر المدعوين استعجالاً لمثل هذه الفرصة المواتية، فقبلها على الفور، استثمر فيها جيداً، وراح يتمدّد مع مرور الوقت، إلى أن بات في زمنٍ قياسي قوة عسكرية كاسحة، متسلحاً بخطابٍ مذهبيٍّ معادلٍ ورؤيةٍ مماثلة، حيث راح ينهل من القاموس نفسه، ويراكم على ما أسّست له المليشيات الإيرانية في أرضيةٍ خصبةٍ وملائمة، ثم أخذ يبني على تلك المداميك صرحاً موازياً لما أرساه حزب الله في تربةٍ خصبةٍ، لترويج مزاعم المظلومية، وتسوية حساب الثارات التاريخية.
وعليه، كانت تداعيات معركة القصير وبالاً طاماً بالقناطير المقنطرة، ليس على الثورة السورية فقط، وإنما أيضاً على كل الأطراف المنخرطة في الحرب الطاحنة، بما في ذلك حزب الله الذي أتى بفعلٍ مذهبي وضيع، عن سابق عمد وترصّد، أدى إلى إيجاد نقيضه بصورة أوتوماتيكية، أو قل إيجاد معادله الموضوعي المباشر، الأمر الذي يطرح سؤالاً استفهامياً عما ستفضي إليه معركة حلب الكبرى من مضاعفاتٍ لا حصر لها، إذا كانت معركة القصير الصغيرة نسبياً، أدت إلى كل ما أدت إليه من متغيراتٍ ميدانيةٍ وتحولات سياسية بدلت جوهر الحرب فعلاً، وأخرجتها من بين أيدي القوى المحلية.






