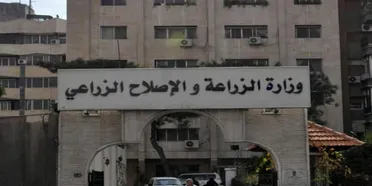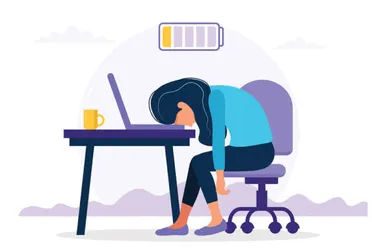العمارة كسلاح: كيف استخدم نظام الأسد التخطيط العمراني أداة للسيطرة والتقسيم
في بلدٍ لطالما عُرف بتنوعه الثقافي والديني، كانت العمارة السورية القديمة انعكاسًا حقيقيًا لهذا التعايش؛ إذ جاورت المساجد الكنائس، واندمجت الأحياء بألوان سكانها المتنوعة في نسيج مدني مشترك. لكن هذا النموذج من الانسجام بدأ يتآكل تدريجيًا، بداية من التخطيط الاستعماري، وتصاعد لاحقًا مع النظام الاستبدادي الذي أسسه حافظ الأسد، وورثه ابنه بشار، ليجعل من العمران أداة مباشرة للضبط الاجتماعي والإقصاء.
القصر المراقب والمدينة المُحاصَرة
تُجسد العاصمة دمشق المثال الأبرز لهيمنة السلطة عبر التخطيط العمراني، إذ شُيّد القصر الرئاسي على قمة جبل قاسيون في موقعٍ يُشرف على المدينة، تمامًا كما في نموذج "البانوبتيكون" الذي وصفه فوكو، حيث تترسخ السلطة في وعي الناس من خلال المراقبة الدائمة، لا الحضور الفعلي. في الأحياء، تنتشر تماثيل الأسد الأب والابن، وترتفع المباني الحكومية الضخمة بأسلوب "العمارة الشمولية"، حيث يسود الطابع الكتلي الصارم الذي يبث الخوف ويرمز لسطوة الدولة.
من الأحياء المتداخلة إلى الفصل المكاني والاجتماعي
في فترات ما بعد الاستعمار، وخصوصًا منذ الثمانينيات، بدأ النظام بإعادة إنتاج المدينة بطريقة تفصل السكان على أسس طائفية وطبقية. نُفذت مشاريع شق طرق سريعة، مثل أوتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي، لتحطيم النسيج المديني المتداخل، ما عزل الأحياء عن بعضها ودمّر التواصل بين الطبقات المختلفة. تزامن ذلك مع تصاعد هيمنة الأجهزة الأمنية على الحيز العام، حيث استُخدمت الأبنية كمواقع للمراقبة والقمع.
العشوائيات.. من مأوى للفقراء إلى سلاح للضبط
مع ازدياد الهجرة من الأرياف نتيجة السياسات الاقتصادية المُجحفة، توسعت العشوائيات على أطراف المدن، مثل عش الورور والمزة 86 في دمشق. لم تكن هذه المناطق مجرد مخالفات عمرانية، بل تحوّلت إلى أدوات للضبط السياسي، إذ غضّ النظام الطرف عن انتشارها في حال كانت مضمونة الولاء، بينما حاصر الأخرى أو استثمر في تفجير التناقضات داخلها.
في دراسات عدة منها بحث لمنظمة "اليوم التالي"، وثّق باحثون كيف استُخدمت هذه الأحياء لاحقًا لقمع الثورة من الداخل، واستُبيحت بعد عام 2011 كـ"أرض معادية" يجب تفكيكها وهدمها، كما في القابون والتضامن وبابا عمرو.
"حلم حمص”.. من تحديث مشوّه إلى كابوس التهجير
في مدينة حمص، التي عُرفت عبر التاريخ بتنوعها، مثّل مشروع "حلم حمص" نموذجًا صارخًا لكيفية تدمير المدينة تحت غطاء التنمية. فقد أُزيلت أحياء سنيّة بالكامل تحت ذرائع التخطيط العمراني، واستُبدلت بناطحات سحاب ومراكز تجارية. وفي غمرة الحرب، تم تهجير أكثر من 50 ألفًا من سكان بابا عمرو والخالدية، بينما بقيت أحياء أخرى، ذات أغلبية موالية، على حالها.
وفقًا للمعماري عمار عزوز، فإن “إعادة الإعمار” في حمص كانت امتدادًا للمشروع السياسي، لا مجرد إعادة بناء، وقد استُخدمت لتغيير التركيبة السكانية، لا لاستعادة المدينة كما عرفها سكانها.
إعادة الإعمار.. عنوان لمشروع الإقصاء
منذ عام 2017، استخدم النظام شعار "إعادة الإعمار" لإكمال ما بدأه من تفتيت للمجتمع السوري، وجرى تسخير هذا المفهوم لإعادة تشكيل المدن وفقًا لهندسة سياسية، تعاقب من ثار، وتكافئ من صمت. في القابون مثلًا، عُوقب السكان لأن أغلبهم لم يملك وثائق ملكية رسمية، ما سهّل منع عودتهم بعد التهجير.
وفي مدن مثل خان شيخون، أعيد نصب تماثيل الأسد على أنقاض المجازر، لتُستكمل بذلك دورة السيطرة الرمزية، وتعزيز رسائل "الردع" حتى بعد سقوط النظام نفسه.
ما حدث في سوريا لم يكن مجرد تدمير بفعل الحرب، بل كان تدميرًا مُمَنهجًا شاركت فيه أدوات التخطيط والعمارة منذ عقود، بحيث أُعدّت المدن لتكون قابلة للضبط والانفجار في آن. وساهم ذلك في اندلاع الثورة، وإطالة أمد الصراع، وترك خلفه ذاكرة مشوّهة وأطلالًا لا تزال شاهدة على كيف يمكن للعمارة أن تكون شريكًا في الجريمة.
المصدر: الجزيرة