 ٨ أغسطس ٢٠١٦
٨ أغسطس ٢٠١٦
هل روسيا ضحية سياسة تقوم على عنجهية أوقعها فيها باراك أوباما من حيث لا يدري؟ يصح طرح مثل هذا السؤال بعد معركة حلب التي لا تزال مستمرّة.
يظهر، اقلّه الى الآن، ان حلب ليست مدينة يمكن احتلالها بسهولة بمجرد وجود ميليشيات شيعية تابعة لإيران مثل «حزب الله» تشارك في الحرب على الشعب السوري من منطلق مذهبي ليس الّا. تساند هذه الميليشيات ما بقي من قوات تابعة للنظام السوري، تتشكل في معظمها من مجموعات من «الشبيحة» الذين يعملون كمرتزقة في خدمة اشخاص مستفيدين من النظام يمتلكون امتيازات كبيرة منذ سنوات طويلة.
اعتقد فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ان سلاح الجوّ الروسي كفيل بقلب المعادلة في حلب، خصوصا في ظلّ حال الارتباك التي تمرّ فيها تركيا. لذلك، نجد الطائرات الروسية تشارك في الحملة على حلب، وهي حملة تشمل دك احياء في المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها بهدف نشر الرعب في صفوف المدنيين خصوصاً. لا فارق بين مدني وعسكري بالنسبة الى الطيار الروسي الذي لا يعرف لماذا يشارك بلده في حرب تستهدف شعباً بكامله. كل ما يبحث هذا الشعب عنه منذ ما يزيد على نصف قرن، أي منذ وصول حزب البعث الى السلطة في العام 1963، تمهيداً لقيام النظام العلوي، هو بعض من كرامة وحرّية.
من بين الحسابات الخاطئة التي قامت بها روسيا الاستخفاف بتركيا واهمّية حلب بالنسبة اليها، وذلك بغض النظر عن من يحكم تركيا. هل من يحكم رجب طيّب اردوغان ام غيره. عندما تجد تركيا انّها مهددة انطلاقا من سورية، من حلب تحديدا، ليس امامها سوى التدخل. نسيت موسكو ان تركيا تدخلت في سورية قبل وصول اردوغان الى السلطة وذلك عندما أجبرت النظام على التخلي عن الزعيم الكردي عبدالله اوجلان أواخر تسعينات القرن الماضي. كان العسكر يتحكمون وقتذاك بالقرار التركي. كان كافيا توجيه انذار الى حافظ الأسد، كي يفهم بشّار الأسد، الذي لم يكن بعد رئيساً، ان لا خيار آخر غير التخلي عن اوجلان بالتي هي احسن...
امّا في ما يخص معركة حلب الدائرة حاليا، فهناك نقطتان فاتتا بوتين ووزير خارجيته. الاولى مدى اهمّية حلب لتركيا والأخرى استعداد الشعب السوري لتقديم التضحيات والقتال حتى آخر رجل وطفل.
وجدت تركيا نفسها، قبل المحاولة الانقلابية الأخيرة على اردوغان، مجبرة على الاعتذار من موسكو. كذلك اعادت تركيا العلاقات مع إسرائيل الى طبيعتها بعدما اكتشفت ان ليس في استطاعتها لعب الورقة الفلسطينية، كما تفعل ايران، على الرغم من الرابط الاخواني القائم بينها وبين «حماس».
لم تكن لدى الروسي، وقبله السوفياتي، حسابات دقيقة في الشرق الاوسط، خصوصاً في سورية. كلّ من راهن على ان حلب لقمة سائغة ارتكب خطأ كبيرا. لا لشيء، سوى لانّ في حلب وحولها آلاف المسلّحين الذين يدافعون عن وجودهم وعن ارضهم. المسألة بالنسبة الى هؤلاء مسألة حياة او موت. لا يريد الروسي، ومعه الايراني، اخذ علم بان هناك رفضا كليا من اهل حلب والمناطق المحيطة بها والقريبة منها للنظام العلوي الذي ارتكب منذ أواخر سبعينات القرن الماضي سلسلة من المجازر في حق هؤلاء تحت ذرائع شتى. كان الهدف دائما تطويع اهل حلب والمناطق المجاورة لها، وصولا الى دير الزور البعيدة عن المدينة. لن ينجح الروسي في ممارسة هذه المهمّة من الجو. لن ينجح الايراني حيث فشل النظام الذي اعتقد في مرحلة معيّنة، بعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، ان اهل حلب تعلموا من تجارب الماضي القريب دروسا في الانصياع لا يمكن ان ينسوها يوماً. ليس الاستخفاف بتركيا واهمية حلب بالنسبة اليها، فضلا عن مدى الجهل بالسوريين، ما أوصل روسيا الى ان تصبح عدوّاً للشعب السوري. هناك عامل في غاية الاهمّية يمكن ان يكون اغرى موسكو في الذهاب بعيدا في مغامرتها السورية والرهان على استغلال نظام الأسد بحثا عن موقع على خريطة الشرق الاوسط. هذا العامل هو العامل الاميركي. اعتبر بوتين، ومعه ايران، ان إدارة أوباما فرصة لن تتكرر. سلّمت هذه الإدارة العراق كلّيا لإيران واعتبرت ان الملف النووي الايراني يختزل كلّ مشاكل الشرق الاوسط. راعت إدارة أوباما الاطماع الايرانية في سورية الى ابعد حدود. تجاهلت ماذا يعني وجود ميليشيات مذهبية تابعة لإيران في سورية ومدى الخطر الذي يمثله «حزب الله»، وهو لواء في «الحرس الثوري» الايراني، على وجود بلد مثل لبنان صار معزولا عن محيطه العربي.
اغرى الاميركي، الروسي. لا شكّ ان نقطة التحوّل كانت في مثل هذه الايّام من العام 2013 عندما استخدم الأسد السلاح الكيميائي في التعاطي مع السوريين. نسي أوباما، وقتذاك، انّه كان وضع «خطا احمر» لرئيس النظام السوري. اقتنع بنصائح بوتين الذي اقترح عليه الاكتفاء بنزع مخزون السلاح الكيميائي السوري وعدم توجيه ضربة عسكرية الى النظام.
مذ ذاك التاريخ، زاد التورط الروسي في سورية وصولا الى إقامة قاعدة في حميميم قرب اللاذقية تستخدم لشنّ غارات على فصائل مسلّحة سورية وعلى مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لابقاء الأسد في دمشق. اذا كان من نتيجة لهذه السياسة الأميركية، فانها تتلخص بدفع الروسي والإيراني الى المزيد من التورط في سورية... وهو تورط ليست إسرائيل بعيدة عنه ما دامت «الخطوط الحمر» التي وضعتها موضع احترام روسي وايراني. وعندما يحصل خرق لأيّ «خط احمر» تضرب إسرائيل ما تعتبره هدفا لها، من دون ان تجد من يردّ عليها.
سهلت إدارة أوباما على بوتين السقوط في المستنقع السوري. لن يفيد في شيء اكتشاف الرئيس الاميركي أخيرا انّ سورية «سببت له الشيب» وانّ لا حرب ناجحة على «داعش» والارهاب من دون التخلص من النظام السوري الذي قارن حصاره لحلب بحصار الجيوش للمدن «في القرون الوسطى».
يبقى سؤال واحد. ماذا سيفعل الرئيس الروسي في حال طرأ تغيير، ولو نسبي، على سياسة أوباما تجاه سورية وذلك خدمة للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون؟
ثمّة مؤشرات الى احتمل حصول تغيير ما في الموقف الاميركي في اتجاه مزيد من التشدّد حيال كلّ ما له علاقة بسورية في الأسابيع القليلة المقبلة.
هل يمتلك بوتين من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بان روسيا، ذات الاقتصاد الهشّ، ليست سوى نمر من ورق؟ كلّ ما تستطيع روسيا عمله، حتّى عندما كان الاتحاد السوفياتي في عزّه، هو التدمير وليس البناء. على من يريد بالفعل دليلا على ذلك، العودة الى التعاطي الروسي مع سورية منذ ما قبل حرب 1967 والكوارث التي أدت اليها وصولا الى السكوت عن كل ممارسات حافظ الأسد في سورية ولبنان، وصولا الى ما نشهده حالياً من تفتيت لسورية نفسها بعدما صارت مستعمرة إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك...
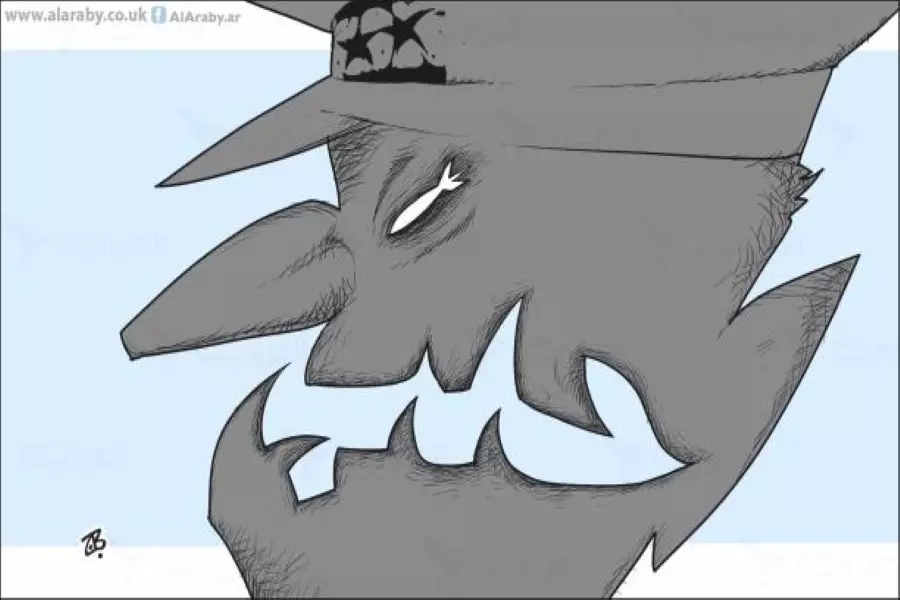 ٧ أغسطس ٢٠١٦
٧ أغسطس ٢٠١٦
منذ انطلاق معركة كسر الحصار على حلب، سال حبر كثير في محاولةٍ لتحليل الأمر، ووضعه في سياق موازين القوى على الأرض، أو في إطار الصراعات الدولية والدخول التركي المفاجئ في مواجهة "التفاهم" الروسي الأميركي. وقيل كلام كثير أيضاً بشأن الوضع الإنساني، وضرورة كسب المعركة لإعادة الروح إلى مئات آلاف المحاصرين في الشهباء، وبطولات هؤلاء التي سطروها في موقعة "الدواليب المحروقة"، وأساطير الصمود في وجه همجية النظام وروسيا العسكرية وبربرية الحصار الذي حرم الأطفال حتى من الحليب.
كلام لا يحمل مبالغات كثيرة، وتحليلات تحتمل في مجملها الصواب، غير أن النظرة الأساس بالنسبة إلى ما هو حاصل في حلب اليوم، وما جرى في الأيام الماضية، هو مصير الثورة السورية نفسها، والآمال التي كانت معقودة عليها خلال السنوات الخمس الماضية. لم يعد خافياً أن ما قبل انطلاق المعركة كانت الأجواء التشاؤمية هي السائدة في المطلق، وأن نهاية الثورة باتت وشيكةً، بناء على التفاهم الروسي الأميركي، وبغطاء أوروبي، والذي كان واضحاً أنه ينص ضمناً على إنهاء الثورة التي أصبحت تشكّل عبئاً على الغرب بالمطلق.
غير أن المعركة قلبت الموازين، وأعادت ترجيح كفة بقاء الثورة السورية، فبغض النظر عن الرايات المتعدّدة التي تقاتل في هذه المعركة، وما إذا كانت فعلياً خارجة من رحم أساس الثورة السورية، إلا أن محصلتها الآن هي الأهم، وهي إبقاء الحالة على قيد الحياة، ومنع النظام وحلفائه من إعلان "انتصار"، كان قريباً، على الثورة ومكوناتها المختلفة.
بهذا المعنى، أعادت معركة حلب ترجيح كفة الثورة السورية، وضخت الآمال مجدّداً بقدرتها على تحقيق إنجازات على الأرض، وهو ما يمكن أن يترجم لاحقاً في الميدان السياسي، والذي كان، إلى حد كبير، خاضعاً لموازين القوى على أرض المعركة، وما كانت تحمله من معطيات تقدم واضح للحلف السوري الروسي الإيراني.
لم تنته معركة حلب بعد، ربما لا تزال في بدايتها، بحسب تقديراتٍ تشير إلى حرب استنزاف طويلة الأمد نسبياً، غير أن الوتيرة التي تسير بها حالياً، وفي حال استمرارها بالزخم والدعم نفسيهما، فإن تبعاتها قد تتجاوز عملية فك الحصار، وتتمدّد إلى المناطق الأخرى التي كانت قد خسرتها المعارضة. قد لا يكون الأمر هيناً، ولا سيما مع سعي النظام وحلفائه إلى محاولة تعديل الكفة، إلا أن الأهم في هذا المجال هو إثبات الفصائل المقاتلة أنها ليست عاجزةً أمام آلة القتل السورية الروسية، وأنها تملك مخزوناً من القدرات القتالية والمعنويات التي تسمح لها بتحقيق تقدم حاسم، متى ما أتيحت لها الفرصة لذلك. والفرصة، هنا، تأتي بمعنى الضوء الأخضر السياسي والدعم اللوجستي من الدول التي لا تزال داعمة للثورة السورية.
المعركة مستمرة، وميادينها ستتوسع. لن تكون فقط عسكرية، فلاحقاً، ومع اقتراب موعد لقاء جنيف، سيكون الميدان السياسي فاعلاً أيضاً، وهو ما قد يحتاج إلى توحيد صفوف حقيقي بين الأطراف السورية المعارضة، السياسية والعسكرية. فالبين لا يزال قائماً بين الشقين، سواء في التمثيل أو تحديد الأولويات. أيضاً هنا الأمر لن يكون على هذا القدر من السهولة، ولا سيما مع اختلاف الرؤى والأيديولوجيات، غير أن فرصة الانتماء المطلق للثورة السورية لا تزال قائمة، ولعله الوقت الأمثل الآن لحصول ذلك، لتبقى كفة الثورة راجحة.
 ٧ أغسطس ٢٠١٦
٧ أغسطس ٢٠١٦
أنجز الثوار السوريون، في الأيام القليلة الماضية، اختراقاتٍ نوعية في كسر الطوق العسكري الذي فرضه النظام السوري وحلفاؤه على مساحةٍ واسعةٍ من حلب، في محاولةٍ لإخضاع المدنيين والثوار، وإجبارهم على الاستسلام والمغادرة من المدينة، كما حدث في مناطق أخرى عديدة سابقاً. لكن الثوّار، بمساندةٍ استثنائيةٍ من المدنيين، صمدوا صموداً أسطورياً، وجعلوا من حلب بمثابة ستالينغراد، لكن بصورة مقلوبة، فالروس هم الغازون مع نازيي النظام السوري، بينما المعارضة المحاصرة هي التي قلبت المعادلة، وتسعى إلى جعل حلب "نقطة تحوّل"، معاكسة تماماً لما كان يريده النظام السوري والروس والإيرانيون، في ظل تواطؤ حقيقي من الغرب والولايات المتحدة معهم.
المهم في معركة حلب التي تدور حالياً أنّها كسرت التوقعات الدولية والإقليمية، وتجاوزت المعارضة ذاتها وتفوقت على نفسها، بعدما أدار لها العالم ظهر المجنّ، فأعادت خلط الأوراق الدولية والإقليمية مرّة أخرى.
الأكثر أهميةً في التغيّرات الأخيرة هو الموقف التركي، وتحديداً بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وإرهاصات ذلك التحول التي سبقت تلك المحاولة، وارتبطت بمحاولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فك الحصار السياسي والديبلوماسي غير المعلن الذي تتعرّض له تركيا.
لم يكن النظام السوري، بإسنادٍ روسي وإيراني مكثّف، لينجح في حصار حلب، ومحاولة إجبار المعارضة على الاستسلام هناك، لو كان الموقف التركي متماسكاً في دعمه المعارضة هناك. لكن موقف أردوغان بعد الانقلاب (كما ذكرنا في مقالة سابقة) أصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً، فالأولوية له داخلية، وهو بحاجة لإصلاح علاقته مع الروس والإيرانيين، بعدما اكتشف هشاشة علاقته بالعالم العربي من جهة، ومراوغة الولايات المتحدة وأوروبا معه من ناحية ثانية.
نظرياً التغير في الموقف التركي حاسم، بالنسبة للمعارضة، فهي الداعم الأكبر للفصائل الشمالية، وساعدت تركيا دوماً هذه الفصائل في التسلح والتنسيق والدعم، وكان للتحالف التركي- السعودي دور مهم في تأسيس جيش الفتح (قبل قرابة عامين) في ريف إدلب، الذي قلب المعادلة هناك تماماً، ووصل إلى ريف اللاذقية، وحرّر مدينة إدلب بالكامل.
لذلك، حاول النظام السوري، بدعمٍ روسي، الاستثمار في تحول الموقف التركي للسيطرة على عاصمة المعارضة، حلب، وتحقيق اختراقاتٍ كبيرةٍ في المناطق الشمالية، وتغيير موازين القوى جذرياً، مع وجود ضوء أخضر أميركي- أوروبي ضمني، بعد التحولات غير المعلنة رسمياً وديبلوماسياً، لكنها واضحة سياسياً، في مواقف المجتمع الدولي الذي لم يعد يفكّر البتة بمصير الأسد، بقدر ما ينشغل في التفكير بالتخلص من داعش، ولا يشعر بالارتياح تجاه الصبغة الإسلامية للمعارضة السورية المسلحة.
العالم أصبح أقرب إلى نظام الأسد اليوم، والشكر موصول لداعش، بالطبع، لكنه لم يكن في أي وقت مخلصاً وصادقاً مع الثورة السورية، ونذكر تماماً محطاتٍ فاصلة، كان يمكن أن تكون نهاية نظام الأسد فيها، لكن الخشية المزيفة من نظام ما بعد الأسد هي التي عطلت سقوطه أكثر من مرة.
النظام الرسمي العربي هو أيضاً أقرب اليوم من أي وقت مضى للأسد، فمصر والجزائر رسمياً معه، وموقف الإمارات والأردن أكثر تعقيداً والتباساً، ولكن بات واضحاً أن أولويتهما القضاء على داعش، من دون الاكتراث بمصير الأسد، وتبقى السعودية وقطر تحاولان التأكيد على أن المشكلة الحقيقية هي في النظام السوري، لكن دورهما تراجع أخيراً، وبدأت الخلافات بينهما وبين المجتمع الغربي بالظهور، مع محاولة اتهامهما مع تركيا بتمويل المعارضة الإسلامية.
الآن، وهنا بيت القصيد، تجد المعارضة، للمرة الأولى، نفسها مكشوفة إقليمياً ودولياً، بصورة كاملة، بلا أي سند أو مساعدة أو غطاء، ولو حتى سياسي يُذكر، لكنها على الرغم من ذلك استطاعت إغلاق جزءٍ كبير من خلافاتها وانقساماتها الأيديولوجية والعسكرية في الداخل، وتوحّدت في معركة حلب، وتمكّنت من إعطاب التوقعات الدولية الإقليمية، وإذا ما تمكّنت من إفشال المخطط الروسي السوري في حلب، فسنكون أمام معادلةٍ جديدة موضوعية، تعني استقلالية أكبر للثورة، ودحض النظريات الروسية والغربية بأنها امتداد لأجنداتٍ إقليمية، بينما الواقع أن النظام السوري نفسه تحول إلى مجرد ورقة على طاولة الروس والإيرانيين.
تبقى معادلة المنطقة الجنوبية الأكثر حساسية، نظراً لارتباطها بغرفة العمليات العسكرية العربية والأميركية والفرنسية (الموك)، لكن التغير في معادلة حلب قد يفتح شهية ثوار درعا لتفكير مماثل.
 ٧ أغسطس ٢٠١٦
٧ أغسطس ٢٠١٦
من المقدّر لمعركة حلب، الجارية منذ عدة أيام، أن تطول أكثر مما كان متوقعاً لها من قبل، وأن تكون باهظة الكلفة إلى درجة مرتفعة، وربما سيتم تسجيل هذه الملحمة كأهم المعارك في تاريخ الثورة السورية (إلى الآن على الأقل)، نظراً لما تحتشد على ساحتها الواسعة من قوىً مدجّجة بالإرادات المتصادمة، والادعاءات المتناقضة، ناهيك عن كل صنوف الأسلحة المتاحة، وفوق ذلك ما يُعلّق عليها من رهاناتٍ كبرى، ليس فقط لدى المتقاتلين على الأرض مباشرة، وإنما لدى الأطراف الإقليمية والدولية، المشتبكة في ميدان صراع مفتوح، أوسع نطاقاً من رقعة حلب وجغرافيا البلاد الشامية.
وبقدر ما تصحّ تسمية معركة حلب معركة استراتيجية، لكلا الطرفين المتجابهين حتى نهاية الشوط المديد، بقدر ما تصحّ معه تسميتها، أيضاً، مصيرية، سواء أكان ذلك لنظام الأسد، أو بالنسبة للثورة التي عبرت إلى عامها السادس، وهي تواجه تحالفاً إقليمياً من طبيعةٍ مذهبية فجة، يعمل تحت غطاء جوي لإحدى أكبر القوى العسكرية في العالم، الأمر الذي أثقل كثيراً على كاهل الثورة، وعقد المشهد المعقد أصلاً، وزاد من وزن العوامل الخارجية المقرّرة في توجيه دفة الحرب المتصاعدة، على نحوٍ كادت فيه كل هذه المتغيّرات أن تهمّش العامل الذاتي إلى أدنى درجة ممكنة.
من هنا، تنبع الأهمية الاستثنائية لمعركة حلب الطاحنة، باعتبارها بمثابة رد اعتبار لعنصر العامل الذاتي الذي استعاد، بهذه المعركة، تموضعه السابق، لاعباً مركزياً، له القول الفصل في إدارة وقائع الحرب، وفي توجيهها بما يحفظ إدامة فعل الثورة، سجالاً بين مدّ وجزر، إلى أن يتم تعديل موازين القوة، وجلاء الصورة، ومن ثمة كسر قواعد اللعبة المستجدّة، في وقت لاحق، وهو ما تستبطنه فصول هذه المعركة التي تبدو، في نظر أصحابها، ووتيرة تصاعدها، نقطة تحولٍ لافتة، انتقلت معها الثورة من حيّز الدفاع عن النفس إلى موقع المبادرة الهجومية. ذلك أن انعكاسات هذه المعركة، الجارية في أكبر الحواضر الشامية، على حاضر ثورة الحرية والكرامة ومستقبلها، بما في ذلك مردوداتها المتوقعة على الحاضنة الشعبية في المدى المنظور، تتجاوز كل النتائج الميدانية المرجوّة في نهاية المطاف، إلى التحليق بالثورة في فضاء الحالة المعنوية، بما تؤدي إليه هذه الحالة من رفعٍ للروح القتالية، وتجديدٍ لشباب الثورة، وإطلاقٍ لطاقاتٍ كامنة، لعل في مقدمتها توحيد الفصائل المسلحة على قاعدة الحد الأدنى المشترك، وطي صفحة الخلافات البينية، التي كادت أن تعصف بكل ما تحقق من نتائج طيبة في السنوات الخمس الماضية.
وكما أدى دخول حلب المتأخر إلى معمعان الثورة، إلى إطلاق المارد من قمقمه، وحوّل الاحتجاجات الشعبية الريفية إلى تمردٍ شعبي شامل، فإن انتفاضة الشهباء على نفسها أولاً، وتحطيمها قانون لعبة الحصار الجهنمية ثانياً، ورفض السابقة الحمصية ثالثاً، من شأنه كسر عنق الزجاجة مرة أخرى، وإيجاد قوة زخمٍ مضاعفة، فضلاً عن منح الثورة دماً جديداً، هي في أمسّ الحاجة إليه، بعد أن أصاب صفوف المقاتلين ما أصابهم من مظاهر ترهّل، وما مالت إليه بعض الفصائل، تحت ضغط الواقع المرير، من هدنٍ ومصالحاتٍ موضعية مهينة.
بكلام آخر، غيّرت حلب موازين الوضع الداخلي، عندما التحق ريفها، وبعد ذلك المدينة نفسها، بصفوف الثورة، حيث وضعت النظام المتهالك آنذاك في أصعب امتحان له منذ خروج أول مظاهرة في درعا، وها هي اليوم تكتب بدمها فصلاً ملحمياً في كتاب الثورة التي بدّلت الوضع السوري، كما لم يتبدّل في السابق، الأمر الذي من المتوقع معه أن تعيد هذه المعركة تصحيح اتجاه البوصلة من جديد، وأن تجبر صورة ما انكسر في مرآة الثورة، وبالتالي، من المؤكّد، والحالة هذه، أن ما بعد معركة حلب لن يكون كما كان قبلها.
وعليه، يصحّ النظر إلى معركة حلب على أنها، في حد ذاتها، أكبر من مجرد معركة كبيرة، تقاس فيها النتائج وفق معايير الحرب الكلاسيكية، حيث ترتسم على ساحتها خطوطٌ حمراءُ متقابلة، وتجري في نطاقها لعبة مصالح متعاكسة، وتتجلى على أديمها مظاهر نفوذ إقليمية ودولية متوازية، الأمر الذي يجوز فيه القول إن معركة حلب كاسرة للتوازنات والمعادلات، وإنها قد تقرّر المآل الأخير، وربما المصير النهائي، سواء للنظام المحارب بالمليشيات الطائفية، أو للثورة المحاربة بسيوف نحو مائة ألفٍ من مقاتليها.
وليس من المبالغة القول إن على نتائج معركة حلب الدائرة في إطار أوسع من رقعة المدينة، كما سبق ذكره، سيتوقف مستقبل هذه المنطقة التي تتحارب فيها كل الملل والنحل والأعراق، وتتقابل فيها الهواجس، لتقرير الأحجام والأوزان، ورسم الخطوط الحمر، وتحديد مطارح النفوذ والمصالح، الأمر الذي يثقل بشدة على أكتاف صانعي هذه الملحمة، ويرقى بهم إلى منزلة من حققوا نقطة تحوّل، صنعوا تاريخاً، كثيراً ما كانت فيه مدينةٌ بعينها تنوب عن الأمة، وفق ما ترويه لنا كتب التاريخ القديم، في زمن الغزو المغولي، وسنين الحروب الصليبية، وعهد الاستعمار الأوروبي.
وأحسب أن معركة حلب، المثيرة بكل المعايير، موقعةٌ كبرى كاشفة نيات الدولة العظمى الملتبسة، ومقوّضة معايير روسيا المزدوجة، وفاضحة حسابات الدول الإقليمية الصديقة واصطفافاتها اللفظية مع الثورة، خصوصاً الدول التي انشغل بعضها بهمومه الداخلية فجأة، وبعضها الآخر بأولويات مستجدّة، إلا أن النقطة المضيئة أكثر من غيرها، في خضم هذه المعركة الطويلة بالضرورة الموضوعية، تظل ماثلةً في حقيقة أنها ستدوّن في سفر الخلود ملحمةً، وأنها أحدثت رافعةً كبرى من روافع الثورة اليتيمة، وأنها عبرت بها من عنق الزجاجة التي راوح فيها المقاتلون طويلاً، وكادوا يفقدون زمام المبادرة.
 ٧ أغسطس ٢٠١٦
٧ أغسطس ٢٠١٦
كانت حصيلة شهر تموز من القصف على مدينة داريا كافية لخراب دول
فعدد البراميل يقارب ال 600 برميل متفجر وهو ما يزن 250 كغ إلى 300 كغ من المواد المتفجرة
طبعا عدا عن أكثر من 200 صاروخ أرض أرض نوع فيل شديد التدمير
ومئات بل آلالاف القذائف المدفعية من الجبال المحيطة بالمدينة
وكل ذلك يتجدد في شهر آب في ذكرى عملية لهيب داريا التي كانت من أكبر العمليات التي قامت بها الثوار في المدينة
وكل هذا القصف غطاء لتجدد قوات الأسد والميليشيات الموالية لها عملياتها العسكرية المكثفة على المدينة
مدعمة بالدبابات والآليات والكاسحات وعربات الشيلكا
نعم بعد كل هذا يتقدم النظام في داريا ويتراجع المجاهدون لأنهم لا يملكون ما يدمرون أو يعطبون بهد دبابة عادية فكيف بتلك الدبابة عالية التصفيح وعالية الحداثة
المجاهدون يملكون بعضا من طلقات ويقاتلون بها حتى آخر رمق وآخر لفظة روح
نعم مجاهدو داريا لديهم قليل من سلاح ولكنهم يمتلكون كثيرا من إيمان راسخ وعقيدة ثابتة ومبادئ لا تتزعزع وهمة لا تلين
كيف تلين تلك الهمة ؟ والمجاهد منهم أصبح لديه 4 سنوات من الجهاد والصبر والمصابرة على كل ما أصابه واعتراه من آلام
المجاهدون في داريا جزء من مجاهدي سوريا يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم فمن يراهم يوم فك حصار حلب يقول وكأن حلب لهم وقد فك عنهم الحصار مع دمعات في عيونهم ترمق نصرا ابتعد عنهم وخذلانا احاط بهم
نعم المجاهدون في المدينة أعتقد أن لا بواكي لهم فكم وكم ناشدوا الجبهات النائمة ولا مجيب ولا من سامع للصوت كم استنصروا وكم صرخوا، وكم نادوا أن نحن إخوانكم لا تتركونا ، برابطة الدين، والعقيدة برابطة الثورة، وبعد كل ذاك لايرى إلا العجز والخذلان إذا أردت أن تسأل عن معنى الخذلان فأسأل أهل داريا وثوارها
نعم بعد ذلك يرفع مجاهد يديه إلى السماء رغم مشاعر العجز التي تحيط به، داعياً مولاه بما دعى يوما صلاح الدين الأيوبي أن يا رب انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبقى لنا إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك أنت حسبنا ونعم الوكيل
ذلك هو الأمل الأمل بالخالق والتعلق به وعدم الطلب من غيره
ولكن هي كلمة نوجهها لأخوتنا في الغوطة الغربية وحوران أن لا تستكينوا ول اتركنوا لعدوكم فو الله لستم في مأمن منه فتحركوا ليس من أجل داريا إنما من أجل أنفسكم ومن أجل أهاليكم من أجل أن لا تضيع الكرامة التي تفجرت شرارتها من عندكم
ولأخوتي في داريا أقول لا تستكينوا يائسين إنما هي نكبة من بعدها البسمات
الله أسأل يوما كيوم حلب وإدلب في داريا ونهضة ثورية في حوران والحمد لله رب العالمين .
 ٦ أغسطس ٢٠١٦
٦ أغسطس ٢٠١٦
يقف السوريون اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما حرب تستمر بين كل الأطراف المتصارعة على سورية وداخلها، أو خيار تتوافق عليه القوى الكبرى، يوقف الإمداد للقوى المتحاربة، وينهي الصراع المسلّح، وفي كلا الأمرين يبدو العامل السوري مهمشاً إن لم يكن غائباً تماماً عن التفاهمات الدولية وعن طاولة المفاوضات التي تعقد هنا أو هناك بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وتحت غطاء أممي في بعض الأحيان.
واضح أننا إزاء خيارين لا يتناسبان مع تضحيات الشعب السوري وطموحاته. فالسيناريو الأول الذي يقوم على استمرارية الصراع، يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والمزيد من الخراب في الدولة والمجتمع السوريين، وهذا أمر لا يبالي به النظام، الذي أشهر منذ البداية شعار: «سورية الأسد أو نحرق البلد»، وقد ترجم ذلك عملياً بتحويله معظم مدن سورية إلى حقل رماية لبراميله المتفجرة وصواريخه ومدفعيته، وبتشريده ملايين السوريين، فضلاً عن فتحه البلد على مصراعيه أمام نفوذ نظام إيران والميليشيات اللبنانية والعراقية التابعة له، وأمام الوجود العسكري الروسي.
أما الذين ينادون باستمرار الصراع بالوسائل العسكرية، من المعارضة، فهم يتذرّعون باعتبارهم أن كل الخسائر المترتبة على هذا الخيار قد دفعت، وأن مزيداً من الضحايا مقابل انتزاع السلطة من نظام يقتل شعبه هو أقل ما يجب عمله، للرد على أي مساومة تتحدث عن إعادة إحياء نظام الأسد. ولنقل إن الشعب السوري ربما يتقبّل مثل هذا الطرح عندما تقدمه قوى فاعلة على الأرض تذود عن خيارها النضالي بأرواحها وأرواح عائلاتها قبل الآخرين، لكن ما يحدث يبيّن أن معظم المتحدثين هم خارج الأراضي السورية ويعيشون في أمان مع عائلاتهم، والحديث عن تضحياتهم حتى آخر طفل يبقى مجرد شعار يساوي شعار النظام الذي يزجّ بأبنائنا في حرب مجنونة دمرت سورية مدناً وشعباً ومستقبلاً. والأهم، أن الذين ينادون باستمرار الحرب حتى آخر طفل هم طبعاً غير قادرين على مدّ المعارضة المسلحة بالمال والسلاح اللذين يمكنانها من الصمود أمام آليات النظام والقوى العظمى المساندة له بسلاحها الجوي وقوة قرارها الدولي.
على ذلك، فإن السيناريو الأول يتلخّص باستمرار الواقع الراهن، أي استمرار التصارع على سورية، بين القوى الدولية والإقليمية والمحلية، وتالياً استمرار حال القصف والقتل والحصار والتشريد، والإبقاء على صيغة لا غالب ولا مغلوب، بعدم السماح لأي طرف بالغلبة على الطرف الآخر. ولا شك في أن هذا السيناريو من شأنه إطالة عذابات السوريين، وتفاقم حال الخراب للدولة والمجتمع في سورية، ومزيد من الاستقطاب الطائفي، والتغييرات الديموغرافية فيهاً. أيضاً هذا السيناريو يصب في مصلحة القوى الدولية والإقليمية التي تسعى إلى خراب المشرق العربي أو لا تبالي به، لا سيما في أهم بلدين فيه، أي سورية والعراق، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى خدمة إسرائيل. إذ لا شك هنا في أن إسرائيل هي المستفيدة من استمرار هذا الخيار، وهذا ما يفسر موقف الولايات المتحدة، اللامبالي واللامسوؤل مما يجري.
أما السيناريو الآخر والمتوقع من الدول الكبرى ومن مجموعة دول أصدقاء الشعب السوري، التي ثبت عجزها عن أي فعل حقيقي لمصلحة الثورة، فيتمثل بوجود نوع من توافق على الحل في سورية. لكن يجب أن يدخل في علمنا، أن الولايات المتحدة الأميركية، من موقع مكانتها العالمية وقدراتها وتأثيرها، هي التي ستحسم لحظة الوصول إلى هذا الحل وشكله، مع إشراكها هذا الطرف او ذاك وفق حجمه ودوره ومكانته. لذا، فإن التسريبات عن نضوج توافق أميركي ـ روسي في خصوص سورية، تؤكد مجدداً أن تقرير وضع النظام السوري ومصير السوريين بات في أيدي القوى الخارجية الدولية والإقليمية، وأن ملف سورية بات في يد روسيا على حساب إيران، وذلك باعتراف الولايات المتحدة، أي أن ذلك سيفضي إلى تحجيم مكانة إيران في سورية، وتقزيم دورها في تقرير مصير هذا البلد، وربما نشوء نوع من التباين بينها وبين الطرف الروسي، على هذه الخلفية.
مع ذلك، يجدر الانتباه الى أن تحقّق هذا الخيار قد يتم فرضه بالطرق السياسية أو بواسطة القوة العسكرية، أو بدمج الوسيلتين معاً، لا سيما إذا ظهرت قوة معينة، مع النظام أو مع المعارضة، تحاول عرقلة هذا الحل.
إزاء هذين الخيارين اللذين لا يتناسبان مع تضحيات معظم السوريين وطموحاتهم، يفترض بقوى المعارضة السورية وبمختلف تسمياتها ومنابتها ومكوناتها، سواء جاءت بقرار خارجي أو شعبي، أن تواجه التداعيات والتحديات التي يفرضها كل سيناريو على مصير سورية وشعبها، وأن تبذل طاقتها وجهودها لتوسيع دائرة حضورها وتعزيز مكانتها في إطار أي خيار.
هكذا أود القول هنا بوجود، أو بوجوب إيجاد، خط ثالث أو طريق ثالث للمعارضة السورية، هذا إن أدركت في شكل صحيح مكانتها ودورها، وإن قررت حسم أمرها، من دون أي ارتهان سوى لطموحات شعب سورية. أي أن هذا يتطلب أن تسأل المعارضة نفسها الأسئلة الواجبة والحقيقية، وأن تجيب عنها بكل وضوح وصراحة. مثلاً، عليها أن تراجع نفسها إذا كانت نجحت في النهج الذي سارت عليه طوال السنوات الماضية، وإذا كانت بكياناتها وتشكيلاتها الحالية قادرة على الاستمرار وتحمّل تداعيات استمرار الصراع، وأن تفكر بكيفية ردم الفجوة التي بينها وبين شعبها.
هذا يعني أن المعارضة ستواجه في كلا الخيارين تحديات وتعقيدات ومداخلات جمة، فالخيار الأول يؤكد أن المعارضة ما زالت في البدايات، فهي لم تهزم النظام، ولم تحجّم دور القوى الدخيلة، وهي ما زالت في حاجة الى توضيح نفسها، أمام شعبها وأمام العالم، واستدراج جميع طلبات الدعم للوضع السوري. أما المطلوب من المعارضة وفق الخيار الثاني، فيتعلق بتعزيز مكانتها كممثل للسوريين، ولمجمل طموحاتهم، وفوق ذلك فهي مطالبة باستثمار المداخلات الخارجية، كقوة مضافة لها، من أجل الضغط على النظام وحلفائه لوقف القصف والقتل والتشريد، ومن أجل الوصول إلى هيئة الحكم الانتقالية، وفق بيان جنيف 1، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهنا عليها أن تقدم نفسها، وعبر الحكومة الموقتة، كبديل للسلطة في المناطق المحررة، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه حتى الآن.
لذا، إذا لم يتم التوجه نحو طريق ثالث، أي إذا تعذر على المعارضة مراجعة تجربتها، ونقد طريقها، واستنهاض أوضاعها، وتطوير كياناتها السياسية والعسكرية والمدنية، على أسس جديدة، وخطابات واضحة وجامعة، فإننا سنجد أنفسنا أمام طريقين فقط يطيلان عذابات السوريين، ويبددان تضحياتهم.
وفي مواجهة مع الذات، أخشى أننا بعد أحداث معركة حلب أخيراً، التي يبدو أنها كشفت ليس غطاء وجه الجولاني أمير «جبهة النصرة» فحسب، بل ووجه التوافقات الدولية بمجملها، أننا كسوريين وكمعارضة وكنظام بتنا أمام خيارين: إما استمرار موتنا تحت مسميات المعارك المدعومة دولياً أو الاعتراف بهزيمة كلا الطرفين عن تحقيق هدف معركتهما، والتوجه إلى طاولة مفاوضات قد تنقذ بقايا مما نعرفه من سورية. هذا مع تأكيدي أن معركة حلب أثبتت مخزون الصمود والتضحية العاليين عند شعبنا، ما يعني أن المعارضة مطالبة بترجمة ذلك بتطوير أوضاعها باتجاه الطريق الذي سبق أن ذكرته، بدل الاستسلام للخيارين السابقين.
 ٦ أغسطس ٢٠١٦
٦ أغسطس ٢٠١٦
التقى المحاصرون بالمحررين مانحين الحياة من جديد لأكثر من ٣٠٠ ألف مدني كانوا مهددين بالابادة ، في مشهد ينفض الغبار ع قلوبنا التي انهكها القتل و الدم طوال الشهور الماضية ، لنستعيد بعضاً من الفرحة التي لا تكتمل إلا و أن يتحقق الكامل ، و إن كان نصر اليوم هو بمثابة نصر نهائي للثورة .
و عادت حلب من جديد إلى الحرية بعد حبس استمر قرابة العشرين يوماً ، بعد أن وصلت أيدي الثوار المحاصرين مع أولئك الذين أتوا من بين خضاب الموت ، متجاوزين كل الصعاب بغية هدف هو الأسمى العد التنازلي على اعادة حلب للتحليق في أجواء الحرية بعد تقليص المسافات و انهاء البعد و فتح نوافذ الحرية .
الأيام القليلة الماضية التي عشنا فيها أسعد أيام الثورة ، و عدنا فيها إلى زمن الانتصارات الذي ظننا أنه ولّى إلى غير رجعة ، و لكن بمعركة تاريخية استعادت الثورة هيبتها بطريقة تجعلها لن تقف من جديد إلا و كسر القوات التي أتت من كل حدب و صوب لهدم همم السوريين و ترضيخهم .
أيام ست من القتال المتواصل الذي تطلب عمل جماعي كامل و منظم و منسق لم تشهد الثورة السورية طوال سنواتها الخمس الماضية مثله، و لكن اليوم حجم الهدف و أهميته كان كافياً لأن يكون الجميع معاً صفاً واحداً متناسقاً منظماً مبرمجاً، يزحف تارة و يهرول في مرات أخر، حتى أزال أساطيراً كانت في الماضي عبارة عن الموت بذاته الذي لا يمكن التخيل أنه سيغيب.
ايران سبق و أن تعهدت باحتلال حلب و لو كلفها مئة ألف قتيل ، و حزب الله الإرهابي توّعد بارسال أعتى القوات و غالبيتها إلى هناك لتدمير همم الثوار ، والأسد الذي رغِب بإن تكون حلب بوابة عودته كحاكم معترف به على جثامين مئات آلاف الشهداء ، أما روسيا التي تبحث عن عودة إلى الساحة الدولية من خلال "ستالين غراد " سوريا ألا وهي حلب ، و حتى التحالف الدولي و الولايات المتحدة الأمريكية كان لهم إرادة في نجاح كل من ذكرتهم آنفاً، حتى يكون الشعب السوري راكعاً أمام خططهم و صاغراً في مواجهة التنفيذ، فكل ذلك زال بمجرد أن التقى الجمعان في منطقة صغيرة لينطلقل كاسرين كل الارادات التي تخالف ارداة الشعب .
اليوم حلب لم يُكسر طوق الموت عنها وحدها ، و إنما كسر كل ما يحيط برقاب ملايين السوريين ، و يَكسر خطط الارضاخ ، وكذلك مشاعر اليأس ، و يدمل جروح النفوس ، ففي حلب الآن تصنع سوريا من جديد ، بسواعد أبنائها و ثوارها و مجاهديها .
 ٥ أغسطس ٢٠١٦
٥ أغسطس ٢٠١٦
يحق للسوريين أن يعتبروا معارك فك الحصار عن حلب ملحمة كبرى، لأن الذين يحاصرون حلب هم محتلون جاؤوا من إيران ومن ميليشيات طائفية من «حزب الله» ومن العراق والأفغان فضلاً عن الاحتلال الروسي، وليس لقوات النظام السوري سوى دور لوجستي بسيط، تساعد فيه المحتلين على إحكام حصارهم لحلب، ولجعل ثلاثمئة ألف سوري من المدنيين أسرى بيد المحتلين الذين رأينا ما يفعلون بالمحاصرين في مضايا والمعضمية وغوطة دمشق حيث مات المئات جوعاً ومرضاً، وكان على العالم كله أن يبذل جهوداً ضخمة لإدخال حليب للأطفال وأدوية للمرضى. ونذكر أن الجهود الأممية لم تفلح في داريا بأكثر من الموافقة على إدخال الفلافل وتم بيعها من قبل شبيحة الحواجز للمحاصرين جوعاً. ولقد كان إعلان وزير الدفاع الروسي عن ممرات إنسانية تأكيداً أنه لا دور للنظام السوري فيه، ولذلك لم يُسمح لوزير الدفاع السوري بأن يصرح بشيء يتعلق بمجريات الحصار، وهذا ما جعل السوريين يرون فك الحصار بداية حرب تحرير من الروس والإيرانيين ومن الميليشيات التابعة لإيران، وقد ظهرت دعوات شعبية تطالب المعارضة الوطنية بإلغاء تسمية «مسلحي المعارضة» وإعلان اسم جديد هو «المقاومة السورية».
وهنا يبدو الخلل الاستراتيجي في الرؤية الروسية التي وقفت إلى جانب نظام راحل بدل أن تقف مع شعب باقٍ هو الذي يضمن لها مصالحها، ولو أن الروس تركوا الصراع يدور بين السوريين وحدهم -نظاماً ومعارضة- لكان الوصول إلى الحل السياسي أسهل، حيث يكفي أن يبتعد الأسد عن كرسي الحكم هو وثلة من أركانه ممن تسببوا بدمار سوريا عبر حلهم الأمني والعسكري الذي ظنوه حاسماً فإذا هو يدمر الجميع (وقد حذرنا النظام من حماقة هذا الحل قبل الواقعة فلم يصغِ أحد، وقد أخذتهم العزة بالإثم) ولكن روسيا تمسكت بالأسد لتفرضه على السوريين قهراً، بينما تمسكت المعارضة ببقاء الدولة ومؤسساتها فقبلت بمشاركة مع النظام في حل وسط، سماه المجتمع الدولي «بيان جنيف» ورسمت طريقه قرارات الأمم المتحدة عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، وتضم هذه الهيئة المقترحة ممثلين عن النظام، وممثلين عن المعارضة، وممثلين عن الجهات المستقلة والتكنوقراط، وتكون هذه الهيئة ذات صفة تنفيذية بالإضافة إلى مهمة تشريعية هي إصدار الإعلان الدستوري. كما تكون مسؤولة عن تشكيل مجلس عسكري يضم إلى الجيش النظامي، الضباط المنشقين وممثلين عن الفصائل العسكرية المعارضة الوطنية، وهذا المجلس يقوم بإعادة الهيكلة، كما تقوم الهيئة بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، وبتشكيل حكومة، وتدعو إلى مؤتمر وطني شامل، يتولى مسؤوليات المستقبل، وتعد جمعية مختصة منه دستوراً جديداً للبلاد، يُعرض على الشعب في استفتاء برقابة دولية، وفي الوقت ذاته تقوم الهيئة بالدعوة إلى انتخاب برلمان جديد، تنجم عنه حكومة جديدة. وأما العقد الاجتماعي الجديد فيقوم على أساس المواطنة في دولة مدنية ديموقراطية.
ولم يكن رفض النظام لـ«بيان جنيف» وقرارات الأمم المتحدة مفاجئاً، فالنظام يبحث عن ضمان بقاء الأسد رئيساً، بينما تبحث المعارضة الوطنية عن بقاء سوريا ودولتها على قيد الحياة، وتدرك أن بقاء الأسد سيعني استمرار الصراع وتصاعده، ولن يكون معقولاً أن يقود الأسد المرحلة الانتقالية، وأن تقدم هيئة الحكم الانتقالي له الطاعة وهو المسؤول الأول عن الفاجعة السورية وعن قتل مليون مواطن واعتقال مئات الآلاف وقتل العدد الأكبر منهم تحت التعذيب، وهو المسؤول عن تشريد ملايين السوريين وهدم منازلهم بالطائرات والبراميل التي دمرت سوريا، والقبول ببقائه يمنحه فرصة التنكيل بكل من عارضوه، والانتقام من الشعب الذي خرج عن طاعته.
وقد اختار الأسد الحسم العسكري رافضاً بخطاب علني «هيئة الحكم الانتقالي»، وجاء حصار حلب انتصاراً هلّل له شبيحة النظام بوصفه فاتحة لحصار إدلب، وإنهاء للمعارضة الوطنية بذريعة مكافحة الإرهاب، وكانت الخطة التي حددت في بداية أغسطس 2016 أن ينتهي حلفاء الأسد من إحكام السيطرة على المعارضة العسكرية ومن ثم يدعون هيئة التفاوض إلى جنيف وقد فقدت كل قواها.
ومن هنا تأتي أهمية فك الحصار عن حلب، وقد بدت مهمة مركبة، فهي القادرة على إعادة التوازن، وهي القادرة على تحرير حلب من قبضة الاحتلال الثلاثي (روسيا وإيران والميليشيات الطائفية) وسيكون تحرير حلب إن شاء الله مصدر قوة في الحفاظ على حقوق الشعب الذي قدم ملحمة العصر من أجل كرامته وحريته.
 ٥ أغسطس ٢٠١٦
٥ أغسطس ٢٠١٦
هناك تجربتان ثوريتان عرفهما تاريخ العرب الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين، الجزائرية والفلسطينية. وهناك، منذ نيف وخمسة أعوام، ثالثة هي السورية، والتي سألقي بعض الأضواء عليها، بمقارنتها مع تلكما التجربتين.
اعتمدت ثورة الجزائر، التي أطلقتها وقادتها جبهة التحرير الوطني، عام 1954، المركزية الصارمة في تنظيماتها وآليات عملها وعلاقاتها بالمنضوين فيها، على الرغم من أنه سبقتها تجربةٌ حزبيةٌ ونقابية متنوعة ومهمة، أدى فشلها في نيل الاستقلال لبلادها إلى تبني الكفاح المسلح سبيلاً للتحرير، ولاستعادة الدولة الوطنية السيدة والحرة والمستقلة، بعد مضي أكثر من قرن على اختفائها بعد سقوطها تحت الاستعمار الفرنسي الذي ما لبث أن اعتبر الجزائر جزءاً من فرنسا، يقع على شاطئ المتوسط الجنوبي، وعمل على دمجها دمجاً لا فكاك منه داخل جسدية الدولة الفرنسية السياسية والإدارية التي رفضت دوماً مطالبة السكان بالاستقلال، وقمعتهم كعصاة ومتمردّين على الشرعية، ضاربة عرض الحائط باختلاف هويتهم عن هويتها، وتاريخهم الذي عرف فترة من الاستقلال النسبي نيفاً وعشرة قرون، كان فيها جزءاً من الإمبراطورية العربية/ الإسلامية.
كانت المركزية حاجةً حتمتها حرب العصابات الشعبية، ورداً سياسياً وتنظيمياً على الانتماءات الدنيا، الحزبية والجهوية التي تفرّق صفوف الجزائريين، وبداية حقبةٍ من السياسة الوطنية، يجب أن تتحد فيها قدرات الشعب وطاقاته إلى أقصى درجة ممكنة، وأن تواجه المستعمر بكامل زخمها وقوتها، بما أنه ليس من الجائز، لتناقض الشعب العدائي معه، أن يعرف أي تهاون، كما لا يجوز السماح له بفتح أية ثغرة في جسد الثورة، انطلاقاً من خلافاتٍ قد تحدث فيها. من أجل الوحدة، وضعت الثورة قيادتها بين أيدي رجال زودتهم بذراعين تنفيذيين: عسكري وسياسي، اتبعتهما اتباعاً مطلقاً بها، ضم الثاني منهما رجالاً من الوسط السياسي، أشهرهم عبان رمضان وعباس فرحات ويوسف بن خده، من دون أن تتخلى عن حقها في القرار. وحين جرت المفاوضات مع الفرنسيين حول استقلال الجزائر، تولى قادتها أنفسهم عملية التفاوض .
قامت الثورة الفلسطينية على تنوع تنظيمي واسع، فقد ضمت طيفاً واسعاً من أحزاب وطنية وقومية وإسلامية ويسارية وليبرالية المنشأ أو التوجه، بنت أوائل الستينيات أذرعاً عسكرية تابعة لها، ما لبثت أن انضوت، كجهات سياسية، في قيادة موحدة، مثلتها منظمة التحرير الفلسطينية التي تولى رئاستها ياسر عرفات، قائد حركة فتح: أكبر تنظيم فلسطيني مسلح، والجهة التي تمحور حولها العمل الوطني والعسكري، وقامت بدور حاسم في توحيد المقاتلين والسياسيين، من دون أن تحد من تنوعهم، أو تقيّد قدرة تنظيماتهم على العمل. في ظل هذه الخصوصية، عرف الفلسطينيون كيف يجعلون عملهم موحداً أو متكاملاً ميدانياً، وعلى الصعيد الاستراتيجي، وصعيد مواقفهم من قضايا الحرب والسلام. وقد تباهى عرفات، مراراً وتكراراً، بما كان يسميها "ديمقراطية البنادق" التي عرف دوماً كيف يوحّدها ضد العدو الإسرائيلي، وكيف يجعلها تتخطى خلافاتها، وتبقى متمسكةً بتناقضها الرئيسي مع الصهاينة، والذي تحوّل أيُّ تناقض داخلي فلسطيني، بالمقارنة معه، إلى مجرد خلاف.
لم تبلور الثورة السورية قيادة مركزية من الطراز الجزائري. ولم تعرف إلى يومنا قيادةً قادرةً على توحيد التنوع، وتوجيهه الواعي والبرنامجي، نحو هدف واحد، هو إسقاط النظام وانتصار الحرية والديمقراطية. وزاد الطين بلةً عجزها عن الحؤول دون اختراق الثورة من قوى مذهبية، معادية لها ولمشروعها، توطّنت بصورة رئيسية في المجال العسكري، حيث استمر فشل مؤسسات المعارضة في توحيده، وضمان غلبته على أي تكوين مسلح لا ينتمي إلى الجيش السوري الحر، كما تواصل فشلها في دفع فصائله إلى تبني خياراتٍ متقاربةٍ أو متشابهة حيال مختلف القضايا، خصوصاً منها العمل العسكري الذي لم تقدم المعارضة أية رؤيةٍ خططية لإصلاحه، فكانت النتيجة الكارثية بقاء حقل الثورة السياسي منفصلاً عن حقلها العسكري، المشتت والحافل بالتناقض بين أطرافه، فلا عجب أن سادت الفوضى الحقلين السياسي والعسكري، وظهر فيهما عديد من أمراء الحرب والانتهازيين، ولا غرابة في أن الثورة لم تنجح، بل شهدت تراجعاً حثيثاً، ومتى وأين نجحت ثورةٌ تحمل مشروعين متناقضين، يخدم أحدهما النظام؟
لم يفت الوقت بعد. على الثورة، كي تنتصر، الأخذ بطريقةٍ تشبه التجربة الفلسطينية، القائمة على تنوعٍ لا يمكننا تخطيه أو القفز عنه، واعتبار وجوده منعدماً، مع أن لقواه العسكرية من القوة، داخل وطننا وخارجه، ما مكّنها من تحييد دور ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في المجال العسكري، وأن من المحال اختيار الطريق الجزائرية، لكونها تتطلب ما يفتقر "الائتلاف" إليه: قيادة مركزية لا يستطيع أحد الاعتراض عليها أو عصيان أوامرها، أو العمل بعيداً عنها أو ضدها، واندماجا سياسياً وعسكرياً مطلقاً.
لا بد، من الآن، من توحيد مواقف التنظيمات العسكرية والسياسية على برنامج، ومن وضع قيادة كارزمية على رأسها، لا شيء يمنع أن تكون من صفوف المقاتلين. ولا مهرب من تفاهم وطني على حدودٍ عليا ودنيا، لا يخرج أحدٌ عليها أو يرفضها، يترجمه المقاتلون ميدانياً عبر قبولهم الانصياع لقيادته السياسية. بغير ذلك، لن تنتج الفوضى التنظيمية والفصائلية القائمة غير النكسات، وفي النهاية الهزيمة. ولن تنتصر ثورةٌ فشلت قواها السياسية والعسكرية في احتواء الأصولية والإرهاب ومخاطرهما، بل إن قسماً منها كان جزءاً منهما. ولن تنتصر الثورة ببرنامجين متناقضين، قوض أحدهما فرص البرنامج الديمقراطي، ونال دعم قوى احتسبت على الثورة، مع أنها لا تؤمن بها، وقاتلت ضدها بطرقٍ ألحقت بها أضراراً فادحة.
 ٥ أغسطس ٢٠١٦
٥ أغسطس ٢٠١٦
تبدو قائمة المسموحات في التفاوض الأميركي مع روسيا، في شأن سورية، واسعة ومفتوحة الأفق، حيث مسموح كسب الأراضي بالقوة، ومسموح حصار المدن والمناطق، ولا سقف لعدد القتلى، وكل ذلك يندرج تحت إطار إغراء روسيا لجلبها إلى مفاوضات متوازنة. لكن السؤال عن ماذا ستتازل روسيا في هذه الحالة وهي تعتبر كل سماح تحصل عليه من واشنطن بمثابة إنجاز وتطالب بتصريفه سياسياً في المفاوضات، حتى أنها باتت تتبع استراتيجية إخراج ما تحصل عليه بالتنازل الأميركي من دائرة المفاوضات وتعتبره لاغياً لعناصر تفاوضية أخرى، فلا يعود هناك معنى للحديث عن مصير بشار الأسد في ظل كسبه أراضٍ جديدة واستعادة سيطرته على مناطق سورية، إذ يصبح هذا الطلب غير واقعي، ثم لمن سيتنحى الأسد طالما يجري تدمير هياكل المعارضة وكامل أطرها؟
ثمّة سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا يحصل ذلك مع أميركا؟ هل نسيت واشنطن أبجديات التفاوض؟ أم فقدت الحساسية السياسية تجاه المتغيرات، أم لم تبقَ لديها القدرة على إدارة الأزمات في العالم؟ المشكلة أن الطرف الذي يقابلها لا يملك بالفعل ما يؤهله لمنافستها لا من حيث حجم المعلومات التي تحصل عليها واشنطن من مصادر معقّدة ومكلفة، ولا من حيث مراكز البحث والدراسات التي تملك خبرة عالية في التقدير والإستشراف، ولا من حيث الخبرة الاستراتيجية بحكم الانخراط الأوسع في قضايا كثيرة، ولا حتى من حيث القدرة على فرض السيطرة على مفاصل الجغرافيا العالمية بحكم الانتشار العسكري الأميركي القابض على جسم العالم عبر عدد كبير من الأساطيل الجوالة ومئات القواعد العسكرية الثابتة.
ما تتّبعه أميركا في سورية ليس استراتيجية متماسكة ومتكاملة، بقدر ما هو مجموع لهوامش استراتيجيات، واحدة تخص العراق، وأخرى إسرائيل، وثالثة ذات علاقة بنشاط حلف «الناتو» جنوب أوروبا، في تركيا تحديداً، وبالتالي فإن إجراءاتها في سورية تندرج، في الغالب، في إطار تلك الاستراتيجيات، ومن الواضح أن روسيا تعمل ضمن المساحة البعيدة عن المدى الأميركي، وعن مدار الأسلحة وأجهزة الرصد الأميركية، لذا لم يكن صعباً على روسيا تشكيل مجال عسكري أمني في باقي الجغرافية السورية وهي مطمئنة إلى أنها لن تصطدم مع واشنطن في أي لحظة، لا الآن ولا في المستقبل.
على ذلك فإن أميركا لا تجد نفسها مضطرة لإجراء مساومات جادة في الميدان السوري، وهي تتعامل مع الحالة برمتها من منطلق ربح زائد تحصّله من روسيا وإيران في مناطق ثانية، أو نوع من إسكاتهما عن المطالبة بمفاوضات متوازنة في قضايا أخرى، بمعنى تحويل الساحة السورية التي لا تنطوي على قيم استراتيجية مهمة للاستراتيجية الأميركية ولا تملك فيها واشنطن أصولاً عسكرية مهمّة، إلى عامل مساعد لكسب نقاط مهمة في التفاوض «الصراعي» مع روسيا وإيران من دون أن تخسر شيئاً في المقابل في ساحات تفاوضية مهمة، سواء في أوروبا الشرقية ذات الأهمية الخاصة في الميزان الاستراتيجي الأميركي نظراً لارتباطها بالأمن الأوروبي واستراتيجيات انتشار حلف «الناتو»، أو في قمع إيران من تطوير مخرجات الاتفاق النووي بحيث تستطيع صرفه سياسياً واقتصادياً.
لعلّ هذا ما يفسر سبب عدم اهتمام أميركا بتدعيم أوراقها التفاوضية في الميدان السوري بدرجة كبيرة، وغالباً فإن إجراءاتها تأخذ طابعاً شكلياً لا تدعمه إجراءات عسكرية وازنة وملموسة.
من هنا، يجد الروس أنفسهم غير معنيين كثيراً بتقديم تنازلات جوهرية ولا حتى التوافق على مبادئ أساسية لحل الأزمة في سورية، بل الواضح أنهم التقطوا حقيقة الاستراتيجية الأميركية من خلال محاولاتهم المتكررة فتح ملفات تفاوضية أخرى، في أوكرانيا وقضية الدرع الصاروخي، على خلفية انخراطهم في سورية، وإصرار أميركا على التفاوض فقط في الملف السوري، من دون الخروج عن مداره وهو ما يزيد غيظ الروس وتزمّتهم في سورية، بل إن روسيا ذهبت إلى حد محاولة صناعة فضاء إقليمي من خلال توسيع علاقات التعاون والتنسيق مع إسرائيل والأردن وتركيا، وإقامة غرف عمليات مشتركة مع العراق وإيران ونظام الأسد، وذلك للضغط أكثر على واشنطن ودفعها إلى تفكيك عقد العلاقات معها في الملفات الأخرى.
لا يدخل في حسابات الاستراتيجية الأميركية حجم الكارثة التي يعاني منها الشعب السوري، ولا التداعيات التي تجاوزت دائرة الاحتمالات وتحولت إلى وقائع من نمط اهتزاز الاستقرار الإقليمي وزيادة انتشار التطرف وتهديد أمن حلفاء أميركا في المنطقة وأوروبا، والأرجح أن السياسة الأميركية نامت عند حدود الرهانات الأولى في تقدير المكاسب المحتملة من الأزمة وحصرها بتقاتل السيئين وإشغال إيران واستنزاف روسيا وإحراجها، تلك الاستراتيجية الخائبة، فهي كما سمحت لـ «داعش» بالظهور والتمدد، شكلت البيئة المناسبة لتغوّل فلاديمير بوتين الذي بات يتدخل في توجيه الناخب الأميركي نحو مرشح معين، بعد أن جرب العبث بأمن أوروبا ونجح.
 ٥ أغسطس ٢٠١٦
٥ أغسطس ٢٠١٦
تأخرت حلب، حتى التحقت بالثورة السورية، لكنها، منذ ذلك الحين، صارت بؤرة الاشتباك الرئيسي، السياسي والعسكري، ومركز ثقل المأساة السورية بكل تجلياتها، وبات ثابتاً في الداخل والخارج أن مستقبل الوضع السوري يتعلق بحسم الموقف في حلب، الأمر الذي تتصرّف بموجبه الأطراف المعنية بمعادلة الصراع، وظهر جلياً من خلال مجريات الهجوم الكبير الذي شنته المعارضة في الأيام الأخيرة.
أعادت معركة حلب الدائرةُ منذ مساء الأحد الماضي، تصحيح بعض الاختلالات في النظر إلى وضعية المدينة قبل كل شيء، ومن ذلك مسألة الحصار التي حاول النظام أن يلعبها ورقةً لإنهاء المعارضة، واستخدامها وسيلة ضغط وسلاح في مفاوضات جنيف، وبعد أن حقّق تقدماً، في الشهر الأخير، على صعيد قطع خط الإمداد الوحيد، وتحكّم بطريق الكاستيلو الذي كان يربط شرقي المدينة بريفها، دخل الأسبوع الماضي في مساومة المعارضة على الاستسلام العسكري ورمي السلاح.
لم يكن في وسع النظام أن يحقّق هذا التقدم النوعي، لولا الدعم الروسي الذي بدأ منذ حوالي سنة، واتضح، في الأسابيع الأخيرة، أن خطة روسيا لتمكين النظام من حلب اعتمدت على تطبيق "نهج غروزني" في العاصمة الشيشانية التي حرثها الروس، ودمّروها فوق رؤوس سكانها، ليسيطروا عليها، وهذا ما يفسّر كيف أضحت المستشفيات ومحطات المياه في حلب وإدلب أهدافاً للطيران الروسي، وصار سلاح التجويع أداةً لإخضاع من تبقوا من السكان في القسم الشرقي من مدينة حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة.
ذهب الروس والإيرانيون إلى حصار حلب، على الرغم من التحذيرات التي صدرت عن أطرافٍ إقليميةٍ ودوليةٍ من خطورة هذه الخطوة، والأمر الذي يبعث على الاستنكار أن الأمم المتحدة انساقت وراء ذلك، وتبنّت مسألة الممرات التي حدّدها الروس، من أجل تفريغ المدينة من المدنيين الموالين للمعارضة، وتسليم المقاتلين سلاحهم. وكانت زيارتا المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، إلى طهران، ونائبه رمزي يوسف رمزي إلى دمشق، في اليوم نفسه رسالةَ تسليمٍ بالخطة الروسية الإيرانية.
جاءت معركة حلب لتكشف أن هناك تسرّعاً روسياً إيرانياً في الحسابات، وخفةً وتواطؤاً من الأمم المتحدة، ذلك أن هؤلاء جميعا تجاوزوا ما تكرّس من قواعد اشتباكٍ في حلب على مدى العامين الماضيين. وفي العمق، أنه لا يحقّ لطرفٍ حسم المعركة لصالحه، وكثيراً ما ردّدت أطراف دولية وإقليمية أن الحل العسكري غير وارد. ولهذا، قامت آلية جنيف من أجل الاتفاق على عملية سياسية.
صحيحٌ أنه لم يتم رسم خطوط حمر في حلب. ولكن، على مدى عامين من الحرب، صار متعارفاً على جملة من الخطوط الحمر التي نشأت بفضل تفاهماتٍ غير مكتوبة بين الأطراف الإقليمية والدولية، ويمكن ملاحظة ذلك من سير المعارك العسكرية، وظهر أكثر من مرة أنه لا يكفي أن يكون طرفٌ ما قادراً عسكرياً، حتى يمسك بالأرض، وتبيّن أن الميدان هو ساحة اشتباك، وليس مكاناً للنصر أو الهزيمة. ومن هنا، يعتبر قرار الروس والإيرانيين قطع طريق الكاستيلو على حلب، وفرض الحصار، خرقاً خطيراً للتفاهمات، وكان الرد عليه من خلال معركة حلب التي جاءت لتفرض حصاراً على النظام، وباتت المعادلة اليوم قائمةً على تبادل الحصارات.
ومن دون شك، تعتبر تركيا الطرف الأكثر تضرّراً من حصار مناطق المعارضة، ليس فقط لأن حلفاءها فقدوا موقعاً مهماً في مسار الحرب، وإنما لأنها ستتحمل وحدها عبء استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين. ولذا، كانت قريبةً جداً من تحضيرات معركة "الغضب لحلب"، وستظل طرفاً أساسياً فيها، وسيكون لرأيها دور في تحديد مآلاتها.
هدف معركة حلب المباشر هو فك الحصار عن مناطق المعارضة، لكن النتائج مرشّحةُ أن تقرّر مصير سورية.
 ٤ أغسطس ٢٠١٦
٤ أغسطس ٢٠١٦
يُقصف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة، وبأحدث الأسلحة الروسية. والمخيم لا يحوي "إرهابيين"، ولا مسلحين، لا في السابق ولا الآن. إذن، لماذا يُقصف؟
قُصف المخيم في درعا، بسبب اتهام الفلسطينيين بتقديم المساعدات الغذائية، حينما حاصر النظام المدينة، وكان ذلك قبل أن يصبح السلاح وسيلة ردّ الشعب السوري على وحشية النظام. وفي مخيم اليرموك، تحجج النظام بسيطرة "الإرهابيين" على المخيم، على الرغم من أن النظام وأتباعه من التنظيمات الفلسطينية كانوا يحشدون السلاح في المخيم، وأنه كانت للنظام علاقة بأول من اقتحموا المخيم. وهكذا في كل المخيمات الفلسطينية، في اللاذقية وحمص وحلب. لكن، ظل مخيم خان الشيح بعيداً عن السلاح، ولم يحوِ مسلحاً واحداً، وظل بعيداً عن الصراع. لهذا، يصبح السؤال عن سبب قصفه كاشفاً، ويوضّح هدف النظام من كل ما قام به ضد كل المخيمات الفلسطينية. ذلك أن قصف هذه المخيمات وتدميرها لا يرتبطان بوجود المسلحين، أو أن وجود المسلحين كان مبرّراً فقط، وأن النظام هو الذي عمل على زجّ المخيمات في الصراع.
يجب أن نتذكّر من أجل فهم الهدف من القصف، أنه، بعد احتلال العراق وتهجير الفلسطينيين منه، لم يسمح النظامان، السوري والأردني كذلك، بدخول هؤلاء، ووضعهم السوري في مخيم التنف في الصحراء سنواتٍ، إلى أن جرى نقلهم إلى أميركا اللاتينية. لماذا؟ لأن النظام خضع لقرار أميركي يفرض منع تمركز اللاجئين الفلسطينيين في محيط فلسطين، وتهجير من هم مقيمون فيها، حيث يجب أن يتشرّد اللاجئون بعيداً، لكي ينتهي حقهم في العودة.
ربما يُفهم قصف مخيم يحوي "مسلحين"، على الرغم من أن الأمر أبعد من ذلك. لكن، أن يُقصف مخيم لا "مسلحين" فيه، وأن يحاصر ويتعرّض للبراميل المتفجرة، وللطيران الروسي بكل أسلحته الحديثة جداً، فهو الأمر الذي يدفع إلى أن في الأمر هدفاً آخر، لا علاقة له بـ "المسلحين"، بل يطاول المخيمات نفسها. لهذا، انطلاقاً مما يتعرض له مخيم خان الشيح، يمكن القول إن النظام يعمل على تدمير المخيمات قصداً، ولهدفٍ يتعلق باللاجئين أنفسهم. وقد استغلت الثورة السورية، لكي يمارس النظام وحشيته ضد الفلسطينيين الذين اتهمهم بأنهم سبب "الأحداث" في درعا واللاذقية منذ الأيام الأولى للثورة. والواضح الآن أن هذا الاتهام لم يكن عبثياً، بل كان المقدمة لسياسة التدمير الممنهج للمخيمات.
إذن، يمكن القول إن ما يتعرّض له مخيم خان الشيح من قصفٍ وحصارٍ يكشف الهدف من كل ما تعرّضت له المخيمات الأخرى. وهو هنا، كما جرى لفلسطينيي العراق، تهجير فلسطينيي سورية بعيداً عن حدود فلسطين، وفق القرار الأميركي الذي يأتي خدمةً للدولة الصهيونية التي تريد التخلص من "مشكلة اللاجئين" من خطرهم، وهم يقطنون في محيط فلسطين.
يتقصّد النظام الممانع، إذن، تدمير المخيمات، وهي ورقةٌ يقدمها للدولة الصهيونية التي يحاول، منذ مدة، أن يتواصل معها من أجل "السلام"، وبالأساس دعم بقائه. وهي "مقاولةٌ" يقبض عليها مالاً. لكن "الجو الفلسطيني" لا يلتفت إلى ذلك، لأنه يتمسّك بـ "دولة الممانعة"، وتزجّ تنظيماتٌ ملحقةٌ به فلسطينيين في حرب النظام ضد الشعب السوري. وتقف تنظيماتٌ أخرى متفرّجة، أو خرساء، لأنها تدعم النظام الممانع، أو لا تجرؤ على قول رأيها، ليس في الثورة السورية، حيث لم يطلب منها أحد ذلك، بل فيما يحدث للمخيمات. والآن، لمخيم خان الشيح الذي هو خارج "الصراع السوري السوري"، حيث لا سلاح ولا مسلحين يكونون مبرراً لتدميره.
بالضبط، لهذا السبب يجب أن يتوضح هدف النظام من قصفه، وبالتالي، من تدمير مخيماتٍ أخرى. لا يتعلق الأمر بمواجهة "إرهاب"، بل بسياسة تدميرٍ ممنهجٍ للمخيمات الفلسطينية، بغية تهجير اللاجئين، بعيداً عن فلسطين. الممانعة تفعل ذلك.






