 ١٤ يوليو ٢٠١٦
١٤ يوليو ٢٠١٦
منذ أن اعتذر طيب أردوغان عن إسقاط الطائرة الروسية، كتبتُ منشوراً على صفحتي بأسلوب ساخر مؤلم، قلت فيه:
الطيب أردوغان، رضي الله عنه، ملّ من التراجع إلى الوراء، وقرر أن يتقدم إلى الأمام..
في بداية الثورة السورية قال: لن نسمح للأسد بحماة ثانية في حمص، ولكنه تراجع إلى الوراء، حتى أصبحت المجازر التي ارتكبها النظام في حمص وبقية المحافظات لا تُعدّ ولا تُحصى..
وحلف برأس جده مؤسس الدولة العثمانية أن ينشئ منطقة آمنة في الشمال السوري، ولكنه تراجع عن هذا القسم حتى أن عظام جده اهتزت في قبره غضباً من هذا التراجع المخجل..
ثم هدد بأنه لن يسمح لقوات الحزب الديمقراطي الكردي أن تتقدم في الأراضي السورية غربي الفرات، ولكنها دخلت وشبعت دخولاً هناك..
من هنا ملّ أردغان من مثل هذه التراجعات، فقرر أن يتقدم إلى الأمام، ولذاااااااا.
قرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. وطبّعها على خير ما يرضي إسرائيل..
وقرر أن يعتذر لبوتين بسبب إسقاط الطائرة الروسية.. واعتذر بشتى أنواع الاعتذارات، حتى أنه قرر أن يحاكم الطيار التركي الذي أسقط طيارة بوتين..
والآن.. بقي عليه أن يتقدم نحو الخطوة الأشد أهمية، وهي أن يقوم بتطبيع العلاقات مع الأسد..
أنا أعترف مسبقاً بأن لهجة المنشور كانت متوترة، وقد كتبته تحت تأثير الحقيقة المؤلمة، ولذلك يستدعي مني الآن أن أنظر إلى هذه المسألة بواقعية وجدية أكثر، مع أن النتيجة لا تؤدي إلى قناعة جذرية..
علينا أن نسلم أولاً أن تركيا قدمت الكثير للشعب السوري، وهذا لا يمكن نكرانه، وعلينا أن نسلم ثانياً أن تركيا ما قبل تغييب أحمد دواوود أوغلو تختلف كثيراً عن تركيا ما بعد مجيء بن علي يلدريم.. لقد حدث انقلاب شبه جذري في المواقف السياسية للأردوغانية الجديدة..
طبعاً.. هناك من يلتمس العذر لهذا التحول في السياسية التركية، وهو عذر واقعي ومنطقي من حيث المبدأ، فالتغييرات السياسية، كما يقول الكاتب زين مصطفى، تحكمها مصالح الدول ولا تحكمها أمور إنسانية ".. وهذه مقولة تتبناها معظم الدول التي لا تريد الخراب لبلادها، بل تسعى لتأمين مصالحها وأهدافها، ولو على حساب الغير.. ويتبناها أيضاً الكثير من المفكرين والمحللين السياسيين..
تركيا في الآونة الأخيرة ، تم حصرها في زجاجة ضيقة، ولا يبقى إلا تحضير سدادة عالية الجودة لإحكام الإغلاق عليها بحيث يتم اختناقها ببطء، ولكن في وقت قريب لا بعيد..
ليس خافياً على أحد أن الهجمات السياسية والاقتصادية والعسكرية على تركيا جاءت من شتى الجهات.. أميركا سحبت بطاريات الباتريوت، بعد التدخل الروسي في سورية، وحلف الناتو أدار قفاه لتركيا بعد إسقاط الطائرة الروسية، ونسي أنها عضو في الحلف، وأن بوتين يرغي ويزبد، ويهدد ويتوعد، أما الاتحاد الأوروبي فراح ينبش لها من قبور الزمن مسألة إبادة الأرمن قبل مائة عام،
ولا ننسى أميركا أوباما وروسيا بوتين وملالي إيران والنظام السوري أجمعوا على تحريك الأكراد في الشمال السوري والجنوب التركي، حتى أن حزب العمال الكردستاني المصنّف في قائمة الإرهاب تم تسليحه مؤخراً بصواريخ مضادة للطائرات، أدت إلى إسقاط إحدى الطائرات التركية.. وداعش المصنّع عالمياً التقى من جهته مع حزب العمال الكردستاني، وبدأ نشاطهما التفجيري المكثف في أماكن تركية متعددة، سقط من جرائها المئات من المدنيين بين قتلى وجرحى..
أما إسقاط الطائرة الروسية فقد كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، فهي المقدمة والنهاية لما أشرت وأشير إليه.. فقد جاءت، فيما أرى، بترتيب وتحريض روسي، فكانت كالطعم الذي أوقع السمكة المغفلة في سنارة بوتين..
كل ذلك جرى ويجري، وعرب الخليج كطيور النعام، يدفنون رؤوسهم في ظواهرهم الصوتية الخافتة المرتجفة..
من هنا يمكن القول إن من حق تركيا أن تخشى على نفسها، وأن تحافظ على كيانها حتى ولو أدى ذلك إلى تغيير مواقفها المبدئية، وهذا ما يراه الكثير من المحللين والكتاب..
ولكن فيما يبدو أن بن علي يلدريم كان مستعجلاً جداً في تطبيق السياسة التي رسمتها تركيا الجديدة، فراح يطلق التصريحات المثيرة للجدل، ومنها تصريحات لا تحتاج إلى نوايا طيبة لتفسيرها، كقوله على سبيل المثال: أنا متأكد من عودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، هذا لا مفر منه، حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة الإرهاب "..
إذن تحقق ما قلتُه في منشوري المشار إليه.. وهو : بقي على أردوغان أن يتقدم نحو الخطوة الأشد أهمية، وهي تطبيع العلاقات مع الأسد "..
تصريح يلدريم الذي جاء بطريقة فجة، ولا أريد أن أقول بطريقة مذلة وانبطاحية، جعلت " أربكت السياسة التركية "، وهذا ما دفع بياسين أكتاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسم الحزب إلى القول: لا توجد مشكلة بين الشعبين التركي والسوري، وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق مرتبط بإقامة نظام ديمقراطي في سوريا، لأن بقاء بشار الأسد في الحكم يشكل عائقاً أمام تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا ".. وذكر أكتاي أن يلدريم صحح أقواله حين أكد على أنه لا يقصد تطبيع العلاقات مع سوريا بوجود الأسد..".. وهذه التوضيحات أشبه بمن يلملم اللبن المسفوح فوق أرض مليئة بالرمل والتراب والتبن..
إن هذه الخطوات الإعلامية دفعت بخالد الخوجا سفير المعارضة ورئيس الائتلاف السابق، إلى القول: من السذاجة لجوء الأصدقاء إلى العمليات الإعلامية في ظل عجزهم عن التحرك.. "..
على أية حال.. المسالة لا تزال في نطاق التصريحات الإعلامية، ولم تصل بعد إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، ومع ذلك فهذا لا يجعلنا نركن إلى أمل " عدم التطبيع " مع الأسد، فالمؤشرات الميدانية بعد التحول الكبير في سياسة أردوغان أدت بسرعة إلى نتائج شبه كارثية، فطريق الكاستيلو تم قطعه نهائياً، وبدأت حلب المدينة تختنق من الحصار المطبق، وربما يؤدي ذلك إلى سقوطها.. وهذا السقوط، إن تحقق، لا سمح الله، سيؤدي إلى كارثة كبيرة على الثورة السورية والشعب السوري خصوصاً، وعلى الشعب العربي وتركيا عموما.. من هنا يقول الكاتب محمد مختار الشنقيطي: لن تسقط سوريا وحدها، بل سيكون السقوط شاملاً لدول سنية محورية "..
وطالما أن تعليقات المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي تعكس الإحساس الشعبي بشكل او بآخر، لذلك أثبت ما قاله أحد المعلقين: بوتين والنظام الأمني لا يجيد الا مناورات القوة ولن تجدي معه المناورات السياسية والرسائل، لذلك مهما فعلت تركيا تبدو تحركاتها هزيلة ولا تعدو فقاعات سخيفة بالنسبة للشعب السوري الذي مل من أردوغان وعجزه وعدم تحركه الفعلي في كل الأوقات الذهبية".. وبالفعل فقد أضاع أردوغان فرصاً ذهبية كثيرة، أشرت إلى بعضها في نص المنشور السابق..
وأخيراً.. إذا أردنا أن نقف في وسط المسافة، فيمكن القول إن التحول التركي كبير جداً، وغامض جداً، ووراءه ما وراءه، ولا أحد قادر أن يستشرف ما سوف يجري في الغد القريب.. ولكن يمكن أن نتحدث عن احتمالين في غاية التناقض.. إما أن يؤدي هذا التحول إلى أن يقدم أردغان التحية للأسد على الطريقة الهندية المهذبة.!!.. أو أن يأتي بحل ينتج عنه رمي الأسد في مكب النفايات التاريخية.!!!..
 ١٤ يوليو ٢٠١٦
١٤ يوليو ٢٠١٦
أنت متهمٌ بتأييد "داعش"، إذا فتحت فمك لتتحدّث عن فظاعاتٍ ترتكبها مليشيات الحشد الشعبي، ضد العراقيين من أهالي مدينة الفلوجة. وعليك أن تصمت، تحاشياً لمثل هذه التهمة، إن سمعت أيضاً صيحات استغاثةٍ من لبنان، واستدرت لترى تنكيلاً عنصرياً مروّعاً باللاجئين السوريين الفارين من براميل بشار الأسد، وصواريخ روسيا، ومليشيات إيران.
أغمض عينيك وأغلق أذنيك، حيال كل ما يقال عن موت الأطفال جوعاً في داريا ومضايا ومعضمية الشام، لكي لا يظن أحدٌ بأنك تخون المقاومة، وقد اختارت المرور عبر تلك البلدات السورية في طريقها إلى تحرير القدس، أو يعتقد آخر أنك تؤجّج الصراع بنشر الأخبار عن معاناة الضحايا من التعذيب، وبتجاهل الأنباء عن معاناة الجلادين من الضجر.
لا خيار أمامك، سوى أن تبتلع لسانك، بل أن تلغي عقلك، إن أردت النجاة من احتمال تصنيفك منحازاً للحلف الأميركي الصهيوني التكفيري، وفق لغة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وإياك حتى أن تتساءل، عن معنى أن توفر واشنطن غطاءً جوياً لأعدائها المفترضين الموالين لطهران، في حربهم على تنظيمٍ تتحالف معه، ولا كيف يمكن فهم التنسيق العسكري الروسي المزدوج مع الإسرائيليين والإيرانيين في آن معاً، وبمباركة من الأميركيين، ضد قوى المعارضة السورية المسلحة كلها، لا ضد "داعش" فحسب.
في وسعك طبعاً، وفق منطق موزعي شهادات الوطنية والخيانة، أن تكون يسارياً، إن أحببت، بشرط أن تنسى انهيار الاتحاد السوفييتي، وتنظر إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوصفه وريث نيكيتا خروتشوف الذي وقف ضد العدوان الثلاثي على مصر، وساعدها في بناء السد العالي، عندما كانت روسيا الشيوعية تقدّم نفسها نصيرة الشعوب ضد الإمبريالية.
وبالمقدار نفسه، تستطيع أن تكون قومياً عربياً، فتستشهد بما ينسجم وموقفك من مقولات جمال عبد الناصر وميشيل عفلق وقسطنطين زريق وجورج حبش. لكن، حذار من أن تنظر إلى التدخل الإيراني في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين والسعودية، بغير كونه فعل خير من جيرانٍ طيبين، وبعيداً عن أية شكوك، قد يثيرها المغرضون حول أطماع الفرس في بلاد العرب.
لا بأس كذلك من أن تكون علمانياً وليبرالياً متشدّداً في الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، ومناهضاً صلباً عنيداً لقوى الإسلام السياسي، باختلاف ألوان طيفها، وقد يكون هذا الموقف مطلوباً، لتتغنى به وكالة أنباء فارس، طالما أنه موجه ضد "داعش" و جبهة النصرة و"الإخوان المسلمين"، لا ضد مليشيات مذهبية أخرى تتبع الولي الشيعي الفقيه علي خامنئي الذي يقول بعض مقربيه إنه يلتقي المهدي المنتظر في غيبته الكبرى، كل يوم، ليتلقى إرشادات النهوض بأحوال المسلمين.
أما في حال لم تُجْدِ كل الوصايا السابقة معك نفعاً، وعجزت عن إلغاء حواسّك كلها، ورغبت، في الوقت نفسه، عن أن تكون يسارياً أو قومياً أو علمانياً ليبرالياً، على الطريقة تلك، فكن محايداً على الأقل، والحياد في ترجماته الواقعية صار يعني وضع القاتل والقتيل، على قدم المساواة، باعتبار أن الصراع يدور بين طائفتين كريمتين من شعبٍ واحد، لا بين طُغَمٍ حاكمة تتحالف مع شياطين الأرض، وغالبية مقهورة يتخلى عنها أقرب الأصدقاء.
لا تستطيع؟! إذن، واصل ترديد ما ترى وتسمع وتحس وتفهم، بلا مواربة. قل إن "داعش" رديف الحشد الشعبي. قل إن قطع رؤوس الناس يساوي خوزقتهم، وشَيّهِم على طريقة الشاورما. قل إن أولئك وهؤلاء، ومعهم ملايين الضحايا، ليسوا إلا وقوداً في مشروع استعماري ذي نواة قومية فارسية، وهدفه السيطرة على بلدان الجوار العربي، عبر التضحية بأبنائها أنفسهم، لا بأبناء الفرس. قل إن المؤامرة تشارك فيها روسيا وإسرائيل، وتباركها أميركا، ثم لا تلومن، من بعد، إلا نفسَك، حين تتجه نحوك سبابات التخوين.
 ١٤ يوليو ٢٠١٦
١٤ يوليو ٢٠١٦
أثبتت شهور طويلة من التعامل مع خططٍ لإنهاء الصراع في سورية تماسك محور روسيا - إيران - نظام بشار الأسد، وتمسّكه بشروطه للحل السياسي من جهة، وامتلاكه بديلاً هو الحل العسكري من جهة أخرى، مستنداً إلى اختلال ميزان القوى لمصلحته، وبالتالي عدم اكتراثه بالكلفة البشرية والاقتصادية والعمرانية. وفيما يشاطره المحور الآخر عدم الاكتراث هذا، فإنه يكاد يقتصر على الولايات المتحدة، وحدها عملياً، وهي متخبّطة ومُربكة، سواء بخياراتها ومصالحها أو بتناقضات لا حصر لها مع حلفاء وأصدقاء، يشعرون أحياناً كثيرة بأنها متواطئة مع روسيا أو مع إيران ومع النظام، والأسوأ أنها كلّما لوّحت وتلوّح بتنازلات للحصول على «صفقة/ اتفاق» تجد أن موسكو تأخذ تلك التنازلات على أنها مكاسب ولا تلبث أن تخدعها فلا تعطي شيئاً في المقابل. مردّ ذلك إلى أن «الدب الروسي» مدرك أنه يتساوم في سورية مع «أميركا بلا أسنان»، وما دامت كذلك فهي في نظره رهانٌ خاسرٌ لمن يعوّلون عليها ولا يحقّ لها أن تحصل على شيء. لكنها أميركا مختلفة في مكان آخر: أوروبا.
لم يكن مُستغرَباً، إذاً، أن يخفق التنسيق والتعاون بين موسكو وواشنطن، ويبدو تشدّد حلف الأطلسي في ملفّيَن (روسيا والإرهاب) وعزمه على تعزيز وجوده العسكري في شرق أوروبا بمثابة تفسير لهذا الإخفاق. ذلك أن شروط الروس لقتال مشترك ضد تنظيمي «داعش» و »جبهة النصرة» (بعد فصلٍ غير واقعي للمعارضة «المعتدلة» عنها)، كذلك شروطهم للحل السياسي، رُسمت بهدف التعجيز والضغط على الأميركيين كي يخفّفوا ضغوطهم الأطلسية. وعلى رغم أن الطرفين يبديان ارتياحاً إلى المعادلة القائمة، إلا أنهما يخوضان صراعاً حادّاً يركّز فيه «الناتو» وأميركا على استكمال منظومة الدفاع الأوروبي، أما فلاديمير بوتين فيعتبر أنه كسب أوراقاً مهمة في أوكرانيا وفرض أمراً واقعاً (تقسيمياً) لا يمكن تغييره إلا بالقوّة. لكن ما يربحه بوتين في سورية لم يساعده على التخلص من الكلفة الباهظة للعقوبات الأميركية والأوروبية ولم يمكّنه بعد من إقلاق خصومه، فالأطلسي وأميركا لا يمانعان انشغاله في الساحة السورية التي لا يريدان دخولها. وفي تقديرهما أن روسيا محكومة بثلاثة محدّدات: لا تستطيع إنهاء هذه الأزمة وحدها أو مع النظامين الإيراني والسوري، ولا تستطيع فرض حلٍّ بشروطها وحدها فهي تحتاج إلى «الشريك» الأميركي، ولا تستطيع إجراء مقايضات بين أوكرانيا وسورية حتى لو قدّمت تنازلات جوهرية.
لكن حتى أميركا - أوباما لا تعمل لتخسر في سورية، وإنْ لم تكن لديها المقوّمات ولا السياسات المساعدة لتربح. وإذا كانت ترفض الإنضواء في سياسة تقودها روسيا، بل تصرّ على المشاركة في القيادة، إلا أنها اختارت للعمل العسكري على الأرض طرقاً خاطئة أو ملتبسة حدّت من جدوى لعبها السياسي على الطاولة. وفي الأساس، لو لم تكن هناك معارضة مقاتلة لما استطاعت أميركا حتى أن تكون طرفاً في المساومة، لكنها فشلت دائماً، حتى عندما كانت تحسن تشخيص الأخطار، في اتخاذ القرارات المناسبة. إذ لم يعد أحد يصدّق أنها تساند أي معارضة للنظام، منذ البداية كانت لديها مشكلة في مناصرة الشعب السوري، على رغم الادّعاءات المعاكسة. لم تدعم حماية سلميته ثم استاءت من عسكرة ثورته، ثم فرّطت بالفرصة التي شكّلها «الجيش الحرّ»، فلم تساعده على الصمود ليكون سنداً لأي حل سياسي، ولم تشأ الاعتماد عليه في صدّ اختراقات المجموعات الإرهابية أو في محاربة تنظيم «داعش». لذلك ساهم غموضها وتردّدها وتقلّبها أولاً في تشظّي هذا الجيش إلى فصائل، وثانياً في تقوية حجة روسيا، إذ تبنّت ادّعاء نظام الأسد بأن كل مَن يحاربونه «إرهابيون» بل قاربت دخول اتفاقات تبيح لروسيا وحلفائها تصفية المعارضة.
كانت المراهنة الأميركية على تعاون مع روسيا مفهومة في بعض المراحل، خصوصاً أن الطرفين أكّدا دائماً أن «لا حلّ عسكرياً» في سورية. أما عدم المراهنة الأميركية على الشعب السوري فكان ولا يزال خطأً فادحاً أمكن واشنطن أن تلمسه على أرض الواقع، لكنها اكتفت برؤية الواقع الآخر الذي يمثّله «داعش» وتمسّكت به باعتباره ذريعة وجودها في شمال سورية، كما أنه أتاح لها استنباط قوة برّية تستخدمها في محاربة الإرهاب. وعلى رغم أن واشنطن تعرف أن الاعتماد على الأكراد يراكم مشكلة إضافية إلى تعقيدات الوضع السوري، إلا أنها أصرّت عليه، بل تجاهلت وأفشلت عمداً كل مشاريعها لتدريب وتجهيز عناصر من «الجيش الحرّ»، مفضّلة ضمّ مجموعات وصفتها بـ «العربية» إلى الوحدات الكردية، من قبيل التعمية وليس الجدّية في محاربة الإرهاب.
لكن موسكو عرّضت واشنطن لاختبارات عدة مخيّبة: إذ اتخذت أولاً من علاقة نظام الأسد مع الوحدات الكردية وسيلة للانفتاح عليها واختراقها والتدخّل في عملياتها ضد «داعش»، فضلاً عن اباء الدعم لها في طموحاتها القومية، ما أدّى إلى مفاقمة تهميش العنصر «العربي» في «قوات سورية الديموقراطية». ثم إن موسكو استغلّت، ثانياً، تلكؤ الأميركيين في التنسيق العسكري فأغارت مقاتلاتها على موقع التنف وأبادت عملياً فرقة استحوذت عليه فجأة، وأُعلن أنها تسمّى «قوات سورية الجديدة» المشكّلة من عسكريين منشقّين أُخضعوا لتدريبات أميركية - بريطانية. كما تمكّنت موسكو، ثالثاً، من اجتذاب إسرائيل إلى خطّها وإظهار انحيازها إلى نظام الأسد، ومن التنسيق مع إسرائيل لاجتذاب تركيا إلى خيارات سورية مختلفة. أخيراً وليس آخراً، نقضت موسكو تعهّدات سابقة بالنسبة إلى حلب وشرعت، حتى قبل إخفاق التنسيق مع واشنطن، في التغطية الجوية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية خلال عملياتها لمحاصرة المناطق وقضمها.
يحصر الأميركيون اهتمامهم حالياً بمحاربة «داعش» والإعداد لمعركة الرقّة، لكن تجربة منبج تضطرّهم إلى إعادة النظر في خططهم وتفحّص القوات التي تنفّذها من دون أن تكون لديهم بدائل. ويبدو الروس والإيرانيون والأسد كأنهم تركوا رقعة «داعش» للأميركيين موقنين بأنها ستعود إليهم في نهاية المطاف. وكما في العراق، كذلك في سورية، يرفض الأميركيون الاعتراف بحقيقة التلازم الأسدي - «الداعشي» والإيراني - «الداعشي»، وعلى رغم أن واشنطن أوحت في وقت سابق بأنها مدركة أن هذا مثلثٌ مترابط الأضلاع، إلا أنها لم تتوصّل في العراق حتى الآن إلى ترجمة إضعاف «داعش» تعزيزاً للدولة العراقية وتحجيماً للهيمنة الإيرانية، بل تتواكب هزائم التنظيم مع استفحال نفوذ طهران واستشراسه، ولا مبالغة في توقّع النتيجة ذاتها للنظام وحلفائه في سورية ولن يعني ذلك بطبيعة الحال حفاظاً على الدولة ومؤسساتها.
تبدى فشل الإدارة الأميركية الحالية في ثلاثة اتجاهات على الأقل: الأول في عجزها عن فرض تصوّرها الأساسي وهو أن تتوازى المرحلة الانتقالية في الحل السياسي مع التركيز على محاربة «داعش». والثاني في مهادنتها الروس والإيرانيين ونظام الأسد، إلى حدٍّ أتاح لهم تحقيق معظم أهدافهم على حساب المعارضة والدول التي تدعمها. والثالث في كونها صادرت مواقف حلفائها وأصدقائها وقصرت المبادرات على تفاهمها مع الروس، فإذا تعطّل التفاهم تتعطّل المفاوضات، وإذا تعذّر التنسيق كما هي حاله اليوم فإن الشعب السوري هو مَن يدفع الثمن. وهذا لا يمنع الروس والإيرانيين والأسد من الانفلات والبحث عن «انتصارات»، قبل انتهاء ولاية أوباما، كي يقدّمونها على أنها «حاسمة»، وحتى لو استطاعوا الحصول عليها فإنهم لن يتوصّلوا إلى أي حسم ضد الشعب، أو إلى نهاية للصراع على النحو الذي يتصورونه. قد يتوصّلون إلى تغيير بعض الوقائع قبل أن تستخلص الإدارة الأميركية المقبلة خيارات جديدة من ركام العبث الذي خلفه أوباما.
 ١٤ يوليو ٢٠١٦
١٤ يوليو ٢٠١٦
شهدنا في الساعات الأربع و العشرين الماضية حالة من "الهياج" الفكري و "جموح" بالخيال ، في اطار تفسيرات تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حول عودة العلاقات مع سوريا ، و كنا في حفلة "مجون" تناول فيها الجميع المسكرات ليظهروا على حقيقتهم قبل أن يصحوا فجأة أن ما قيل عبارة "زوبعة" مفتعلة .
حتمية اعادة العلاقات مع سوريا للقضاء على الإرهاب ، هي المحور الأساسي لتصريحات "يلدريم" ، و التي انطلق معها سلسلة من التحليلات و السيناريوهات حول هذه "الحتمية" ، ووصل الأمر بالبعض لتخيل طيران الرئاسة التركي يحط في دمشق و حاملاً رجب طيب أردوغان أو يلدريم على أقل تقدير، ويتم استقباله من قبل مبعوث من الأسد ، كون الأخير أكبر من هذا الاستقبال.
في حين ترفّع موالو الأسد عن التعبير بالفرح بـ"النصر" ، و بدأوا بإعداد الشروط و تحضير قوائم الهدايا المحبذة و المحببة ، مع تفضيل أن تكون العلاقات الجديدة تحت فكرة "البوط العسكري" أي اعتراف واضح بأن المنتصر هو القاتل .
لاشك أن التغير الكبير في السياسة التركية أصاب العقول بتلبك كبير ، و جعلها بحالة لا توازن تصدر عنها أصوات لا يعرف منشأها و لا اتجاها ، و الأكيد أنها تظهر روائح كريهة تزكم الأنوف ، و تكشف ما تحتويه من سوء تدبر و جهل بالتعامل مع التطورات.
رغم وجود أصوات طالبت بالتريث ريثما يكتمل المشهد العام إلا أن الإصرار كان واضحاً بانتهاج "الهجوم"، فوحده الطريقة المثلى ليقال أننا على يقين بكل ما تخفيه الصدور و يدور في فلك الدهاليز، و لكن على الأقل نستطيع القول أن هذا التخبط أوجد شرخ جيد بين مدعي الصداقة أو الوطنية ، اذ مجرد كلام تم تصويبه جعل بوصلتهم تتغير ٣٦٠ درجة ، تتيه كما جرت العادة عن المشكلة الأساسية للسوريين ، ألا وهو الأسد كشخص و نظام ، و بدأنا بحملة على ثانويات و هجوم على الجميع ، كما حدث عندما خُلقت داعش فعلى الرغم من أنها وهم إلا أن الكثيرون يصرون على أنها الخطر الأكبر و يكاد يكون الأوحد ، مخفضين درجة الأسد لما بعد الدرجة الثالثة أو الرابعة .
التغييرات السياسية تحكمها مصالح الدول و لا تحكمها أمور إنسانية ، ففي السياسة كما تعلمنا قاعدة ذهبية لا تشذ عنها "على المرء أن يسير مع مصالحه لا مبادئه"، و "يلدريم" لن يخرج عنها ، فكلامه موجه لروسيا و ليس للأسد ، ورسالته دفينة بأن سوريا هي مهمة لهم أيضاً و أن التقريب و التقارب بينهما جائز و ممكن و لو حتى وصل الأمر للقبول بالأسد لأشهر قد تصل للستة و قد تزيد لتصل ١٨ شهراً ، و لكن في النهاية لن يكون أكثر من ذلك ، بمقابل الحصول على تطمينات كافية بأن لا كيانات و لا فيدراليات "قومية" هنا أو هناك ، وهو ما يكون التقريب الأفضل بين المصالح و المبادئ.
 ١٣ يوليو ٢٠١٦
١٣ يوليو ٢٠١٦
يخشى معارضون سوريون أن تكون تركيا «السلطان» رجب طيب أردوغان انتقلت من حقبة سياسة «صفر مشاكل»، إلى مرحلة «صفر ثوابت». ومبرر القلق لديهم أن مَنْ كان يُعتبر عرّاباً للإسلام السياسي في دول ما سُمِّي «الربيع العربي» وفتحَ أبواب تركيا لكل معارض و «إخواني»، وتعهَّدَ معركة حتى تنحية الرئيس بشار الأسد، وانحاز إلى معاناة الشعب السوري... كان حذّر مرات من «الخط الأحمر» الذي يحول دون فتح النظام أبواب حلب، وبات معتصماً بالصمت، رغم شراسة القتال حول المدينة واستهداف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة ومحاولة محاصرتها لتركيعها.
والقلق مبرَّر لدى كثيرين من السوريين النازحين والمشرّدين في أصقاع الأرض، لأن التحوُّل في موقف أردوغان من الحرب في بلادهم، سيعني بالحد الأدنى- أي التفرُّج على «خنق» الفصائل المعارضة في حلب- إطالة أمد المعاناة والمآسي، وربما حسم المعركة هناك لمصلحة النظام. وواضح أن شكوكاً وارتياباً يثيرها اقتراح الرئيس التركي منح الجنسية للاجئين السوريين في بلاده، لن تبدّدها بسهولة مقولة دمجهم في سوق العمل التركية، فيما شريحة واسعة من مواطني «السلطان» ما زالت تحلم بالانتقال إلى دول في الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن فرص.
يتضخّم الارتياب لأن الصمت التركي على محاولة «خنق» حلب المعارِضة، وسعي قوات النظام السوري إلى السيطرة على الشريان الوحيد لها، يأتي بعد تحوُّلات في السياسة الإقليمية لأنقرة، كان أبرز محطاتها التطبيع مع موسكو، الحامي الأول لنظام الأسد، فيما لم يفرّط أردوغان بالتهدئة مع طهران التي تعتبر بقاء الأسد في السلطة خطاً أحمر.
تركيا إذاً في حقبة أردوغان الثاني بعدما ابتلع الأول هزيمة خيار «صفر مشاكل»، لكنه ضحّى بداود أوغلو كبش فداء. انتهت أنقرة قبل محطات التطبيع الجديدة، إلى قطيعة مع روسيا وريبة مع أميركا، ومقاطعة لإسرائيل، وخصومة مع القاهرة وعداء لدمشق الأسد، وتوتر صامت مع طهران وأزمات متعاقبة مع بغداد. وبعد سعي مرير إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، بدا ان السلطان نفض يديه من حلم السوق الهائلة لدول الاتحاد، لا سيما بعد الضربات الإرهابية و «زلزال» الاستفتاء في بريطانيا الذي وضعها على عتبة مغادرة قطار القارة «العجوز». وكل ذلك بعد اختبار مرير لبلادة الإدارة الأميركية في التعامل مع جحيم حرب التهمت الأخضر واليابس لدى الجيران السوريين، وباتت تهدد بتفكيك تركيا.
الأكيد أن أردوغان الثاني يفضّل عدم النوم على حرير التطمينات الأميركية إلى مدى الدعم الذي حظيت به «قوات سورية الديموقراطية» والأكراد السوريون. فجأة باتت تركيا بين ضربات الإرهاب ومطرقة التراجع الاقتصادي وهواجس الحصار السياسي إقليمياً، وأرق تمدُّد طموحات الإدارات الذاتية الكردية. اختار السلطان التطبيع مع الجوار والحسم الأمني في الداخل، وتعاوناً استخباراتياً إقليمياً يمكّنه من إجهاض حملات حزب العمال الكردستاني.
اختار «الاعتذار» لسيد الكرملين عن إسقاط الطائرة الروسية، لا أن ينتظر فوز السيد الجديد للبيت الأبيض في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. اختار أردوغان الورقة الروسية «الرابحة»، الطاغية في تقرير مسار الحرب في سورية ومصيرها، فيما أقصى طموحات الأميركي أن يخفّف النظام السوري الضغط العسكري على الفصائل المقاتلة «المعتدلة»، لتتولى واشنطن وموسكو إضعافها!
هل يدفع السوريون ثمن قطار التطبيع التركي، وتدفع أنقرة ثمن التطبيع مع موسكو صمتاً على «الخط الأحمر» في حلب؟ «صفر ثوابت» كما يقال في تهكُّم بعضهم على التحولات الإقليمية لأنقرة، ألم ينعكس تخلياً عن المطالبة برحيل الأسد، شرطاً لنجاح المرحلة الانتقالية في دمشق؟
قد يكون التطبيع مع القاهرة المحطة المقبلة في تكيُّف أردوغان الثاني مع «واقعية» التخلي عن دور العرّاب للإسلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما انتهت تجارب عربية إلى حروب أهلية، وتطايرت شرارات الإرهاب في كل اتجاه. بل إن الذين يدافعون عن خيارات السلطان، يرون في السلوك الأميركي على مدى ولايتي باراك أوباما، ما يكفي لعدم الاتكال على قوة عظمى كانت وحيدة، قادرة على ضمان استقرار الخرائط، وباتت «ناعمة» عاجزة عن مواجهة ثارات بوتين وأحلامه.
ولكن، هل يبرر كل ذلك، الخوف من صفقة «مشبوهة» في سورية، يريد أردوغان استباقها بكسر جدران العزلة، فلا تدفع تركيا ثمن تمديد الحرب والتهجير والتشريد، ولا ارتدادات خيار التقسيم، بما تعني من جولات طويلة... بدماء السوريين؟
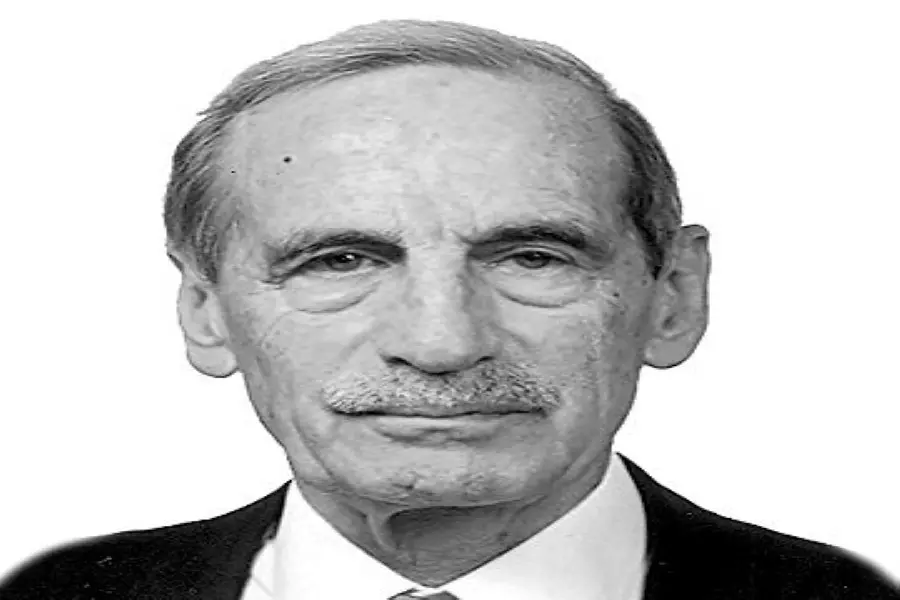 ١٣ يوليو ٢٠١٦
١٣ يوليو ٢٠١٦
انتهى صوم رمضان وانتهى عيد الفطر ولا يزال ملايين السوريين صائمين، فالأمم المتحدة تقدِّر أن خمسة ملايين يواجهون خطر مجاعة مستمرة.
هذا في سورية، إحدى أخصب بقاع العالم وأجملها. عيد الفطر السادس مرَّ والسوريون إما تحت الحصار في بلادهم وإما لاجئون في الخارج، وقد تلاشى أمل الجميع في حل. هل سورية التي عرفوها وعرفناها انتهت؟ لا أريد أن أصدق هذا.
ميليشيات معارضة في قرى حول دمشق، وحلب تتقاسمها قوات الحكومة والمعارضة وتدمَّر يوماً بعد يوم. أكثر من ثلثي الأحياء القديمة لم يعد موجوداً، وسكانها بين مشرد وقتيل.
الإرهابيون من «داعش» وزعوا فيديو قبل أيام يفاخرون فيه بتدمير آثار تاريخية في تدمر. قوات النظام مدعومة من الطيران الروسي استعادت ما بقي من تدمر، لكن الأكراد في الشمال على الحدود مع تركيا ماضون في بناء إقليم خاص بهم. هل أقول إنه مستقل.
النظام لا يزال مصراً على الحل العسكري. ستون شهراً، كل واحد منها أسوأ من سابقه والنظام مصرّ على أسلوب لا يمكن أن ينجح. حتى الحكومة الجديدة بددت أي أمل بتغيير فهي ضمت 26 وزيراً، بينهم 14 وزيراً جديداً، ولكن لا سياسة جديدة إطلاقاً، بل لا وزير واحداً مما يُسمّى المعارضة «المقبولة».
الأزمة المعيشية بدأت تعصف بالموالين مع المعارضين. الجوع قبل صوم الشهر الكريم وبعده، والقوات النظامية تفرض حصاراً على 18 منطقة، والإرهابيون يحاصرون مناطق أخرى. أقرأ أن حوالى مليون سوري تحت الحصار، أي في قبضة الجوع والمرض والخوف.
منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً في 36 صفحة اتهم جبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام والحركة الإسلامية بممارسة التعذيب والخطف وأيضاً القتل. المنظمة وثّقَت 24 حالة خطف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2013 و2015، وبعض الضحايا ناشط مسالم ومعهم أطفال، بالإضافة إلى أفراد من الأقليات استهدفوا لا لشيء سوى دينهم.
جماعة النصرة، وهي تنظيم إرهابي، قضت على تنظيم آخر يوصَف بأنه «معتدل» ولا أراه كذلك في ريفي حماة وإدلب كجزء من مشروعها تأسيس «إمارة» تنافس خلافة «داعش». عندما نتحدث عن الإرهاب يظل لـ «داعش» قصب السباق.
أمام «براميل» النظام و «سكاكين» الإرهابيين، لجأ ستة ملايين سوري خارج بلادهم، ومات ألوف منهم على الطريق، وشرِّد ستة ملايين سوري داخل بلادهم. وصرنا نسمع عن حي سوري في إسطنبول وعن «دولة» سورية في لبنان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أنه سيمنح اللاجئين السوريين جنسيات تركية، ربما أملاً بأن ينتخبوا حزبه، ثم تراجع وألغى الفكرة.
إذا كان كل ما سبق لا يكفي، فهناك 51 موظفاً كبيراً في وزارة الخارجية الأميركية وقعوا مذكرة تطالب بزيادة التدخل الأميركي العسكري في سورية، وكأن السوريين لا يكفيهم ما فيهم.
المأساة السورية تقصّر عنها تراجيديا إغريقية. لم أحلم في حياتي، أو لم أصب بكابوس يتوقع هذا الشقاء للسوريين. لم أفرق يوماً بين سوري ولبناني أو أردني أو فلسطيني، أو مصري أو أي عربي آخر. الأمل مات في قلبي، فأجلس وأحلم بأنني عائد بالسيارة من دمشق إلى بيروت، وأتوقف على الطريق لأشتري فاكهة أو خضاراً. حتى طلبي البسيط هذا أخشى ألا أحصل عليه.
 ١٣ يوليو ٢٠١٦
١٣ يوليو ٢٠١٦
كل يفسر الأمر من زاويته، عندما وعد رئيس الحكومة التركية اللاجئين السوريين بمنحهم جنسية بلاده. خصومه من الأتراك عارضوه، واعتبروها محاولة لتعزيز وضعه في الانتخابات المقبلة بإضافة السوريين للتصويت له، وشنوا حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد «تتريك الأجانب». والبعض من السوريين خائف لأنه اعتبرها إيحاءً من إردوغان بتخليه عن قضيتهم، وأنه ينوي التصالح مع النظام في دمشق. وهناك من اعتبرها مجرد دعاية سياسية أخرى لن يلتزم بتنفيذها.
وقبل أن تبدأ الإجراءات ويحصل أول سوري على الجنسية التركية، من الصعب الحكم عليها، وفي ظل الظروف الحالية فإن الفكرة نفسها، كما تناولتها الصحف التركية، مثيرة جدًا وتستحق النقاش. الذي فهمناه من المعلومات الأولية، أن مشروع الجنسية مقصور فقط على الميسورين ماديا، ويقدر عددهم بنحو ثلاثمائة ألف. وهو عدد يستوجب التشكيك فيه، حيث لا أتصور أن هناك ميسورين سوريين بمثل هذا الرقم، بين المليونين والسبعمائة ألف لاجئ في تركيا أو في عموم سكان سوريا، إلا إذا كان الرقم يشمل عائلاتهم، بما يعني أن المستهدفين بالتجنيس نحو ثلاثين ألف ثري سوري.
والحقيقة إن كانت مشروعا حقيقيا وليست مجرد دعاية، فإنها خطوة ذكية، وعملية، تصب في صالح الاقتصاد التركي، وإن كانت قد تسبب إشكالات سياسية، وخطوة جيدة تخفف الضغط والمعاناة على بعض الفئات من اللاجئين. ولا أتصور أن مثل هذا الرقم يغير في التوازنات الانتخابية التركية، فلن يبلغ مائة ألف «سوري تركي» مؤهل للتصويت، وذلك من دون احتساب صغار السن الذين لا يحق لهم التصويت قانونيا.
أيضًا أستبعد زمنًا أن يفيد إردوغان سياسيا، لأنه لن يتم إنجازه في وقت قريب داخل المؤسسات التركية الرسمية، بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة. حتى وعد الرئيس إردوغان، الذي قطعه العام الماضي، بمنح اللاجئين السوريين رخصة العمل، لم يحصل من المليوني سوري سوى خمسة آلاف فقط. وبالطبع منح الجنسية أكثر تعقيدًا، وحساسية، وقد تمر سنوات قبل تنفيذه بمثل هذا الرقم الكبير، رغم أن عدد سكان البلاد كبير نسبيا، مقارنة بالثلاثمائة ألف الموعودين من السوريين، ولا يقارن بالمليون مهاجر الذين استقبلتهم ألمانيا، ووعدتهم بمنحهم الإقامة، التي تفضي عادة في الأخير إلى منحهم جنسية البلاد. ولو حقق إردوغان وعده فإنه سيكون عملا مهما، حتى لو انتقده البعض على أنه تمييز ضد الفقراء من اللاجئين أو مشروع لتغيير خارطة الانتخابات المحلية.
فاللاجئون للدول المجاورة مثل القدر، خارج سيطرتها وحساباتها. وهناك حكومات سعت للاستفادة من أزمة اللاجئين والمهاجرين إليها، فاعتبرت اللاجئين مشكلة لا بد من استيعابها، بدلا من حصارهم في المخيمات. والولايات المتحدة من أكثر الدول التي استفادت من المهاجرين، وكانت في بعض الحالات تخفف من قيودها، فتمنح رخص العمل، التي تكسبهم الجنسية الأميركية لاحقا، وذلك لفئات تعتقد أنهم سيفيدون اقتصادها، مثل الهنود الذين فتحت لهم أبواب الهجرة وتكاثر عددهم بشكل كبير منذ التسعينات. اليوم هم فئة مهمة في قطاعات مختلفة، يتميزون بالجد والكد والحرص على التعلم والتفوق المهني كذلك. وسبق لبريطانيا، في العقد الماضي، أن ضغطت على الحكومة العراقية لإعادة لاجئيها إلى بلادهم، إلا أنها طلبت استثناء الأطباء منهم، على اعتبار أن عندها نقص كبير في العاملين في المجال الصحي، وتوجد حاجة كبيرة لمنتسبي هذه المهنة.
محاولة تبني مئات الآلاف من اللاجئين قد يهون، لكنه لن يوقف المأساة المروعة التي يعيشها الشعب السوري، فمهما منح الأتراك والأوروبيون الجنسية والوظائف، فإن رقم اللاجئين أكبر من أن يستوعب عالميًا. نحن أمام بلد نصف شعبه أخرج قسرًا من بيوتهم، يوجد اليوم أكثر من عشرة ملايين ما بين مشرد في داخل سوريا، ولاجئ في الخارج. والسوريون ليسوا مثل الشعب الفلسطيني الذي معاناته أصعب وأعقد، حيث تم تهجيرهم بعد الاستيلاء على بيوتهم وأرضهم، قطعت عروقهم من تراب بلدهم الذي قد لا يعودون إليه. فما يحدث في سوريا نزاع على الحكم، وسينتهي في يوم ما، ومهما كانت نهايته، وبأي كيفية صارت عليها سوريا، سواء بقيت دولة واحدة أو مقسمة، فإن أهلها قادرون على العودة إليها مهما طال الزمن، كما هو حال العراقيين والأفغان والصوماليين واليمنيين وغيرهم من الشعوب التي ابتليت بالفوضى والحروب. سيعود من يعود، ويعيش في الخارج من لا يريد العودة أو لا يستطيع.
 ١٣ يوليو ٢٠١٦
١٣ يوليو ٢٠١٦
لا يزال قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح لاجئين سوريين الجنسية التركية يثير سجالاً واسعاً بين السوريين والأتراك على السواء. والسجال المحتدم في وسائل الإعلام الافتراضي كما في الإعلام الواقعي مرده خصوصاً إلى التحول المفاجئ في الموقف حيال لاجئين منعوا طوال خمس سنوات من الحصول على صفة لاجئين، ليتحولوا في غضون أيام من ضيوف الى مرشحين محتملين للحصول على الحقوق الكاملة للمواطنة.
وتزيد التكهنات في شأن دوافع أردوغان من سوابق له في التعامل مع ملف اللاحئين وهو كان هدد قبل أِشهر بإغراق أوروبا بهم إذا لم يلبّ الإتحاد الأوروبي شروط أنقرة، وخصوصاً إلغاء تأشيرة الدخول للاتراك. وليس توقيت القرار أكثر وضوحاً في خضم تحولات كبيرة تشهدها الديبلوماسية التركية.
لم يقتنع كثيرون بالدوافع الإنسانية لأردوغان الذي سبق له أن حاول عقد صفقة العمر لتركيا على حساب معاناة النازحين، ووافق مع الأوروبيين على اتفاق لترحيل مهاجرين من أوروبا وصفته منظمات إنسانية بأنه غير إنساني. وفي انتظار استكمال اتفاق إلغاء التأشيرة للأتراك المسافرين ألى أوروبا، يبدو أن أردوغان يخطط لمكاسب داخلية هذه المرة. ففي ما يعكس قطباً مخفية في القرار، أفادت وزارة الداخلية أنها لا تزال تعمل على بلورة تفاصيل منح الجنسية التركية للسوريين المقيمين في تركيا "من ذوي الكفايات"، وانتقاء الذين لم يتورطوا في الإرهاب، بينما نسبت صحيفة "حريت" الى مسؤول تركي رفيع المستوى أن العمل في هذا المجال بدأ قبل أكثر من سنة، وقبل وقت طويل من تصريح أردوغان. وذهب هذا المسؤول إلى القول إن إعلان هذه الخطوة في هذا الوقت هو قرار سياسي.
وردود الفعل الساسية في تركيا تعكس شعوراً مماثلاً حيال القرار، فأحزاب المعارضة رأت أن هذه الخطوة تهدف الى تحقيق ميزة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وشككت في طابعها الانساني. وذهب حزب الشعب الجمهوري إلى حد القول صراحة إن أردوغان ليس مهتماً بمستقبل هؤلاء الناس، وإنما بالمكاسب السياسية التي سيجنيها من تجنيس 300 ألف سوري في الانتخابات العامة المقررة سنة 2019.
ولكن هل حقاً يريد اللاجئون السوريون الجنسية التركية؟
في حالات كثيرة، لا تعد هذه الجنسية مكسباً لهؤلاء، ولا يوفر جواز السفر التركي تسهيلات لحامله. وفي بعض المناطق التركية، يحتمل أن يشكل عبئاً.
كان الأجدر بأردوغان، بدل منح السوريين الجنسية التركية، أن يساعدهم على الحفاظ على سمعة جنسيتهم، وبذل جهود جدية لمنع إرهابيي العالم من التسلل الى سوريا وخطف ثورة أبنائها وتهديد سلام العالم بأسره.
 ١٢ يوليو ٢٠١٦
١٢ يوليو ٢٠١٦
تشكل الأرض السورية اليوم مساحة صراع يتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة، بدأ من ثورة على نظام الاستبداد قام بها الشعب السوري، لكنه اتخذ وجوها مختلفة من الصراع الإقليمي والدولي، فرضت إيقاعها بقوة، على جوهر المواجهة المتمثلة بانتفاضة الشعب السوري على نظام بشار الأسد.
نجح نظام الرئيس بشار الأسد وحلفاؤه الإيرانيون والروس، في فرض معادلة جديدة، اتسمت بفرض أجندة “الحرب على الإرهاب”. وما كان لهذه الأجندة أن تفرض شروطها إقليميا ودوليا إلى حدّ بعيد، لولا أن الولايات المتحدة الأميركية بدت غير مهتمة بانتقال النظام السوري من نظام توليتاري إلى مرحلة جديدة تفتح سوريا على أفق ديمقراطي. كما أن إسرائيل تدرك أن أي تحول في حكم سوريا، من دكتاتورية الأسد إلى أي نظام آخر، لن يـكون مضمونا لجهة التزامه بمقتضيات الهدنة والاستقرار التي كان لنظام الأسد دور مميز في حمايتها على حدود الجولان المحتل مـنذ العام 1974.
ليس هذا جديدا في قراءة الأزمة السورية خلال السنتين الأخيرتين، ولا يمكن تغييبه حين الحديث عن مأساة الثورة السورية التي وقعت ضحية شراسة المعادلات الإقليمية والدولية من جهة، وسطوة الاستبداد الذي يهيمن على أنظمة الحكم في العالم العربي من جهة ثانية.
من هذه الثنائية غرفت الحركات الإرهابية واستفادت، وتستفيد، من نقمة شعوب المنطقة على أنظمتها، ومن عجز هذه الشعوب عن تغييرها.
أما إذا تحققت لهذه المنظمات الإرهابية السيطرة والتحكم وتشكيل كيانات أو دول تحت مسمى “الخلافة”، فالأرجح أن مثل هذه الكيانات لن تكون أفضل حالا من الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة التي تحكم معظم العالم العربي والإسلامي.
التدمير الذي يطال سوريا اليوم، أسوة بالعراق واليمن وليبيا، هو تدمير تجاوز الحجر إلى تدمير المجتمعات، فقد بات الحديث عن تقسيم سوريا، على سبيل المثال، مشروعا قابلا للتحقق ليس فقط برغبة الدول المؤثرة، بل حتى المكونات السورية لكثرة ما استنزفها الصراع المذهبي أو الإثني، باتت مستعدة للخوض في غمار تقسيم ما، ترتجي من خلاله استقرارا ولو كان وهميا.
الصراع الإقليمي والدولي الذي تشهده الأرض السورية ليس صراعا على سوريا، ولا على من يكون حاكما لهذا البلد أو لأجزائه. بل أظهرت مجريات الصراع أن الميدان السوري يرسم معادلة إقليمية دولية تتحكم بالمنطقة العربية إلى عقود آتية لا إلى سنوات.
وأبرز ما يمكن ملاحظته في هذا الصراع هو ما سيظهر، بقوة، خلال المرحلة المقبلة عبر الدور الإسرائيلي الذي يفرض نفسه لاعبا أساسيا في المنطقة، ومركز جذب لأطراف الصراع الإقليمي والدولي في سوريا.
لذا ليس عاديا أن تلتفت تركيا مجددا إلى أهمية الدور الإسرائيلي، إذ حين ظنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن من شروط الزعامة في المنطقة العربية والإسلامية الابتعاد عن إسرائيل، اكتشف لاحقا أن هذا الشرط لم يعد أساسيا بل لم يعد له أي تأثير في بناء الزعامة العربية والإسلامية. من هنا أعاد أردوغان المياه إلى مجاريها مع إسرائيل، محاولا استباق ما قطعته قوى الممانعة من خطوات باتجاه إسرائيل.
المنافسة على استرضاء إسرائيل هي ديدن دول المنطقة اليوم، وهي الوسيلة الأفضل للحدّ من الخسائر ولحفظ ما تبقى من موارد وإمكانيات لهذه الدول.
ولم يعد خافيا أن إيران، التي طالما استطاعت أن تستخدم فكرة العداء لإسرائيل، من أجل اختراق الدول العربية، ومحاولاتها الحثيثة لعسكرة المجتمعات على حساب مشروع الدولة، باتت اليوم إزاء حالة العداء التي تواجهها في العالم العربي وفي محيطها الإسلامي، معنية بتثبيت لغة التهدئة مع إسرائيل، بل هي تندفع إلى محاولة إغراء إسرائيل بتأمين المزيد من شروط الاستقرار على حدودها اللبنانية والسورية، في مقابل مثابرة إسرائيل على منع سقوط نظام بشار الأسد.
المعادلة التي اختارتها إيران في المنطقة العربية تفضي، بالمعنى الإستراتيجي، إلى تقاطع موضوعي مع إسرائيل. ذلك أن الصراع الذي اتسم بتعزيز الأيديولوجيا المذهبية، وحماية الأقليات، وتقديم هذه العناوين الفرعية على أولوية بناء الدول وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية ما تبقى من عناوين وحدوية إسلامية، كفيل بأن يجعل إسرائيل طرفا مقررا في معادلة الصراع الإقليمي وفي سوريا تحديدا.
الخطوة الروسية لبناء علاقة تحالفية مع إسرائيل على صعيد المنطقة العربية، والتنسيق مع إسرائيل في سوريا بما يحفظ شروط الأمن الإسرائيلي، هي خير دليل على مدى أهمية الدور الإسرائيلي في صَوْغ المعادلة الإقليمية والسورية.
وقد شكلت روسيا الطرف الضامن لدول الممانعة، وعلى رأسها إيران، في تأمين شروط علاقة مستقرة وهادئة مع إسرائيل. ربما اكتشفت تركيا أن تراجع علاقتها مع إسرائيل هو ما جعلها عرضة للاستهتار الأميركي بمصالحها الإقليمية، وهدفا روسيا سعى الكرملين إلى تطويعه والحدّ من طموحاته.
لذا أعاد رجب طيب أردوغان الحياة إلى العلاقة مع إسرائيل، تلك العلاقة التي كانت شرطا أساسيا لإعادة التوازن لعلاقته مع روسيا.
الباب الإسرائيلي هو الباب الوحيد الذي بات الدخول منه شرطا لحماية نظام مصالح الدول الإقليمية في المنطقة من روسيا إلى إيران وصولا إلى تركيا.
أما نظام المصالح العربي فهو شبه غائب عن المعادلة، بل هو الهدف الذي تتقاطع الدول الإقليمية على إضعافه، تمهيدا لوراثة ما تبقى من نفوذه ودوره.
 ١٢ يوليو ٢٠١٦
١٢ يوليو ٢٠١٦
سوريا ميدان مفتوح على تسجيل الخسائر والأرباح. الجميع يحاربون ويتحاربون، و»المايسترو« باراك اوباما، يدير «اللعب الدموي»، بلا رحمة. الآن والرئيس اوباما قد دخل مرحلة العد التنازلي لمغادرة البيت الأبيض، فانه لم يعد يمكنه اتخاذ قرار يعرقل خليفته سواء كانت هيلاري كلينتون او دونالد ترامب، في قضية مثل سوريا تعني منطقة مثل منطقة الشرق الاوسط التي مهما اهملت فإنها تعود الى الواجهة حتى لو كان الخيار الآخر في منطقة المحيط الهادئ. بدلا من ذلك فان اوباما يتحرك لترك رصيد يمكن للخليفة المنتخب العمل والبناء عليه. ويبدو واضحا ان اوباما اختار «اللاعب» الاول في إدارة اللعب «القيصر» الروسي فلاديمير بوتين، الذي اثبت منذ «ولادته» السياسية انه «يضرب ويسحق» ثم يبني على «الأشلاء» سواء كانت سياسية او حتى بشرية.
أمام هذا الواقع، الآخرون يخسرون خلال «اللعب» حتى انتهاء رسم المسارات وتحديد «المحطة« الاخيرة. من الواضح حتى الان ان «لاعبا» اقليمياً قد خسر كثيراً، وحتى لا يخسر كل شيء انقلب على نفسه حتى تبقى بلاده واقفة على رجليها. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انقلب على «الاردوغانية»
التي أراد ان يكون نتيجتها «السلطان» وان تعود تركيا باسم «العثمانية الجديدة« صانعة للسياسة الإقليمية التي تؤهلها للدخول الى «نادي« القوى الكبرى. لا شك ان اردوغان اثبت بأنه زعيم وطني يضع مصلحة بلاده فوق شخصه.
في قلب التحول «الاردوغاني» الذي يكاد يصل الى درجة «الانقلاب« على ذاته، الأكراد وطموحهم ونشاطهم العسكري والسياسي الذي اصبح في قلب صناعة تاريخ منطقة الشرق الاوسط وجغرافيتها، بعد مئة سنة على تجاهلهم في اتفاقية سايكس - بيكو. ادرك اردوغان ان الغرب وتحديدا واشنطن الذي تحالف ودعم أكراد سوريا لتشكيل» شريط» مستقل او حتى تحت صيغة حكم ذاتي كما في العراق، يمهد لتكرار الصيغة نفسها في تركيا التي لا تتحمل ذلك لانه مثل بتر «قدميها«. لذلك كله تصالح وقدم السلطان تنازلات حقيقية سيكشف الوقت عاجلا مدى حجمها لكل من موسكو وتل ابيب. المهم الآن ملاحقة الخاسرين وتحديد حجم خسائرهم.
المعارضة السورية و»حماس» خاسران كبيران من هذا «الانقلاب«. لا يمكن منطقيا ان تكون سياسة اردوغان في سوريا بعد الاتفاق، كما كانت قبله. التنسيق مع موسكو سيكون في قلبه الموقف التركي في سوريا. الكلام المسرب عن إمكانية قبول تركي ببقاء الاسد لفترة ولو محدودة في إطار الحل السياسي لانه « يشكل ضمانة بعدم قيام دولة كردية في سوريا «مؤشر خطير لانه مفتوح على كل الاحتمالات، خصوصا في ظل المتغيرات التي ستتبلور في العام المقبل. على المعارضة السورية ان تتحرك وتدرس خياراتها بسرعة حتى لا تكون كما يقال «فرق عملة«!.
«حماس» تحركت ويبدو انها اختارت الواقعية السياسية على الايديولوجية. كل شيء يكمن في ما قاله اردوغان لخالد مشعل. «حماس« مضطرة في ظل محاصرتها سياسيا وجغرافيا للعودة الى احضان ايران. «الحرس الثوري« قدم لهذه المصالحة بنفي لتصريح لم يجف حبره بعد قيل فيه «ان حماس تفاوض الصهيونية«. التصريح الجديد الرسمي باسم «الحرس» ان «حماس في الخط الأمامي للمقاومة الفلسطينية ضد الصهيونية«. يقال ان خالد مشعل قد يدفع الثمن، لكن بالنسبة لإيران من الأفضل التعامل مع مسؤول مهزوم على التعامل مع قيادي صاعد.
هنا يبدو وكأن ايران رابحة. في الواقع لن تربح لأن واشنطن وموسكو لا ترغبان ولا تريدان « شركاء لهما«. منسوب القوة المرتفع لدى المرشد آية الله خامنئي يتم العمل لتنفيسه. الأكراد عادوا للنشاط العسكري. الفصائل الثلاثة: الحزب الديموقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني (كوملة) وحزب «الحياة الحرة الكردي« (بجاك)، تتنافس في النشاط. الحركة الكردية الاستقلالية نواتها في «جمهورية مهاباد« التي باعتها موسكو للشاه عام بعد ان حضنتها. طهران وصفت «الانفصاليين« بأنهم اشرار ومعادون للثورة». زيادة في الهموم الايرانية، تبرز الصدامات القديمة والمتجددة في بلوشستان الايرانية والتي تأخذ طابعاً قومياً ومذهبياً في وقت واحد. هذا ما يقلق النظام الايراني، اما مريم رجوي و«مجاهدي خلق»، فان طرحهم البديل له فانه يريحه شعبيا....
في الحالة الايرانية يوجد خاسرون. اي حل سياسي لا يمكن ان يقوم دون تقديم القوى تنازلات مؤلمة. لا يمكن لإيران ان تتحرك بعد انخراطها في سوريا مع روسيا «القيصر» دون الأخذ في الاعتبار ان الاولويات في سوريا قد تغيرت، خصوصا ان التفاهم الاسرائيلي - الروسي يكاد يصبح تحالفا بعد ان طال النفط والغاز. السؤال الكبير ماذا ستكون السياسة الايرانية بعيدا عن الخطابات الشعبوية من فلسطين، خلال السنوات الخمس والعشرين التي حددت للانتصار على اسرائيل؟ وماذا سيفعل «حزب الله« في كل هذه السنوات وهو غير قادر على تحرير القدس ولا المشاركة في صياغة سياسة الغاز والنفط في المنطقة بعد تأكيد الحماية الروسية للغاز بعد شراكتها مع اسرائيل في إنتاجه؟.
لقد امتلك «السلطان» الشجاعة السياسية للانقلاب على نفسه لضمان مصالح بلاده، فهل يملك المرشد مثل هذه الشجاعة ام يتابع سياسته واصراره على ديمومة خطوطه الحمراء فيدفع الثمن من استقرار إيران ومن قوة "حزب الله".
 ١٢ يوليو ٢٠١٦
١٢ يوليو ٢٠١٦
أربع نقاط يمكن التوقف عندها لتفسير الانعطافة المزدوجة للسياسة التركية، نحو تطبيع العلاقة مع إسرائيل وتجاوز ما وضعته من اشتراطات لقاء ذلك، ونحو إصلاح العلاقة مع روسيا والرضوخ لمطلب موسكو بتقديم اعتذار صريح عن إسقاط طائرة السوخوي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.
أولاً، يأس أنقرة من استنهاض موقف غربي داعم لسياستها في الصراع السوري، حيث استمر رفض الأميركيين والأوروبيين توفير مظلة سياسية وعسكرية لحظر جوي أو لمناطق آمنة، ولم تتراجع ثقتهم بالأكراد السوريين ودعمهم بصفتهم شريكاً رئيساً في مواجهة تنظيم» داعش».
ويصح القول أن الحكومة التركية قد استنفذت كل محاولاتها لإقناع حلفائها بخطر نفوذ الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني وسيطرته على حدودها الجنوبية، وباتت مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا وإسرائيل في رهان على تعاونهما لحماية أمنها القومي وتلافي هذا الخطر، وعبرهما للضغط على واشنطن لتليّن موقفها الداعم بشدة للدور الكردي في الصراع السوري.
ثانياً، الاطمئنان التركي لسقف التدخل الروسي في سورية بعد قرار موسكو وقف عملياتها الحربية وسحب القسم الأكبر من قواتها، وبعد وضوح دور الكرملين في دعم خطة أممية للحل السياسي، والضغط على النظام السوري للموافقة على مفاوضات جنيف وهدنة وقف الأعمال العدائية، زاد الأمر وضوحاً ميل موسكو نحو تثمير نتائج تدخلها العسكري في سورية بفتح الباب لعقد تحالفات جديدة في المنطقة تؤكد دورها كقوة كبرى مؤهلة للمشاركة في معالجة أزمات الشرق الأوسط ومشكلاته.
ثالثاً، يبدو أن أنقرة، وبعد التداعيات السياسية لثورات الربيع العربي، إن لجهة تراجع الاهتمام الشعبي بالقضية الفلسطينية وإن لجهة تنامي التطرف الإسلاموي الجهادي وهزيمة الإسلام السياسي في غير بلد، قد أدركت أن صلاحية الاستثمار في المظالم الفلسطينية واللعب بورقة غزة و «حماس» قد انتهى، وأنه لم يعد ينفعها، لكسب الرأي العام العربي والإسلامي، الظهور بمظهر الدولة التي تتحدى الغطرسة الصهيونية وتتباهى بأنها أوفى نصير للشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني.
رابعاً، ثمة حاجة اقتصادية ضاغطة على الحكومة التركية للانفتاح على روسيا وإسرائيل، تهدف لاستعادة التبادل التجاري الكبير والمميز مع البلدين، وضخ النشاط في قطاع السياحة الذي تحتل إيراداته موقعاً مهماً من الدخل القومي.
لكن ما كان للأسباب السابقة أن تفعل فعلها لدى حكومة أنقرة وتدفعها لتلك الانعطافة السياسية لولا النهج البراغماتي الأصيل لحزب العدالة والتنمية، وتاريخه المفعم بتوظيف مختلف الأوراق والوسائل من أجل الاستمرار في حيازة السلطة واحتكارها، حتى وإن كانت هذه الأوراق والوسائل عارية عن القيم والمبادئ وعن المقاصد الدينية ومتعارضة مع ما يرفعه من أهداف وشعارات، وحتى لو كان ثمنها غض النظر عما يجرى من فتك وتنكيل من جانب السلطات الاستبدادية أو الجماعات الإسلاموية، وطبعاً ليست قليلة المحطات التي عدل فيها حزب العدالة والتنمية سياساته، مبتعداً عن الثوابت التي جاهر بنصرتها، وسالكاً دون خجل أو تردد طريق الأنانية وتغليب المصلحة الخاصة، وما سرع انعطافته اليوم اضطراره لإعادة بناء صلاته الدولية وتحالفاته الإقليمية في ظل انحسار قدرته على التحكم بقواعد اللعب مع تنظيم «داعش»، الذي حين استشعر ببدء تضييق أنقرة على طرق إمداده ونشاطاته، لم يتردد في تنفيذ عمليات إرهابية طاولت غير مدينة تركية، وآخرها تفجيرات مطار أتاتورك التي بدت أشبه بإعلان حرب وقطيعة نهائية بينهما.
فيما مضى، وعلى النقيض من الإجماع الدولي، بدت حكومة العدالة والتنمية كأنها المتفهم الوحيد لصعود تنظيم «داعش» والأقدر على التعاون معه، لم يقف الأمر عند إطلاق سراح ديبلوماسييها بعد احتلاله الموصل، أو استجرار النفط منه والصمت عن جرائمه، بل وصل إلى تسهيل مرور آلاف الجهاديين للالتحاق به عبر حدودها، ثم رفض الانضواء في التحالف الدولي والتهديد بمنع طائراته استخدام قاعدة أنجرليك، لكن السحر انقلب أخيراً على الساحر، وفشل رهان أنقرة على استثمار ما يحدثه تنظيم «داعش» من تغييرات على الأرض لتحسين نفوذها الاقليمي ومحاصرة الحضور العسكري الكردي، لتجد نفسها وجهاً لوجه في حرب ضروس ضد هذا السرطان الإرهابي.
يبدو أن السباق قد انطلق للقضاء على «داعش» كمدخل لحجز موقع في خريطة التوازنات والتسويات القادمة، ويبدو أن هذا التحدي سيكون العامل الأساس في تحديد هوية السياسة التركية الجديدة، فهل تنجح انعطافة حزب العدالة والتنمية في تخفيف أزمته وتمكينه من استعادة هيبته وثقة الآخرين به؟! وهل تمهد لتعديل دوره تجاه أزمات المنطقة والصراع السوري تحديداً، وعلى الأقل، دعم هدنة لوقف إطلاق النار، تأخذ في الاعتبار المصلحة التركية بتحجيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وتغليب الوزن العربي في قوات سورية الديموقراطية، كما المصلحة الروسية بالفرز الواضح بين فصائل المعارضة المعتدلة والجماعات الجهادية المتطرفة؟!
صحيح أن أحزاب الإسلام السياسي، تحدوها شدة الولاء الأيديولوجي للتجربة التركية وقادتها، لم تتأخر في وضع الأعذار والمبررات لتلك الانعطافة السياسية وتحميل مسؤوليتها لتآمر جهات خارجية أو لتعقيدات الصراعات الدموية في المنطقة، وصحيح أن ثمة نقطة مضيئة لحكومة أنقرة في استيعاب ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وتوفير شروط حياة لائقة لهم مقارنة بالبلدان الأخرى، ولكن الصحيح أيضاً أن هذه الانعطافة بدت عند الغالبية أشبه بالصدمة والانقلاب، ربما لأن إعلانها كان سريعاً ومفاجئاً من دون مؤشرات أو مقدمات، وربما لأنها جاءت على نقيض صارخ مما تجاهر حكومة أنقرة به، أو مما كان ينتظر منها.
أخيراً، وبعيداً عن عبارات التبرير والانزعاج والاستغراب والتخوين، ربما يصح الاستنتاج بأن الخاسر من الانعطافة التركية هو نهج الحروب وتسعير الصراعات وإلغاء الآخر، والرابح تقدم الحقل السياسي وروح المشاركة في معالجة أوضاع مأسوية باتت أحوج ما تكون إلى مثل تلك الانعطافات للتحول عن مستنقع الدماء وجحيم العنف.
 ١١ يوليو ٢٠١٦
١١ يوليو ٢٠١٦
يبدو العالم وكأنه سيتعرض من الآن لما يمكن تسميتها "لعنة سورية"، عقابا له على سكوته المشين حيال إبادة شعبها بيد نظامه الذي استعان لتحقيقها بجيوش احتلال روسية وإيرانية وأحط أصناف المرتزقة الذين شاركوه في قتل مواطنين طالبوا بحريتهم. لم يكن هدفهم يوماً الانخراط في صراعاتٍ خارجيةٍ، لكن العالم " المتمدّن" في الغرب و" المتوحش" في الشرق خذلهم، وتفرّج مستمتعاً على أمواتهم بيد نظامهم والقتلة متعدّدي الجنسيات والمذاهب والأعراق والأهداف، ممن فبركت الأسدية بعضهم، وفبرك الخارج بعضهم الآخر، أو تعاون معه على فبركتهم وتزويدهم بالأسلحة الضرورية للقضاء على شعبٍ يعني نجاحه في إسقاط الأسدية انقلاباً تاريخياً سيطاول المنطقة بأسرها. وللأمانة، حقق القتلة مهمتهم باحترافيةٍ، رعتها جهاتٌ خبيرة، يسمونها "العالم المتمدن" و"رعاة حقوق الإنسان" و"حكومات شرعية".
واليوم، وقد قطعت الإبادة شوطاً كبيراً، ووصل الناجون منها إلى أكثر أمكنة العالم بعداً عن وطنهم، صار من المرجح أن تحل "لعنة سورية" به، وتتظاهر، من الآن فصاعداً، في أمواج فوضى عاتية، لن يمر زمن طويل قبل أن تجتاحه بكامله، بعد أن غمرت "الشرعية الدولية"، وقوّضت شرعيتها وزلزلت قدراتها، وأطاحت عديداً من مؤسساتها، وأحدثت صدوعاً خطيرةً في البلدان "المتحضرة" ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وأخلاقية، كشفت بؤس قياداتها وأحزابها، ومهّدت الطريق إلى يمينٍ جديدٍ معادٍ لها، أخذ صعوده العاصف يقوّض أمنها، ويدخل الرعب إلى قلوب مواطنيها، وكذلك الخشية من أن يغدو مصيرهم متصلاً بمصير ملايين السوريين الذين يغرقون في البحر، أو يموتون تحت أنقاض بيوتهم، أو يتبدّدون في انفجارات القنابل والصواريخ، أو يهلكون جوعاً وعطشاً عند حدود الدول، الصديقة والعدوة، أو تحزّ السكاكين أعناقهم ويدمّرهم نفسياً وروحياً، ويفشلون في الحصول على خبرٍ عن أخ أو أبٍ أو زوجٍ أو ابن اختفى منذ سنين، ولم يعد لديهم من أمل غير أن يكون قد فارق الحياة، أو ... أو... أو ... . هل نعجب بعد هذا من امتلاء قلوبٍ سوريةٍ كثيرة بحقدٍ أعمى على عالمٍ سمح بقتلهم عن سابق عمد وتصميم، لم يرف له جفن وهو يتأمل سعيداً القضاء عليهم، فلماذا تأخذهم شفقةٌ به، ولا يتحوّلون إلى "ذئاب منفردة وجماعية" تفتك بما تعيش بين ظهرانيه من أغنام، ولم لا تجرّد حكوماتها من أية قدرةٍ على مواجهتها، ومجتمعاتها من أمنها، وتخوض ضدّهما حرباً، لطالما توهما أنهما في منجاةٍ من ويلاتها، وها هي طلائعها تطيح ثقتهما بنفسيهما، وتدخلهما في ذعر من الآخر الذي يمكن أن يكون حزاماً ناسفاً أو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت ومكان.
ليس ما ظهر إلى اليوم من "لعنة سورية" سوى بداية، ستمدّها التطورات بمواد متفجرة، ستحولها إلى حال تصعب السيطرة عليها، وحروب ستسعرها عيوب ونواقص ومشكلات نظامٍ دوليٍّ، فيما ملايين السوريين يقتلون ويذبحون كالنعاج، متجاهلا أن انهيار حواضنه القانونية والأخلاقية لن يتوقف عند حدوده، وأنه سيخترق بلدانه ويهشّمها من الداخل. ومن يراقب صعود اليمين الجديد في بلدان أوروبا يدرك أنها صارت هي أيضا في قبضة أخطارٍ تفقد أكثر فأكثر السيطرة عليها.
خال لعالم أن إبادة شعب سورية سيُنجيه من القتل والموت. وها قد بدأ يدفع ثمن تقاعسه عن وقف ما كان في استطاعته وقفه: ذبح شعبها الأعزل، المقتول بيد قتلةٍ وطغاة محليين وإقليميين ودوليين. ومع أنه لا يوجد سوري حر يريد ابتلاء أي فردٍ أو شعبٍ بما ابتلي هو وشعبه به، فإن "لعنة سورية" ستلاحق كل من شارك النظام الأسدي في قتل وتهجير وتشريد وتجويع وتعذيب وإخفاء ملايين عزّلاً صدّقوا ما كان يُقال عن حقهم في الحياة الحرّة، وها هي بقاياهم تهيم على وجوهها في الأرض، حاملة معها إلى من تخلوا عنها "لعنة" أخلاقيةً، لن ينجو منها أحد منهم، وسيدفع ثمنها الأبرياء من مواطنيهم.
ملاحظة: قصدت في مقالتي في "العربي الجديد" (3/7/2016) عن لقالق المعارضة حالاً قائمة، ولم أقصد أي شخصٍ بعينه.






